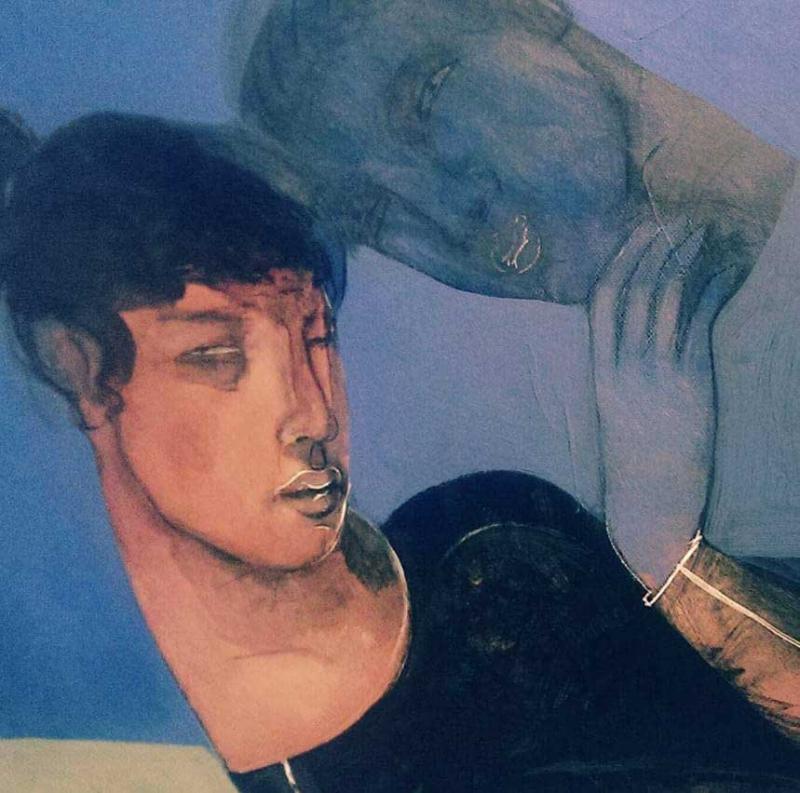يحتفل العالم، اليوم 21 مارس (آذار) بـ"اليوم العالمي للشعر" الذي اعتمدته منظمة اليونيسكو الدولية ليصادف انطلاق فصل الربيع كل سنة، وكان الشعر هو فعلاً ربيع الأرض والعالم، بل ربيع البشرية التي تخضع الآن لأقسى التجارب. معظم الدول العربية والعالمية تحتفي اليوم بالشعر والشعراء، وقد أولت اليونيسكو هذه السنة الشعر اهتماماً فريداً من خلال إحياء قراءات شعرية عبر الـ"أون لاين"، يشارك فيها شعراء من العالم أجمع، وعبر لغات شتى. في هذا الملف ننطلق من سؤال الشاعر الألماني هولدرلن "ما جدوى الشعراء في زمن الفاقة هذا؟" ونطرحه مع سؤالين آخرين، على شعراء عرب من أجيال ومشارب عدة: ما جدوى الشعر في هذا الزمن العصيب، زمن وباء كورونا، هل استطعت أيها الشاعر أن تواجه هذا الزمن شعرياً، هل سيكون لهذه التجربة المريرة التي يتخبط فيها العالم، أثر على الشعر؟
غسان زقطان (فلسطين): الشاهد الجالس خلف النافذة
الرجل المكمم المتعجل الذي يحمل كيساً بلاستيكياً ويبدو خائفاً، ثمة خوف يمكن التقاطه في مشيته وفي طريقة تثبيت الكمامة بيده، في محاولته المكشوفة لتجنب جيرانه والمارة القلائل، الرجل هو نفسه الذي يصعد الشارع كل صباح في طريقه للمسجد وهو يصافح جيرانه ويحيي المارة، يبدو أنه فقد ثقته بالأشياء، وانصب اهتمامه على الكمامة وكيس البلاستيك الأخضر وتجنب كل شيء.
القطة التي تقطع الشارع بشيء من الثقة غير بعيد عن الرجل، ثقة وفرها غياب المركبات وأولاد البناية المقابلة وخوف الرجل، في الليل سيصل ثعلب إلى حاوية القمامة المثبتة تحت عمود النور وسيلمع ذيله المنفوش تحت الضوء، تلك إشارة إلى أن الطبيعة تتقدم نحونا. الطبيعة تبدو أكثر ثقة مما كانت عليه في مواجهة تنمر الإنسان، بينما الخوف يعبر الشوارع ويسعى مع الهواء. هذا ليس مجازاً.
لا يبدو الشعر هو الخلاص هنا بقدر ما يبدو شاهداً، الشعر هو الذي يجلس خلف النافذة ويحاول أن يضع كل هذا في ترتيب جديد.
الشعر أيضاً اهتزت ثقته في مكوناته وعاداته وطريقته في إدراك ما يحدث، التغيرات أصابت كل شيء تقريباً، وما كان يبدو تمرداً على منطق الأشياء، مهمة تفكيك العالم وإعادة ترتيبه، يتضح أنها نوع من الروتين، وأن الطبيعة قامت بالعمل كاملاً. وها هي البشرية تبدو هشة ومفككة كما لم تكن من قبل.
لا أفكر في الشعر كمخلص، لا أظن أن ذلك قد ينجح، ولكنه يمنحني النافذة التي يمكن أرى من خلالها المشهد، على الرغم من أنه، الشعر، يبدو الآن مثل أداة قديمة ومعقدة، فرشاة عريضة مخصصة لرسم مشهد طبيعي، بينما كل ما أسعى إليه هو بورتريه شخصي بقلم فحم.
قاسم حداد (البحرين):كما الهواء
إذا نحن تفادينا مسألة "الجدوى" عندما يتعلق الأمر بالشعر، ربما تيسر لنا منح أنفسنا حرية الكلام عن الشعر. فالشعر هو أن تتحرر وتحرر علاقتك بالكتابة، وترى إليه بوصفه مطراً يلامس حياتنا لكي تظل رطبة وحيوية وذات مغزى إنساني، كما الهواء والتنفس. عندي، مثلما أن الشعر لا يغير (مادياً) في الحياة، فهو لا ينقذ سوى أرواحنا من الأوهام. فهو أيضاً لا يستطيع أن يصد الموت عنا. إنه فحسب يجعل الموت سهلاً مثل الحياة. الشعر، يعني أننا أحرار بمعزل عن قانون الأقدار. ولعل في التذكير السنوي بيوم الشعر العالمي، إنما هو لكي نقول "أن الذكرى تنفع المؤمنين والملحدين معا". ففي الشعراء العرب، المؤمنون والملحدون، ويحتاجون كلهم من يذكرهم بالتنفس.
يبدو لي أن هذا الزمن الصعب هو الذي تمكن من مواجهتي، فقد صرت أفقد الأصدقاء في العالم واحداً بعد الآخر، وأنا مقذوف، متروك في عجزي الكوني إزاء ما يحدث. وظني أن ما يحدث لنا مع هذه الجائحة يؤكد كم أن الإنسان لا يزال ضعيفاً وضئيلاً في هذه الحياة، ولكي نتأكد أـننا "حرفيا" وحدنا، والآلهة تتخلى عنا في وقتها. وربما يدفعنا هذا الوضع لكي نراجع إيماناتنا القائمة على الأوهام الكونية الكبيرة. ومثلما سمعنا كيف أن البيت العتيق ترك وحيداً ولم يكن له رب يحميه، ها هو يتركنا عراة بلا حماية، في الحرب والسلم.
نعم، أرجو أن يكون لهذه التجربة المريرة تأثير فينا، غير أن هذا مستبعد فعلاً، لكون الإنسان سيظل بحاجة لوهم يصقل له حياته التي أسهل منها الموت. لذلك كنت أشرت قبل قليل إلى أن بين الشعراء العرب، هناك المؤمن والملحد، من دون أن يصيب هذا مقتلاً في الشعر، مثلما يفعل ذلك في الإنسان.
الحق أن من يتخبط في هذا العالم، هم الشعراء والعلم، وليس الشعر. كنا نتوهم أن التقدم العلمي وانتشار المعرفة سيحصنان عالمنا من الأخطار. ورأينا كيف أن ثمة جهلاً أمام الجائحة سيدفع البعض إلى الكلام عن مؤامرة ينظمها العالم ضد الإنسان. وهذا خضوع مضاعف للغيبيات التي تحكمت بالإنسان من فجر البشرية. غيبيات تمثلت في الأديان التي ظلت طوال العصور تحمي الحكام ضد الأمم، من دون أن يجرؤ أحد على طرح الاستغراب تجاه الغياب الفادح للألهة. هذا التأثير هو ما ينبغي أن يحدث من جراء حدوث كورونا.
هاشم شفيق (العراق): ما يبقى يؤسسه الشعراء
لعل الشاعر الألماني هولدرن كان من أكثر الشعراء إحساساً بالزمن، وأكثر الشعراء التفاتاً إلى مهمة الشاعر في الحياة، وأهمية دوره وهو يخوض مصيره الشعري والإنساني، وكذلك هو الشاعر الكبير بريشت، مواطنه الذي أكد دور الشاعر في أزمنة المحن والخطوب، وهنا يحضرني قول هولدرلن المميز، فمنذ أمد بعيد وهذا القول يمتلك قدراً من التحدي، في مواجهة الزمن، لمواصلة البقاء والاستمرارية، كونه قولاً أثيراً ونادراً، لشاعر مؤثر وعظيم، وقد لخصه الشاعر في هذه الجملة "ما يبقى يؤسسه الشعراء".
إن هذا القول، أو هذه الحكمة الشعرية، تعيدنا هنا إلى الشاعرة العراقية نازك الملائكة، يوم كتبت قصيدتها الشهيرة "الكوليرا" عن ذلك الوباء الذي اجتاح مصر، في أربعينيات القرن الماضي، وأودى بحياة كثير من البشر، وكانت القصيدة تلك خير فاتحة لعالم جديد، من الشعر الحديث، ولتزيح الشاعرة بتلك القصيدة الرائدة، تاريخاً طويلاً من الشعر الكلاسيكي، الذي زاد على ألف وأربعمئة عام.
من هنا قول الشاعر هولدرلن "ما يبقى يؤسسه الشعراء" ومن الطبيعي، والحال هذه في أزمنة كورونا، أن ينهض الشعر ويتحدى ويقاوم، كي يواجه أزمنة البلاء والجوائح والأوبئة الشرسة، ومن هذا المنطلق كتب شعراء كثيرون في هذا الوباء الخطير، وبذا وجدت نفسي أنخرط بحكم جاذبية الشعر، الذي يبدو مثل مادة مغناطيسية قادرة على التقاط المحن والصروف والأوصاب، لأكتب أكثر من كتاب شعري وأدبي، محاولاً بكتابتي هذه أن أقلل من خطر الوباء، ومن خطر قوة انتشاره، بالكلمات المضادة للعدوى، وأرفع في الوقت عينه من سقف بقائي، وأجعل من الزمن موضوعاً قابلاً للتصرف.
نجاة علي (مصر): ركن من أركان الوجود
قبل أن تفاجئنا هذه الفاقة اللعينة كنت أهوى العزلة الاختيارية التي تتيح لي وقتاً أطول للقراءة والكتابة والهدوء النفسي وتأمل الحياة بعيداً عن الصخب الذي يحيط بنا ويفسد كل جمال، حتى يمكنني إنجاز عمل إبداعي جديد، فالعزلة بالنسبة لي "وطن للأرواح المتعبة"، بحسب تعبير الكاتب الأميركي إرنست هيمنغواي.
ربما تغير الأمر الآن، فبعد حدوث جائحة كورونا التي فاجأتنا جميعاً وأربكت العالم من حولنا، لم تعد العزلة هي نفسها التي كنت أذهب إليها طوعاً، مصدراً للمتعة والراحة. صارت عزلة إجبارية مخيفة يهيمن عليها الشعور بالقلق والتوتر والتباعد الاجتماعي، والفزع من فكرة الإصابة بالعدوى التي قد تنتهي بالموت أو حتى الخوف من الفقد المتوالي للأصدقاء. حالة الخوف انتابت الجميع إلى الحد الذي تحولنا جميعاً إلى كائنات افتراضية تتحدث من خلف شاشات باردة تفتقد دفء حضور البشر، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي معه أيضاً إلى دفتر عزاء لا أداة للتواصل بين الناس، وشاع إحساس عام باللاجدوى من كل شيء، فقد وضعنا هذا الوباء القاسي وجهاً لوجه أمام محنة وورطة سؤال الموت وأدخلنا إلى حالة من العدمية في علاقتنا مع كل الأشياء التي كانت مصدر بهجة لنا في السابق.
ربما في وسط هذا العدم يبقى الشعر وحده بالنسبة لي ركناً من أركان كينونتي ووجودي. والملاذ الآمن للنفس، والنور الذي يشرق في أرواحنا كلما توحش العالم وازداد عتمة وقسوة.
وما زلت أعتقد أن الشعر سيظل دائماً ذا جدوى للشعراء وللإنسانية في كل الأوقات العادية وقد تزداد جدواه أكثر في الأزمات الكبرى كتلك التي نعيشها اليوم؛ فهو إحدى طرق المقاومة للفناء المحيط من كل جانب، ويمكننا من اكتشاف تلك الندب التي تمتلئ بها الروح. وهو أيضاً الرفيق الذي لا يخذلنا أبداً في أوقات الوحدة. أو ليست الحياة تتكون أصلاً من تلك اللحظات الصغيرة من الشعور بالوحدة؟! كما يقول بارت في كتابه المهم "الغرفة المضيئة".
أظن من الصعب الحديث الآن عن أي كتابة شعرية تتناول جائحة كورونا وترصد انعكاساتها على حياتنا وذواتنا المهزومة أمامها، هذا ببساطة لأننا ما زلنا واقعين تحت أسرها وما زالت تخيم علينا بظلمتها التي ربما قد تمتد لسنوات ونحن نعاني من آثارها النفسية. ولأنني أرى أيضاً أن الكتابة بحاجة دوماً إلى مسافة زمنية ودرجة من درجات التأمل في التجربة الإنسانية، أما الكتابة عن الوباء الآن، فلا تعدو في أفضل الحالات أن تكون مجرد تعبير عن أفكار مشوشة وغير مكتملة لا تتسم بالعمق، وقد تسقط في فخ المباشرة الذي لا أحب للشعر أن ينزلق إليه.
محمد ناصر الدين (لبنان): ضد التفاهة المطمئنة
بلى لا بد من الشعر في زمن القحط، انطلاقاً من قول هولدرلن. وفي زمن كورونا الذي يتم فيه البحث عن لقاح "جسدي" للوباء، أجرؤ على القول إن الشعر لقاح الروح، ودواء الإنسانية من النقوش الأولى في كهوف آلتاميرا إلى يوم يخرج فيه فرسان الدينونة الأربعة. أكتب الشعر كمن يبحث عن هذا اللقاح، وأرى في العالم عوارض المرض: دأب التفاهة كي لا يسمع الشعر، وتحويله إلى حيادية لطيفة جبانة، أو إلى تشويش لا يضر ولا ينفع، أو إلى هامشية لا يمكنها أن تنقذ الحياة من قبحها، في زمن يراد فيه للشعر حتى في الأوساط الأدبية أن يكون أشبه بمريض الكورونا الذي ينبغي إخفاؤه في غرفة العزل.
عالمنا اليوم بلعبته الاجتماعية والسياسية والثقافية ومنطقه المحتاج إلى السرعة والضبط والسيطرة هو من الشعر بمثابة الكورونا من الرئتين… لأن الشعر هو المضاد الحيوي الذي يهدده في جيناته وحمضه النووي، ولأن الشعره وحده، متجاوزاً حتى الأديان في هذه النقطة، هو الوحيد الذي يملك نقاطاً للإرتكاز والمقاومة. أكتب الشعر لأن العالم من دونه عالم من الأموات أو بالأحرى عالم لا الموت يغيره ولا الحياة، عالم واحد وموحد، عالم يسير في كل يوم إلى التشابه ووحدة اللغة والتصورات والمفاهيم، عالم بلا شعر، عالم استيتيقي أكثر فأكثر تسوده راحة التفاهة المطمئنة. وحيث التاريخ ينظم ويثبت ويصنف، كان الشعر يضع علامات استفهام على هذا التقطيع والاجتزاء وتجميد الحس، لأن الشعر تكذيب للمعطى المباشر والموضوعي وجدلية تجعل كل ما تثبته البداهة متحركاً.
حين أكتب الشعر يحضرني ذلك الطفل ــــ المتسائل الذي لا يكل، على قول نيتشه، لأنه لم يخضع بعد لطغيان المعرفة وأحكامها المسبقة على الأشياء، والفتى رامبو راكضاً في الحبشة وحرار خلف "الحرية الحرة"، المتمردة على وقاحة اليقينيات ومحاولة إلغاء المجهول. يهرب بنا الشعر من محدودية المعجم الذي يحاول "زمن البث المباشر" حصر لغتنا فيه بدقائق البث الخمس أو السبع التي تعطى للمتكلم على أي شاشة اليوم، أو أخبار المرض الذي تتلخص بأعداد الإصابات والوفيات. يهرب بنا من شمس الواقع التي تشرق وتغرب مثل أي كوكب تافه إلى "الشمس المقطوعة العنق" كما يصفها أبولينير. انتشار خدمة "الخبر العاجل" اليوم على هواتفنا المحمولة هو تعد على اللغة. ينجو "الشعر" من أعراض المرض، الذي يطاول حاستي الشم والذوق لأنه على ما يقول لويس أراغون في جملة هي غاية في الأهمية "الشعر لا يطلب دائماً أن يكون مفهوماً بل هو ثورة للأذن"، الأذن التي هي بشرى الجسد للروح لاستنهاض الوعي. يدخل الشعر هنا في وظيفة كل نشاط فني، حمل الاعتراض على السائد والتافه والمسطح، اعتراض نفعه يكمن في مجانيته الكاملة إذ حين يقتحم الشعر الحياة فهو لا يتطلب بنية تحتية أو تجهيزات لوجستية ضخمة، بل إلى ذلك التوازن بين الصوت والصمت، بين الأذن والفم، وذلك الخيال الذي يجعل من دعبل الخزاعي يصور قبيلته الصغيرة في الصحراء بهذا الجمال: "كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت/وقصّ مرّ الليالي من حواشيها". علاقتي بالشعر "علاقة كهربائية" كما يقول دولوز، والقصيدة بكونها حمولة تكثيفية تصلني بالحياة بطريقة صحيحة، في زمن صار الواقع المعيش مختصراً بعمليات عرض وطلب: أقول في أحد نصوصي "الشعر سلحفاة تعلمني البطء"، إذ أشعر بالعجز عن مواكبة الماكينة الهائلة للكلمات والصور التي تمر أمامي على شاشة الهاتف أو الكمبيوتر.
وبالتالي أكتب الشعر كي أعارض أو أختلف عن ما تفرضه هذه الماكينة عليّ. حين يظهر الشعر أشعر بأنني صرت مباشرة خارج الماكينة أو "السيستم"، وأتذكر قول كوكتو "لا يجد الشعر كينونة في عالم لا يهتم إلا بالثرثرة". التعدد في المعنى، انفتاح أفق التأويل وانتقال السلطة الدائم في الشعر بين الشاعر والقارىء وتعدد أصوات القصيدة يضع في يدي مفتاحاً يدخلني فردوس "ميلتون" المفقود، لتعدد أصوات العالم، بحيث يصبح هذا العالم فرصة لا عائقاً، لكينونة ممتلئة ومكثفة يقلقها ما يسميه ايف بونفوا "وعي الفناء". يستنهض الشعر فيّ أيضاً هذه الناحية الوجودية من كثافة الحياة أمام الموت، لأن كل قصيدة نوع من السكنى في شعاع في قلب الأبدية، سكنى تفلت من العمر والزمن. هذه القوة الروحية للشعر هي ذات أهمية كبرى في زمن "القراءات المسطحة" والإيديولوجية والباعثة على العنف والكراهية. الشعر سحر، وستبقى قدرته في بث الروح في الكلمة وشد عصب الكلمات بعضها على بعض منافسة للآلهة في عملية الخلق والتكوين، أستذكر هنا قول المتنبي عن الشعراء: "نحن ركبٌ من الجنّ في زيّ ناسٍ/فوق طير لها شخوص الجمال".
يوسف عبد العزيز (الأردن) : لطخة سوداء في وجه الشعر
"ما جدوى الشعر في هذا الزمن العصيب، زمن وباء كورونا"؟
لعل هذا السؤال يثير الشجن في البداية لدى الجمهور، إذ قد يحتج أحدهم قائلاً: لندع الأمر للأطباء الآن، ولننح الشعر جانباً، ولكننا لو دققنا النظر في المنظومة الثقافية، لوجدنا أن لها تأثيراً طاغياً في ما حدث، وذلك من وقت ظهور الفيروس والطريقة التي ظهر فيها، إلى وقت انتشاره السريع، والتسبب في هذه الأعداد الهائلة من الإصابات المرضية والوفيات.
تعمل الثقافة، وضمنها الشعر، على تحصين البناء المجتمعي ضد الظلم والفساد والجريمة وضد التخلف. وعادة فالمجتمع المثقف هو مجتمع سوي، تقل فيه هذه المظاهر البغيضة التي تسيء إلى الإنسان، ويرتفع فيه الشعور بالألفة والمحبة والتسامح. والآن لو ألقينا نظرة على الأسلحة الفتاكة التي يتم إنتاجها، والتي تكفي لإبادة البشرية، لرأينا أنها لم تصنع أصلاً لحماية الأوطان بقدر ما صُنعت لقتل الناس أينما كانوا. أحياناً تحدث هناك انقلابات في بلد ما، فيقتل الناس فيه بعضهم بعضاً.
من هنا، فإن الشعر من خلال نسله العظيم المبثوث في الكون، ولكونه نسغاً للوجود، يمكنه أن يدخل المعركة لينتصر للإنسان. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن تأثيره كما الثقافة لا يكون سريعاً وخاطفاً، بل يأتي عبر تراكمات عديدة تحتاج إلى زمن طويل لتحقيق إنجاز نوعي.
والآن لو ألقينا نظرة على القرن العشرين لخرجنا بالنتيجة التي تقول، إنه كان قرناً متداعياً، فثمة عدد كبير من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، عملت على استباحة الكوكب بحروب طاحنة واحتلالات بغيضة، وصلت الذروة بانفجار حربين عالميتين ذهب ضحيتهما ملايين كثيرة. من المفارقات التي حدثت مثلاً في هذا القرن احتلال الجزائر وحرب الإبادة التي شنتها فرنسا على الشعب الجزائري الأعزل، فكان الجنود الفرنسيون يقطعون رؤووس الجزائريين، ويلعبون بها ككرة قدم فانتازية، ثم يأخذونها إلى المتاحف الفرنسية. في الوقت نفسه الذي كان الشعر والفن التشكيلي الفرنسي في أوج ازدهارهما، لكن يبدو أن تأثير الشعر والثقافة في فرنسا كان ضعيفاً في الحياة العامة.
"هل استطعت أن تواجه هذا الزمن شعرياً"؟
للإجابة عن هذا السؤال أقول: إن مثل هذه المواجهة لا تتم بطريقة فردية، وإنما بطريقة جماعية، وذلك من خلال وحدة الجسد الشعري في العالم، وتصديه إلى جانب المثقفين والمبدعين من روائيين وتشكيليين وسينمائيين ومسرحيين. إن إشاعة الجمال وحب الحياة والتمسك بقيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، هي شكل أصيل من أشكال هذه المواجهة. فالشعر والفن بشكل عام يساهمان بشكل فعال في بناء الروح الإنسانية. التصدي الجمالي لهذا الزمن العصيب، يمكن أن يتم ليس فقط من خلال النص الشعري واللوحة والفيلم والمسرحية، ولكن أيضاً من خلال الدراسات والندوات والحوارات والمهرجانات والكتب والمجلات، ومن خلال العمل الدؤوب للمنتديات الثقافية.
الأمر المحزن هنا، أن الثقافة في العالم العربي وفي بقاع كثيرة في العالم، هي ثقافة مهمشة ولا تجد اهتماماً يذكر من قبل الأنظمة الحاكمة، مما يجعل تأثيرها ضعيفاً.
"هل سيكون لهذه التجربة المريرة التي يتخبط فيها العالم، أثر على الشعر؟
في إجابتي على هذا السؤال أقول نعم. ففيروس الكورونا يهاجم الشعراء أيضاً، فيصيبهم بالمرض والإعاقات ويقتلهم، وقبل أيام توفي صديقنا الشاعر الأردني جريس سماوي- رحمه الله- جراء إصابته بكورونا. وبناء على ذلك، فإن هذا الفيروس سيترك لطخة كبيرة سوداء على وجه الشعر الجميل والفن بشكل عام. ربما ستمتلئ نصوص الشعراء بالفقد والألم والسواد. الأمر هنا شبيه بحرب مرعبة ضد البشرية، إذ إن الضحايا الذين يسقطون، والأعداد الهائلة من المصابين الذين يفتك بهم هذا الفيروس، ربما يفوقون أعداد مَن يمكن أن يسقطوا ويصابوا في أي حرب كبرى.
بقيت هناك مسألة مهمة لا بد من التطرق إليها في هذا الموضوع، وهي تتعلق بالسؤال عن الدولة أو الجهة التي تسببت في إطلاق فيروس كورونا، أو أسهمت بتصنيعه إن كان قد جرى تصنيعه، فثمة معلومات كثيرة غائبة عن سمع العالم، ولا بد من معرفتها. وفي هذا المجال لا بد للشعراء وللمثقفين واتحاداتهم وروابطهم الثقافية من إعلاء صوتهم لمعرفة ما جرى، ثم المطالبة لاحقاً بمعاقبة الجهات المسؤوولة عن هذا الدمار الهائل، الذي أحدثته هذه الحقبة الفيروسية في جسد الإنسان وروحه.
نبيل منصر (المغرب): عودة الوهج لقدسية المصير
"جدوى الشعر" سؤال ما فتئ يعود، بعودة أزمنة الشدة وتجدد أثرها الوخيم. ولعل أخط النذر التي حمل الشعر وزرها، تمثلت في مكابدة انفصال "الإلهي" عن الأرض، وانبثاق أغنية الحداد من فجيعة احتجاب العناية الإلهية وعزلة الإنسان أمام المصير. احتجاب له كل مرادفات "الليل" الداجي الكبير، الذي خاطر شاعر مثل هولدرلن بأن ينتزع من غسقه "كلمات تأرق" لتضيء. ليل هولدرلن يكثف تجربة الشعر الإنساني، في حركته العمودية المخترقة لكل الأزمنة والجغرافيات، باتجاه التأسيس المأساوي لما يبقى. فالإنسان الذي "وهب الطيش" وهب أيضاً "اللغة، أخطر النعم". كلمات هولدرلين لا تزال تتوهج في ليلنا الإنساني المديد، لتعلمنا، نحن الذين "لم نوهب مكاناً فيه نستريح"، أننا وهبنا أساساً "اللغة"، حيث تتقد النار: مؤسسة المكان الشعري.
ظل هذا المكان، الذي يلوذ به الشاعر، هو ما يمنحني شخصياً قوة الإيمان بأهمية الشعر في مواجهة أزمنة الشدة، بما فيها زمن كورونا. عمودياً، يتقاطع هذا الزمن مع المضايق والأهوال، التي شرطت وجودياً، على امتداد حقب وعصور مختلفة، خطوة الإنسان على الأرض. إن احتراق المدن وسقوط الحضارات وانتشار الأوبئة وغرق البلدان، أجج دوماً نار المراثي في قلب الإنسان. بل، إن "التقدم" نفسه، يتقاطع، في شرطه ومآله، مع أزمنة الشدة، التي يستجير الإنسان من صحرائها بلغة الشعر، ومجهول معرفته وجماله، وفتنة تركيبه ومتخيله. نحن ورثة أغنية الحداد الطويلة الطافحة بالوجع، لكن المليئة أيضاً بإشراقات الوعد الإنساني بالعيش شعرياً على الأرض.
شدة كورونا هي حظنا الشخصي، من هذا القدر العمودي. هي جرعتنا "المهلكة" التي جعلتنا نلوذ بـلغة الشعر، بشاردات الأغاني، لنثبت أقدامنا على الأرض. من هشاشة لغتنا الشعرية وزفيرنا الإنساني العميق، نخاطر ننفخ في طيننا المهدد بالهلاك. ذلك هو وعد الشعري فينا، الذي يجعلنا نعيد التحليق بحطامنا الأرضي. لغة الشعر "تحتانية" الاتّقاد، وهي إذ تخلق تركيبها الضروري الغريب، فإنها تعيد بعث رموز من هذا القدر العمودي، في إيهاب شخصي، يبث روح المقاومة في "كلمات البشر"، بجعلها، مرة أخرى "تخاطب في الظهيرة الأجيال القادمة"، مثلما تؤكد نبوءة هولدرلن. إن المخاطرة بإعادة بث هذه الروح شعرياً، تعيد الوهج لـ "قدسية" المصير الإنساني على الأرض.
تلك تجربتي وحظي الشخصي من الشدة. تيه وخرس وعتمة وأبواب عملاقة انحفرت تحتها، في الحيز الضيق الصغير، متاهات لا نهائية. وعلى قدر التيه، بلورت الذات آلية دفاعها الغريزي، بالانغراس في حفرة الكلمات. القراءة ذللت الخوف، فيما هي تهبط بخيوطي الواهية المرهفة، إلى جوف التجربة الإنسانية المتحصنة بالأعماق. حيوات وتجارب كانت بانتظاري في كتب أرجأت قراءتها لأسباب مجهولة. كأن الإرجاء كان فعلاً موعوداً بهذه الشدة المحررة التي أطلقت كلمات، فجأة، من عقالها القديم، وجعلتها تنتشر في الروح، نافذة عبر المسام. مصافحة الكلمات في أرضها المعتمة، هو ما أضاء بداخلي طريق العودة للكتابة بوصفها استئنافاً، مشروطاً، هذه المرة، بمواجهة شخصية لشدة الوباء. شدة أثمرت قصائد لا تتنازل عن الوعد الشعري في مقارعة الأهوال. ما يبقى ينبغي أن يبقى دالاً، في القصيدة، على زمن الشعر، بوصفه خلقاً وليس مجرد آلية تنفيس وتعبير. ذلك رهاني المتجدد دائماً، في أن أجعل قصيدة الأرض تنهل "نار السماء" من دون خشية هلاك. ذلك، لأن"العناية المنقذة" للكلمات توجد، أساساً، في هذه المخاطرة.
خالد البدور (الإمارات): استبصار المعاني العميقة
بمجرد النظر إلى أحوال العالم وأخباره وآلامه اليوم سندرك جدوى الشعر وأهميته. لا شك في أن الشعر الذي ساعدنا دوماً على استبصار المعاني العميقة لحياتنا يمكنه اليوم أن يفتح طاقات ضوء في الزوايا المظلمة والمؤلمة لعالم الوباء هذا. من يعرف قيمة الشعر يدرك أنه يمكن أن يكون العزاء والملجأ الذي ننزوي فيه ونعود إلى ذواتنا، حيث يمكن أن نعيش على خبز الصبر وماء الحكمة. وبقدر ما يعري الشعر الأنا المتضخمة للإنسان المعاصر ويكشف عن خواء حياتنا المصطنعة وراء عوالم افتراضية فارغة، يمكنه كذلك سقاية أحلامنا ونشر الضوء في أرواحنا المتعبة، والتخفيف من ثقل المصائب قليلاً.
خلال الجائحة ركزت شخصياً على الاطلاع على تجارب شعرية مختلفة من مناطق عدة من العالم لم تتوفر لنا بعد في العربية، ما جعلني أرغب في التعريف بها وترجمتها ونشرها. تلك القراءات أكدت لي أن الشعر مع كل ما يقال لازال يحتفظ بأهميته وحضوره، بل وجد قنوات جديدة لينتشر. بكل وضوح نشاهد أن ثورة قنوات التواصل الجديدة أتاحت لجيل جديد من الشعراء والشاعرات كتابته والاستماع إليه وتبادله بين قارات العالم بشكل لم يكن متوفراً سابقاً. هناك اليوم العشرات من الشعراء والشاعرات يستطيعون النشر بكل سهولة، ولديهم في قنواتهم الخاصة متابعين بالملايين يطلعون على تجاربهم ويشاهدون كيف يكتبون وكيف يعيشون بل ويمكنهم التواصل معهم بشكل شخصي. هذا بلا شك يهب الشعر حياة جديدة وآفاقاً لا محدودة.
حسين درويش (سوريا): ما أحوجنا إلى الشعر
الحياة قاسية من دون شعر، جافة وينقصها البريق، لربما كانت قشة كورونا التي قصمت ظهر البعير، لكنها التي كشفت عن الصلة التي انقطعت بين الشعر والناس إلا ما ندر.
نتساءل: متى نحتاج الشعر، وأين نبحث عنه، وهل حقاً نحن نحتاجه؟ تلك الأسئلة ظهرت أجوبتها جلية خلال عام مضى والمسافات تكبر بين البشر، وتبتعد طرق تواصلهم لتصبح ما كنا نخشاه يوماً من أن نكون عبيداً للتكنولوجيا، بل ارتفعنا درجة أخرى لنصبح أسرى التكنولوجيا.
خلال عام من انتشار هذا الوباء عالجت البشرية وحدتها بطرق مختلفة حيث الغناء والرقص والعزف عبر الشرفات للإعلان عن التضامن المؤازرة مع من يشبهونهم في وحدتهم أو أحزانهم، عالجوا يأسهم وقلة حيلتهم أمام وحش غامض غير معروف وغير مرئي يصح معه قول المتنبي: لا تحقّرنّ صغيراً في مخاصمةٍ / إن البعوضةَ تُدمي مقلةَ الأسد.
بينما عبّر شعراء "زمن كورونا" عن حضورهم الخافت بقصائد مرتعشة ينزّ منها يأس كبير، لم أنج منه بشكل خاص، لقد نظرت ملياً نحو الذين ضاعفت الجائحة من عذابهم، نظرت إلى الذين رمتهم أزمنة القهر في الفقر وحرمتهم نعمة العيش الآمن، نظرت من تلك الزاوية إلى قسوة الوحدة، وتمنيت لو أمتلك صوتاً جميلاً وقوياً لأقف على الشرفة وأغني، لربما خلقت لحظة بشرية صافية يستحسنها جيراني.
مع الشعر بدأت - وبعد أشهر من انتشار الجائحة - أعبر نحو فكرة تحولت إلى نص تحوّل إلى قصيدة، بدأت أعي أن يأسي وقنوطي سيزدادان أكثر إن لم أفرغ ما بداخلي، ومثلي فعل كثيرون، وأكاد أجزم أن الشعر أنقذهم من العذاب، أن الشعر أعطاهم مفاتيح الأبواب التي أغلقوها على وحدتهم، لقد حررني الشعر من هذه المرارة، لم أكتب القصيدة فحسب، بل عدت لقراءة المزيد من الشعر لأكتشف المزيد من الذين يشبهونني، ولديهم هواجسي، ومخاوفي، ولطالما نظرت إلى شعر "الأمل" نظرة غير منصفة، وكثيراً ما أتهمته بالفرح المجاني والأمل الكاذب، لكنني - وفي ظل الجائحة - وجدت فيه ما أبحث عنه، ولأكتشف أن القشة (قشة كورونا) التي قصمت ظهر البعير، هي القشة التي يتمسك بها الغرقى، إنها قشة الأمل. كم نحتاجه... كم نحن يتامى دون شعر.
لميس سعيدي( الجزائر): اليد التي تنقذ الغرقى
في مطلع سنة 2019، أصدر الكاتب الفرنسي الشاب جوزيف بونتوس (توفي مؤخراً في 24 فبراير (شباط) 2021، كتابه الأول تحت عنوان "عودة إلى السطر"، وهو عبارة عن رواية شعرية، أو بالأحرى نشيد مكتوب بتقنية "الشعر الحر"، يحكي فيه الكاتب عن تجربته كعامل في سلسلة إنتاج في أحد المصانع. وأنا أنصت إلى جوزيف بونتوس وهو يتحدث عن كتابه في إحدى الحصص التلفزيونية، انتبهت (ولم تكن المرة الأولى) إلى إمكانية أن يتحول الشعر إلى يد حقيقية تمد فتنقذ الغرقى، ولا أقصد هنا معنى مجازياً أو وظيفة طوباوية تسكن الأغاني وتتبخر مع صدى الصوت، لكنني أتحدث عن وظيفة ملموسة وعملية، عن يد بخمس أصابع وخطوط قدر تتحول إلى وديان صغيرة حين ترتبك.
في سنة 2007، تعرفت إلى الشاعر اللبناني الكبير بول شاوول؛ تعرفت إلى كتبه التي قرأتها جميعاً (بما في ذلك النصوص المسرحية) وإلى الكيان الشعري الذي يسكن خطاه التي تعرفها شوارع بيروت وزواياها وتحديداً شارع الحمرا. كان بول شاوول يتحدث دائماً عن مفهوم "العزلة المأهولة" في مواجهة الأوبئة، أوبئة الحروب الأهلية والطائفية، العزلة المأهولة بالقراءة والكتابة والشعر والترجمة في مواجهة ما يدمر وجود الإنسان، أي ما يدمر قدرته على الإبداع والمحبة. وأنا أستمتع باكتشاف هذا المصطلح ومفهومه، لم أتخيل أبداً أن "العزلة المأهولة" ستتجسد أمامي من خلال روتين يومي، سوف أعيشه وأختبره لمواجهة وباء حقيقي، أقصد وباء يفتك بالأجساد وينتقل بسرعة الكذبة.
في أبريل (نيسان) 2020، وبعد قرابة شهر من بداية الحجر المنزلي، حاولت خلاله أن أكتب بعض القصائد عن خطوط القدر التي ستمحوها المطهّرات وتعجز عن قراءتها العرافات، والكمامات التي تحمي أجسادنا كما تحمي الأقنعة المجرمين، وعن "عودة الزمن إلى الساعات المعطّلة" وعودة حصتنا من الأمل والقسوة، أطل عليّ من مكتبة غرفتي (وقد كدت أن أيأس) كتاب لونه أزرق، كتب على غلافه باللغة الإسبانية: خورخي لويس بورخيس، الأعمال الشعرية الكاملة. كنت قد اشتريت الكتاب من إحدى المكتبات بمدريد في أواخر سنة 2016، ولم تمكنني لغتي الإسبانية آنذاك من الاستمتاع بعوالم بورخيس الشعرية، وحتى بعد سنوات من دراسة اللغة الإسبانية وتمكني من قراءة نصوص لخوليو كورتاثر وأوكتافيو باث وفيديريكو لوركا، لم أفكر في محاولة اكتشاف ذلك المحيط الأزرق، حتى أطل عليّ وسط زحام الخوف واليأس و"تردّد الأمل". ووجدت نفسي تلقائياً وبحركة شبه آلية، أقرأ وأترجم، وأقطع أذيال جثث وهمية تصل تباعاً إلى المذبح. لم يقتصر الأمر على "عالم بورخيس الأزرق" لكنه انتقل إلى عوالم بولانيو وخوسيه إيميليو باتشيكو، وماريو بينيديتي، وإيديا بيلارينيو وأونيتي وخايمي سابينس، هذه العوالم التي تبدو في أول الأمر هشة وغير مرئية كفيروس تقتله رغوة الصابون، لكنها صلبة كالموت والحب.
مع الوقت، صارت كل قصيدة تتحول إلى إبرة جديدة في ساعة الساحة الرئيسية التي لم يعد يمر من أمامها أحد، حتى كثرت عقاربها وصارت بالطول ذاته، تشير إلى الزمن الذي أختاره، زمن لا يعرف ساعات حظر التجوال، ولا ساعات العمل أو الدراسة أو حتى تقدم العمر وموعد رحيل الجسد.
تعيد الجائحة طرح إشكالية أساسية: هل نغامر بزمن إضافي من الحياة في سبيل المتعة أم نكتفي "بالأمان المملّ" لنحمي أنفسنا في سبيل أيام إضافية سوف تنتهي بالموت في كل حال؟ ولا أجد إجابة لهذا السؤال سوى تلك الجملة التي كتبتها وأنا أعيش عزلة المرض مع والدي منذ قرابة عشر سنوات: لولا الشعر، لما فرّقت بين هذه الأيام المتشابهة والملتصقة كتوأمين سياميين.
سيظل الشعر بطريقة ما، تلك الشامة الظاهرة في وجنة الحياة، الشامة التي تشكلت من اشتهاء الوجود جمالاً لم يعثر عليه وهو يحمل في أحشائه هذه الأيام.
زاهر الغافري (عمان): يا شعراء العالم اتحدوا
شخصياً أظن أن جدوى الشعر تتجلى أحياناً في أزمات كهذه، أعني زمن وباء الكورونا لأن الشعر على الدوام ما ينفك يطرح الأسئلة الشائكة، الغياب، الموت، الحب، العزلة، هذا هو البعد الميتافيزيقي المتأصل في تجربة الكائن على الصعيد الوجودي. وفي ما يخصني استفدت قدر الإمكان من العزلة والحجر الصحي فأنجزت، عملاً سيصدر قريباً تحت عنوان "العابر بلا كلمة" وهذا العمل كتب منذ بداية الوباء حتى الآن. من متابعتي لاحظت نوعاً من الانبعاث الغريب للشعر، ليس في العالم العربي فحسب بل في العالم ويبدو أن التقنيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي تساعد على الانتشار. لذلك تجد الشعراء الشباب والشاعرات يخوضون تجربة الكتابة الشعرية حتى لو لم تتحقق الأدوات الفنية فعلياً، فبعضها يرقى إلى الخواطر الشعرية أو شيء أشبه بالبوح الذاتي.
نعم تجربة مريرة ولكنها تنفتح على آمال شعرية وكتابية وفنية أيضاً. لا أظن أن العالم سيتوقف وبالتالي لن يتوقف الشعر مطلقاً كما أنني أجد في الأمر مفارقة غريبة. ففي فترة هذه الجائحة هناك إشارات أكثر من ذي قبل حول ما يمكن أن نسميه الأخوّة الشعرية. وطالما هناك شعراء في العالم يزدهر التواصل الشعري هنا وهناك. بالنسبة لي الأمر ذاته يحدث، لذلك رحت أبحث عن تلك "الكتابة المبهمة، الجسورة" التي تحدث عنها الشاعر الفرنسي إيف بونفوا. وفي ما يتعلق بالعالم العربي راهناً، أجد أنه من الضروري أن يمتلك الشاعر صوتاً إضافياً عنيداً ضد هذا الوباء، والخروج أيضاً من السطحي للوصول إلى الأعماق. وعطفاً على ما سبق حول جدوى الشعر في زمن الكورونا. فأنا أظن أنه الوقت الملائم لكي يعود الإنسان إلى ذاته فيتأمل ماضيه وحياته. فالإنسان على هذه البسيطة وصل من الغطرسة والقوة بحيث نسي الطبيعة التي يقوم بتدميرها. وبمناسبة اليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 مارس (آذار) في كل عام أقول: يا شعراء العالم اتحدوا.
محمد الغزي (تونس): في مواجهة الألم والضجر
أصبحت الحياة، منذ انتشار وباء كورونا، مثل بندول شوبنهاور الذي يتأرجح باستمرار بين الألم والضجر، في حركة رتيبة لا يمكن تعديلها أو تغييرها أو التغاضي عنها.
فالجائحة التي فرضت علينا، في ظرف أشهر قليلة، قوانينها المجحفة، أخضعتنا، أفراداً وجماعات، إلى نمط مخصوص من السلوك، قوامه: التباعد الاجتماعي.
والتباعد، في سياق الجائحة، يعني السير عكس غرائزنا الأولى. فإذا كان الأصل في حياة الإنسان الاجتماع والاتصال، فإن الجائحة فرضت قانون الافتراق والانفصال. وإذا كان الأصل في حياة الإنسان الإقامة بين الناس في كنف الأمن، فإن الجائحة جعلت الإقامة بينهم مصدر خوف ورعب. وإذا كان الأصل في حياة الإنسان استخدام حاسة اللمس لتبادل المشاعر والأحاسيس، فإن الجائحة عمدت إلى تعطيل هذه الحاسة، وإقصائها بعيداً عن حياتنا الاجتماعية والوجدانية. بعبارة أخرى فرضت الجائحة على الإنسان أن يعود، من جديد، إلى مغارة وحدته، ليعيش، داخلها، مرتجفاً من الوحشة والخوف.
في هذه المغارة بات على كل فرد أن يبتكر طريقة لكي يراوغ الموت والخوف والكوابيس التي تداهمه كلما حلّ الليل.
والشعر، ككل الفنون، وسيلة تحرر. لهذا كان استدعاؤه، في هذه الظروف، ضرورة لإنقاذ الروح، قبل البدن، من العطب الذي أصابها بعد ما أودعنا التراب عدداً من الأحبة، وبعد ما تحوّلت الحياة الاجتماعية إلى كابوس خطير.
لقد كان الشعر دوماً وجهاً من وجوه الشجاعة، بل إن الكاتب الفرنسي فابريس ميدال يعتبره الشجاعة نفسها. بسبب من هذا رمزت الثقافة الغربية إلى الشاعر بشخصية أورفيوس، هذا البطل الأسطوري الذي اجتاز كل درجات الجحيم، غير عابئ بأهوالها، تحركه طاقة الحب للمضي قدماً إلى الأمام. تحيط به الحيوانات الكاسرة التي خضعت لسلطان عزفه وموسيقاه.
وفي خضم هذه الجائحة يمكن أن نضيف مع الكاتب الفرنسي: على كل شاعر حقيقي أن يجتاز الجحيم مثلما حصل مع أورفيوس حتى يكون جديراً بصفة شاعر.
وعندما نتحدث عن الشعر فنحن نتحدث عن كتابته وقراءته في آن.
القراءة، كما الكتابة، محاولة لكسر العزلة، باستدعاء أصوات تنتمي إلى أزمنة وأمكنة مختلفة. والقراءة، كما الكتابة، تبديد لظلمات المغارة، عن طريق أرواح الشعراء المشتعلة على الدوام. والقراءة أيضاً محاولة لتأثيث وحدتنا وبحث ممضّ من أجل الظفر بصداقات جديدة وإن كانت في عصور بعيدة وأماكن قصية، سفر إلى أماكن بات من الصعب الوصول إليها.
يقول بول سيلان إن الشعر يد ممدودة، لكن هذه اليد لا يتلقفها الآخرون ولا يحاولون الإمساك بها... القراءة هي التشبث بتلك اليد الممدودة ومحاولة للإمساك بها.
لكن الشعر أيضاً ضربٌ من اللعب. ومثل كل لعب، غايته في ذاته أو كما يقول الفلاسفة ليس في اللعب لأن ولا لماذا. إنه هذا النشاط الحر الذي يتيح للإنسان أن يتعالى على ذاته. وينطلق نحو الحرية. اللعب هو قرين المتعة والاستمتاع. وعندما يكون الشعر لعباً فنحن لا نكتفي بكتابته إنما نعيشه ونكونه، فيتحول عندئذ، كما قال البعض، إلى نور داخلي تستضيء به بصائرنا.
من هنا تكون الكتابة في مثل هذا الظرف شكلاً من أشكال المقاومة اجتيازاً للجحيم، أي تكون انتصاراً على قطبَي الألم والضجر اللذين تحدث عنهما شوبنهاور.