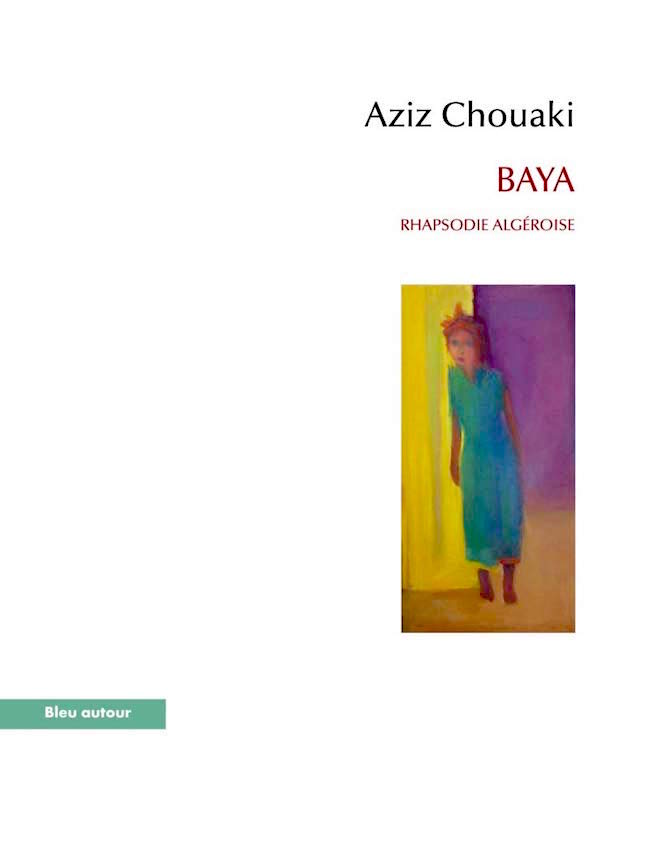معيبٌ الصمت الذي لفّ وفاة الكاتب والمسرحي الجزائري الفرنكفوني عزيز شواقي إثر نوبة قلبية. صمتٌ لم تقطعه سوى بعض الوسائل الإعلامية الجزائرية التي نعته بأسطر قليلة من دون أن يتوقف أيٌّ منها عند مسيرته الكتابية والفنية الحافلة بالإنجازات. ففي الميدان المسرحي، ترك لنا نصوصاً مهمة أُخرِجت على خشبة أبرز المسارح الفرنسية، مثل "البرتقال" (1998) الذي خطّ فيه تاريخ وطنه من عام 1830 وحتى نهاية التسعينات، أو "أمل" الذي قارب فيه مأساة المهاجرين غير الشرعيين. وفي الميدان السردي، وضع روايات لا تقل أهمية، نذكر منها "نسر" (2000) و"نجمة الجزائر" (2002).
لكن خلف هذه العناوين المعروفة، ثمة نصٌّ مؤسِّس له بعنوان "بايا" يجهله معظمنا لوقوعه في طيّ النسيان بعد فترة قصيرة من صدوره عام 1989 عن دار نشر جزائرية صغيرة. نصٌّ ألّفه شواقي عام 1986 على شكل قصيدة ملحمية مغنّاة (rhapsodie)، صاعقة شكلاً ومضموناً، وأعادت دار "بلو أوتور" الفرنسية نشره حديثاً بعدما أجرى صاحبه عليه تعديلات طفيفة.
قيمة هذا العمل تكمن أولاً في كونه نصّاً هجيناً يتعذّر إدراجه ضمن جنس أدبي محدَّد، إذ نتلقّاه كقصيدة ملحمية حرّة، كما سبق وأشرنا، وفي الوقت نفسه كرواية ومونولوغ مسرحي ومونولوغ داخلي ودفتر يوميات حميمي وسيرة ذاتية لشخصية نسائية أخّاذة تعيد تحت أنظارنا تشكيل ماضيها من دون إهمال حاضرها. هكذا نكتشف مع بايا (اسم هذه الشخصية) تجربتها الحياتية، بدءاً بصداقاتها الأولى وعلاقاتها بأفراد عائلتها والسنين التي أمضتها في حيّ سان أوجين في العاصمة الجزائرية، ومروراً بظروف لقائها بزوجها صلاح وبمآسي حرب التحرير التي اختطفت منها شقيقها وأيضاً بعض معارفها الأوروبيين، ونشط خلالها "التنظيم العسكري السرّي" الفرنسي الإرهابي، وانتهاءً باكتشافها فرنسا بحماسة مؤثّرة إثر سفرها إلى باريس.
وعلى طول النص، تسائل بايا نفسها ببصيرة، على الرغم من بساطة شخصها، متجنّبةً الوقوع في المانيّة (manichéisme)، أثناء تحليلها حياتها، أو إضفاء طابع مثالي سواء على زمن الاستعمار الفرنسي أو على مرحلة الصراع المسلّح ضدّه أو على مرحلة الاستقلال. وإذ غالباً ما تحتكر الكلام داخل النص مجبرةً إياناً على الإصغاء إلى صوتها المركزي، العالي، الكاسح، الذي يمنحنا الدوّار أحياناً، لكن ثمة أصوات أخرى ترتفع فيه من حين إلى آخر، كصوت الراوي الذي يتدخّل في عملية السرد لكن بشكلٍ محدود جداً، والأصوات المتقاطعة في الحوارات التي تستحضرها بايا ضمن مونولوغها.
ومن مجموع هذه الأصوات، تتجلى هذه الشخصية كامرأة حسّاسة، ساذجة قليلاً، لكن هدّامة ومليئة بالتناقضات، تنطلق في عملية استذكارها إثر تأمّلها صوراً فوتوغرافية تغطي سنوات الأربعينيات والخمسينيات والستينيات وتشكّل فرصةً لها للعودة إلى الفصول الرئيسة لحياتها على خلفية التاريخ الحديث والعنيف لوطنها. وخلال مونولوغها السديمي الذي لا يحترم أي ترتيب زمني، بل تتداعى تفاصيله على وقع تداعي ذكرياتها، تنظر إلى نفسها بلا مواربة، كما لو أنها أمام مرآة، ساعيةً إلى أجراء جردة في معيشها. وفي هذا السياق، يشكّل برنص الحمّام، الذي تكرر بايا مراراً واجب إعادة حياكته، استعارةً لقدرها وفي الوقت نفسه لتاريخ الجزائر.
لكن النظرة الملقاة داخل النص تبقى دائماً فردية، ولا تندرج ضمن صراع جماعي، عقائدي أو نسوي. ومع ذلك، أو ربما بفضل ذلك، يتمكّن شواقي فيه من قول حقائق وأشياء ما زال كثيرون في الجزائر يرفضون تقبّلها، ضمن خطاب يقوم أكثر على السخرية من الذات منه على التمرّد أو التحريض. وفي هذا السياق، تسجّل شخصيات النص الفرنسية ــ بجاذبيتها ــ قطيعة مع الرؤية السلبية للفرنسيين التي تتسلط على الكثير من السرديات الجزائرية. شخصيات لا يبتكرها الكاتب للتعبير عن حنين لـ "الأقدام السوداء" أو لفترة الاستعمار، كما ظنّ بعض النقّاد الجزائريين على خطأ، بل لتصوير برقّة مؤثّرة الطابع الكوزموبوليتي لمجتمع الجزائر آنذاك. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سفر بايا إلى باريس الذي يشكّل فرصة له من أجل توجيه تحية لفرنسا وتعددية مجتمعها، أو بالنسبة إلى مونولوغها ككلّ الذي لا يسيّر إطلاقاً رؤية كاريكاتورية حاقدة لهذا البلد وأبنائه، بل رؤية إنسانوية قائمة على فضيلة المصالحة والتسامح. وضمن هذه الرؤية، تعبّر بايا عن محبتها ليسوع ومريم العذراء، من دون التنكّر لهويتها الدينية، وتأسف لأن الحرب تعمي بصيرة الناس إلى حد لا يعودون فيه قادرين على رؤية روعة الطبيعة ودورة الفصول والأشياء الجميلة الكثيرة التي تحيط بهم أو تلك التي تجمعهم. وعلى الرغم من عنف التاريخ الذي خضعت له وظروف حياتها صعبة، تتمكن دائماً من العثور في الكلمات على ما يكفي من الجنون والشعر والموسيقى للإيمان بالحب والأساطير الذهبية، لاقتناعها بأن "الكلمات تساعدنا على الحياة".
قناعة يتشاركها الكاتب من دون شكّ مع شخصيته الرئيسة، كما تتجلى بقوة في المناورات اللغوية الغزيرة التي يلجأ إليها وتمنح نصّه كل قيمته، وفي مقدّمها خلطه اللغة الفرنسية بالعربية والأمازيغية والإسبانية، تماماً كما سيفعل في نصوصه المسرحية اللاحقة، مبتكراً لغةً جديدة مدهشة في إيحاءاتها تقوم على تلاعبٍ عبقري بالكلمات، على طريقة ريمون دوفو، وتمدّ سرديته بإيقاعٍ موسيقي يتوافق كلياً مع الفيض السديمي لذكريات بايا. إيقاع يفسّر العنوان الفرعي لهذه النص، Rhapsodie algéroise، الذي يقول بدقّة علاقته الوثيقة بالموسيقى الحرّة المستوحاة من موضوعات شعبية.
وبالتالي، لم تخطئ الباحثة الفرنسية مارتين ماتيو جوب، في مقدّمتها لهذا العمل، بتحدّثها عن "مرحٍ لفظي"، فداخله يستخدم شواقي بمتعةٍ وفنٍّ كبيرين جميع التقنيات البلاغية المعروفة منذ رامبو من أجل تعزيز طابعه الفكاهي: اللجوء المكثّف إلى التجنيس أو التورية، استثمار الكلمات المتعدّدة الدلالات، اشتقاق كلمات أخرى من مفردتين أو أكثر (mots-valises)، الانحراف الطريف والحاذق بمعنى بعضها، الالتباسات السمعية... وفي ذلك، تندرج كتابته ببداهة ضمن ذلك التقليد الجزائري الشعبي والأدبي المعروف بميله إلى الابتكار اللغوي وإيمانه بسلطة الكلمات.