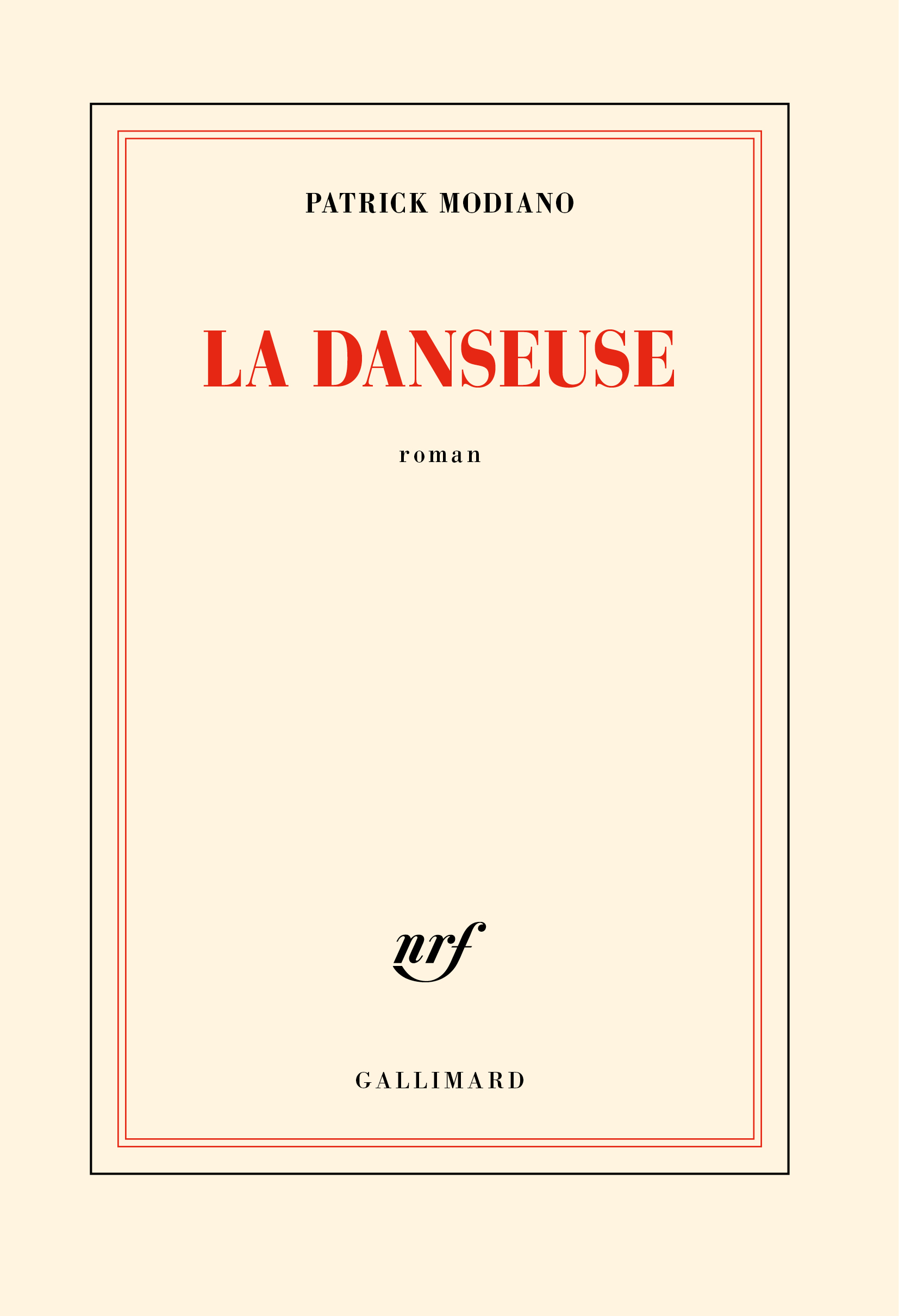ملخص
يعيد الكاتب في هذه الرواية ابتكار لحن الزمن الذي يعبر من دون أن يتوارى كلياً
من رواية إلى أخرى، ما برح الكاتب الفرنسي باتريك موديانو (نوبل، 2014) يتابع بحثه عن الزمن الضائع، آملاً أن يفضي به إلى "فسحة مشمسة أو شاطئ، إلى لحظات ما زال ممكناً إنقاذها من النسيان، وتمنحنا الانطباع بحاضر سرمدي". وضمن هذا البحث تندرج روايته الجديدة "الراقصة"، التي صدرت حديثاً عن دار "غاليمار"، ويقترح علينا فيها رحلة مثيرة داخل مدينة بات يتعذر التعرف إليها (باريس). رحلة صيد ذكريات ما زال نورها الضعيف والضبابي يشع، قادماً من ماض بعيد.
"هل كانت حقاً سمراء، تلك الراقصة التي شاركها الراوي فيما مضى نتف حياة ونزهات ثلجية من حي بيغال إلى باب شامبيري؟ أم كان شعرها أشقر داكناً؟" منذ الجملة الأولى، يحل الشك وتتعثر الذاكرة. ولا عجب في ذلك، فالذكريات، كما هي الحال دائماً مع موديانو، ليست حقيقة مؤكدة، وبالكاد تحييها ظروف خاصة "تطفو فيها على السطح لحظات تبدو وكأنها مقبلة من نجم كنا نظن أنه انطفأ منذ زمن طويل".
في الرواية، لا اسم للراقصة، بل فقط وصف جسدي، لأن الذاكرة انتقائية، لكن في الأقل، ثمة صور لها ولطفلها بيار يمكن العثور عليها، لدعم هذه الذكريات، بينما لا أدلة مادية متبقية على حقيقة "الأشباح" الآخرين الذين ما زالوا يسكنون مدينة تغيرت لدرجة أن الراوي -صنو الكاتب- يواجه صعوبة كبيرة في العثور على آثاره فيها.
50 عاماً مضت وهو يتساءل: ماذا حدث للراقصة وطفلها؟ تساؤل يبرره دور هذه المرأة الكبير في تغيير مجرى حياته، حين كان لا يزال شاباً يتدرب على الكتابة، وإخراجه من العدم الذي كان يتخبط به. كيف؟ بمنحه مثالاً، شغفاً ونظاماً كان يفتقد لهما. فمثلما أن الرقص نظام تقشفي للجسد "يسمح لمن يعانقه بالبقاء على قيد الحياة"، الكتابة نظام تقشفي للذهن والروح، لا يلبث أن ينقذ الراوي آنذاك، بـ"منحه معنى لحياته، ومنعه من الانجراف بعيداً". هكذا، تتراءى على طول الرواية عناصر مقارنة بين الرقص والكتابة: النظام التقشفي، وأيضاً تلك التصحيحات والتكرارات الضرورية في كلا المجالين، من دون أن ننسى الرشاقة والأناقة اللتين تنتقلان من حركات الراقصة إلى أسلوب الكاتب، من ثم ذلك البحث عن الجمال في قلب فوضى الوجود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما في جميع أعمال موديانو السابقة، تنتظرنا في "الراقصة" أطراف خيوط مقطوعة، ما إن نشد عليها حتى تطفو على السطح لحظات من حياة سابقة، لقاءات صدفوية تفضي غالباً إلى لقاءات أخرى، لكن كما يشير إليه عنوان الرواية، تبقى راقصة الباليه شخصيتها المركزية ومحور قصتها الرئيس، فنرافقها يومياً من غرفتها الصغيرة، ثم من الشقة التي ستسكنها مع طفلها، إلى محترف الرقص حيث تتلقى دروساً مع مدرس روسي شهير، قبل أن تقفل عائدة إلى دارها.
ومع أننا سنشاهد، من حين إلى آخر، أشخاصاً آخرين حولها، كانت تعاشرهم وتمضي بعض السهرات معهم، لكن الانضباط الذي يتطلبه امتهان الرقص الكلاسيكي، وتلتزمه بتزهد كبير، كان يقلص حياتها إلى ذلك الذهاب والإياب بين المنزل والمحترف، مشكلاً بذلك حبل خلاص متيناً كانت تتشبث به كي لا تنجرف في اتجاه ما اختبرته خلال سنوات طفولتها ومراهقتها. ماض يبقى غامضاً حتى النهاية، لكننا نعرف أنه كان مقلقاً، حين يظهر فجأة رجل من تلك الفترة، ويشكل تهديداً لها ولطفلها أو حين يذكر بشكل خاطف اسم والد طفلها الذي لن ندري حتى النهاية كيف توارى منذ فترة طويلة، ولماذا.
حبكة هذا النص القصير معاصرة، وزمن السرد فيه مؤرخة بدقة داخله (يناير 2023)، لكن تفاصيل كثيرة، "من أزمنة أخرى"، تبلبل علامات الاستدلال الزمنية لقارئه وتغوص به داخل غبش ساحر. وسواء الوصف الضبابي للأحياء التي يعبرها الراوي وحده، أو برفقة الراقصة، أو الإضاءة الخافتة للشقق التي ندخلها معهما، أو الشخصيات التي تحمل أسماء عائلات غريبة بحيث يتعذر تصديقها، كل هذه العناصر تسهم في إحلال ذلك الغبش، مغذية شعور الغرابة المرافق له، قبل أن نستشعر تدريجاً حالة من الضيق، إثر استحضار ذكريات تلك المضايقات التي كانت تمارسها على الراقصة شخصيات شريرة تفوح منها "روائح مستنقعات"، أو تلك الخاصة بتبادل حقائب مليئة بالنقود.
وهنا يكمن كل فن موديانو، أي في زرع تلك البلبلة، أو ذلك القلق، خلف الرقة الظاهرة للقاءات ومشاهد مسرودة ببساطة مربكة، وفي تساؤله الثابت عما يتبقى، حين ينتهي كل شيء، أي تلك اللحظات التي تبقى سليمة، حية، داخل ذهننا، مثل "حاضر سرمدي". وفي هذه الرواية النيرة، التي لا تتجاوز 100 صفحة، يمارس الكاتب هذا الفن مجدداً، برميه شباكه مرة أخرى في مياه الماضي لانتشاله، كغنيمة ثمينة بالكاد يحجبها ضباب الذاكرة، بضع صور تشكل خير مكثف لفترة شبابه.
هكذا نعرف أن موديانو كان يعيش في تلك الفترة داخل غرفة خادمة، ويكتب كلمات أغان بسيطة، من دون أن يدري أن بعضها سيعرف شهرة كبيرة لاحقاً. نعرف أيضاً أنه كان يعاشر أشخاصاً غريبي الأطوار بين حانة تسمى "باستوس" ومطعم باسم "الصندوق السحري"، إلى أن التقى ناشراً، غريب الأطوار بدوره، يدعى موريس جيرودياس، وهو الذي سينشر لأول مرة تحفة نابوكوف الأدبية "لوليتا" (1955)، التي رفضتها قبله جميع دور النشر التي عرضت عليها. ناشر سيطلب من الشاب موديانو تحرير روايات إنجليزية ممنوعة في الدول الأنغلوسكسونية، بإضافة فصول عليها، مما يفتح أمامه أبواب الكتابة الأدبية.
باختصار، يعيد الكاتب في هذه الرواية ابتكار لحن الزمن الذي يعبر من دون أن يتوارى كلياً. وبقيامه بذلك، يتحول الماضي والحاضر تحت أنظارنا إلى معزوفة لا زمنية، يكفي فيها ظل شخص أو ذكرى لإنارة، بصفحات قليلة، موضوعات حميمة بقدر ما هي شاملة، كفعل الكتابة أو هاجس البقاء. وقد تكون هذه الرواية الأقصر في إنتاجه، لكنها تشكل خير ملخص له، إذ نجد فيها كل ما يميز أسلوب أعماله السابقة ومضمونها وفتنتها، من مساءلة الماضي إلى صعود الذكريات على شكل نتف، تارة دقيقة، وطوراً ضبابية، ومن تسلسل الأحداث الذي يبلبله عبور الزمن، إلى الوقائع التي تبدو تافهة عند الوهلة الأولى، قبل أن تتجلى قيمتها الخاصة، وصولاً إلى تلك الكتابة المصفاة إلى حد تتحول فيه إلى عطر أثيري.
يحضر أيضاً ذلك التيه في شوارع باريس الأمس واليوم، ووجوه سبق وظهرت في أعمال سابقة، أو باتت اليوم تركن في رقعة الخلود، مثل عمالقة الرقص الكلاسيكي رودولف نورييف، جان بيار بونفو وموريس بيجار. شخصيات متفرقة تربطها حبكة قادرة، بسحرها وخيطها الخفي، على إثارة اهتمامنا بكل منها، وأيضاً بشخصيات أخرى مجهولة تستمد جاذبيتها من بقائها في دائرة الالتباس.
وكما في جميع روايات موديانو السابقة، لا تحدث أشياء كثيرة في هذه الرواية، التي تقوم فقط على بضع شذرات من ماض بعيد، مما يجعلها أشبه بفسيفساء غير مكتملة. ومع أن صاحبها يتركنا في نهايتها عطشى، راغبين في معرفة مزيد عن تلك الراقصة وعلاقته بها، إلا أننا نسعد لكوننا رافقناهما في نزهاتهما اليومية داخل المدينة. مرافقة على رؤوس الأصابع، خوفاً من قطع خيط الذكريات.