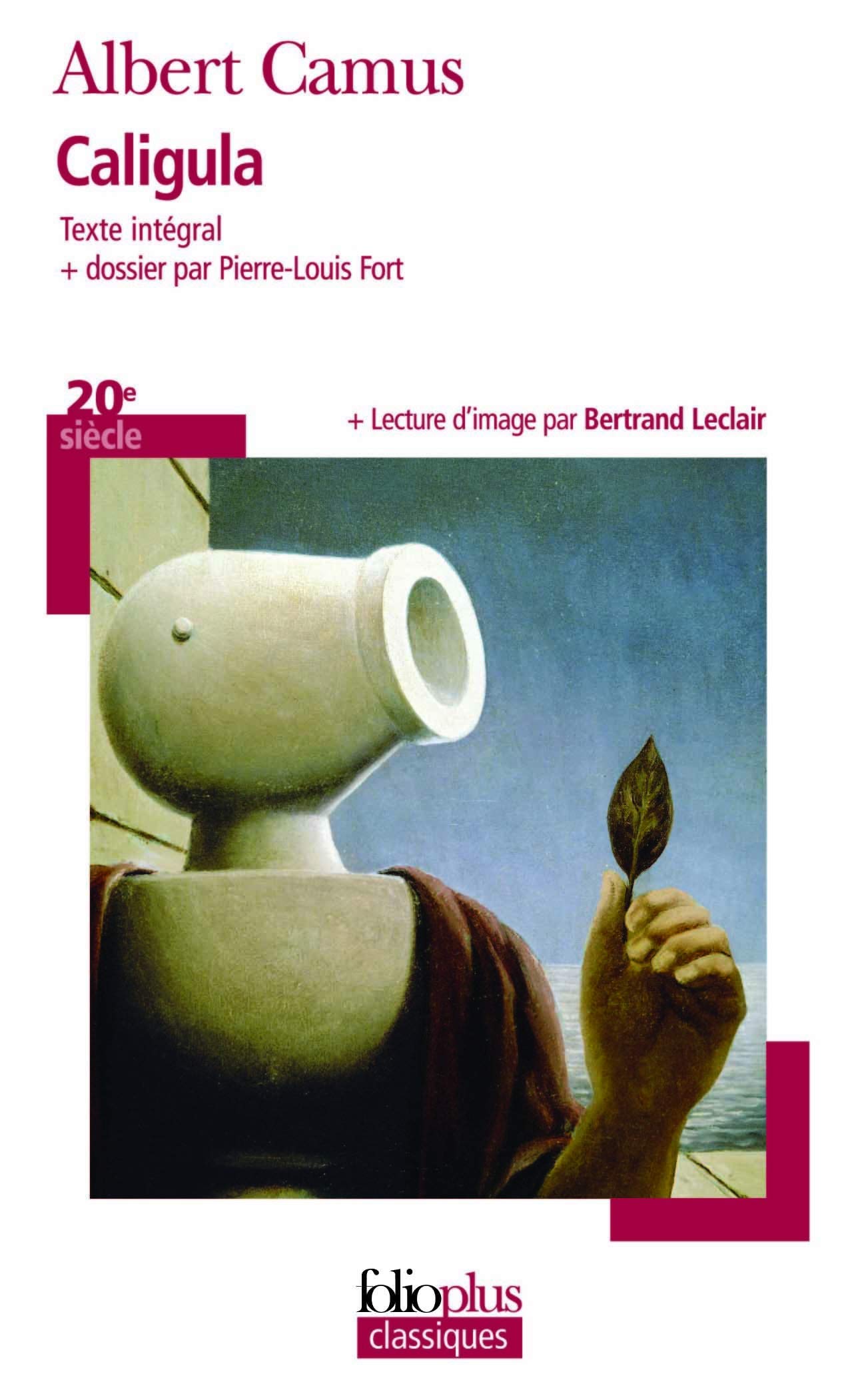يعرف المطّلعون على حياة المخرج المصري الكبير الراحل يوسف شاهين أن المسرح كان دائماً عشقه الأول وحلم حياته، بل إنه حين اتجه أواخر أربعينيات القرن العشرين إلى باسادينا/ كليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية لدراسة الفنون وعاد منها مخرجاً سينمائياً، لم يدرس هناك السينما أو الإخراج السينمائي، بل درس المسرح. قد يكون هذا مفاجئاً لكثر لكنه الحقيقة التي أسرّ شاهين بها أمامنا غير مرة. ويعني هذا أن كبير السينمائيين العرب، والمبدع الذي كان من أكثر السينمائيين العرب ابتكاراً للغة السينمائية، كان هواه مسرحيّاً في المقام الأول. بل لنقل بشكل أكثر وضوحاً: كان هواه شكسبيريا. كان حلمه أن يخرج للخشبة مسرحية "هاملت" بالتحديد فللسينما إن لم يُقيّض له ذلك. ونذكر نحن الذين كنا نعرفه عن قرب أنه في كل مرة ينجز فيها فيلماً من أفلامه ونسأله عن مشروعه التالي كان يجيب بشكل غامض وتساؤليّ: ألا ترون أن الوقت قد حان للوصول إلى هاملت؟ فنسأله: للمسرح أو للسينما؟ فيبتسم ولا يجيب.
لقد رحل شاهين وعينه على اثنين: المسرح وهاملت. وهو لئن كان مرّر شيئاً من هاملت في فيلم له من هنا أو آخر من هناك، فإن المسرح ظلّ عصياً عليه، على الأقل حتى العام 1992 ولكن ليس في أي بلد عربي ولا حتى باللغة العربية، من دون أن يكون لشكسبير أو لهاملت يد في الأمر. والحكاية حكاية فرنسية خالصة على أية حال. ففي تلك الآونة وكان شاهين يجد بعض الصعوبة في إنجاز فيلمه "المهاجر" (1994)، جاء من يقترح عليه في العاصمة الفرنسية أن يُخرج لأحد المسارح الباريسية الكبرى ولحساب "الكوميدي فرانسيز"، مسرحية "كاليغولا" للكاتب ألبير كامو. قبل شاهين العرض على الفور، غير آبه بالصراخ الذي عمّ في الأوساط الثقافية الفرنسية متسائلاً عن جدوى قيام مخرج سينمائي "من العالم الثالث" بالدنوّ من قدس أقداس الفنّ الفرنسي: المسرح؟ بيد أن الصراخ سرعان ما خبا حين ردّ القائمون الفرنسيون على العمل وغالباً بلسان الوزير الاشتراكي جاك لانغ الذي كان من كبار أصدقاء شاهين والثقافة العربية وجرى في عهده كوزير للثقافة دعم عدد كبير من السينمائيين العرب (وهو الآن يتولى رئاسة معهد العالم العربي في باريس): شاهين سيخرج كاليغولا للمسرح الفرنسي تحديداً لأن هناك حرب الخليج ولأن هناك دكتاتوريين كثراً في هذا العالم ولأن شاهين لديه هنا أشياء كثيرة يمكنه قولها.
مسرح عبثي أم فكر وجوديّ؟
ومن المعروف أن مسرحية "كاليغولا" التي كتبها ألبير كامو بدءاً من العام 1938 لينجز نسختها الأولى عام 1938 وتنشر للمرة الأولى بعد ذلك بخمس سنوات معتبرة إلى جانب نصوص أخرى لكامو نفسه، "سوء تفاهم" و"أسطورة سيزيف" و"الغريب"، تعود معاً إلى الحقبة نفسها تقريباً، "حلقة العبث" في كتابات كامو حتى وإن كان ثمة نقاد يعتبرونها كتابات وجودية ما يرفضه كامو على أية حال. وتتألف المسرحية من أربعة فصول اتّبع فيها الكاتب شذرات من سيرة الإمبراطور الروماني الطاغية كايوس تشيزاري الملقب بكاليغولا، كما كتبها المؤرخ سويتون في كتابه "حياة 12 قيصراً".
ولئن كان كامو قد أبدى أمانة في رسم مشاهد معينة ونقاط مفصلية من سيرة كاليغولا، فإنه أعطى نفسه حرية حركة فكرية كبيرة في مجال التفسير بحيث لا تعود المسرحية سرداً موضوعياً لحياة حاكم، بل تحليلاً "وجودياً" عميقاً لمفهوم السلطة نفسه وارتباط حياة الحاكم بذلك المفهوم. أما بالنسبة إلى كاليغولا بالتحديد، فإنه لم يكن بالنسبة إلى كامو، ذلك الشرير المطلق الذي يمكن تصوّره، بل هو كائن يطرح تساؤلاته على نفسه كما على وجوده. إنه بالدرجة الأولى يعيش في مسعى منه للبحث عما يراه مستحيلاً. وهو إذ يثق بأنه كائن خالد لا يمكن للموت أن ينال منه، يفعل كل ما يفعل، بما في ذلك علاقته الحرام مع أخته التي يفقدها في أول المسرحية واستناده إلى عشيقته القديمة جيسونيا التي تساعده في كل الجرائم التي يقترفها بدءاً من قتله الإمبراطور سلفه وتصديه لكل المؤامرات التي تحاك ضده من أقرب الناس إليه، ومن الواضح أنه إنما يفعل كل هذا تأكيداً لقدرته على الخلود. إلى درجة أنه حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في نهاية المطاف، يضحك ساخرا من الموت صارخاً به صرخة المنتصر: أترى كيف أنني نلت منك؟
عن "الكاليغولات" العرب
والحقيقة أن تلك هي الصورة التي تبناها يوسف شاهين بحذافيرها حين نقل تلك الشخصية إلى الخشبة الباريسية متسائلاً عما إذا كان مشاهدو المسرحية سيدركون أنه في نهاية الأمر لا يتحدث عن أي إمبراطور روماني، سواء كان كاليغولا أو غيره، بل عن "ذلك العدد المتزايد من الكاليغولات العرب" الذين "يحكموننا وكل منهم معتقد أنه باق هنا للنهاية" بحسب تعبيره. والحقيقة أن النقد الفرنسي أدرك هذا حين شاهد المسرحية في عرضها الباريسي وعلّق عليها بشكل إيجابي واضعاً حداً لكل تلك التساؤلات التي استنكرت في البداية تسليم نصّ كامو إلى "مخرج من العالم الثالث".
وهكذا إذاً، خاض شاهين تجربته المسرحية الوحيدة في تاريخه الفني الطويل بنجاح فني ولكن سياسي لافت في تلك الأزمنة الانعطافية، وكان يحلو له حين يجري الحديث عن هذا العمل أن يذكّر كم أن ألبير كامو، كان مهتماً شخصياً بالمسرحية وتفسيرها تفسيراً معاصراً هو الذي كتب ذات يوم ملحقاً لها يقول فيه: "أبداً إن كاليغولا لم يمت. إنه موجود هنا وهنا وهناك. موجود داخل كل واحد فينا، نحن الذين إن أعطيت لنا السلطة، إن جرؤنا على ذلك، إن همنا بالحياة، سنراه وقد انفلت من عقاله في داخلنا، ذلك الشيطان أو ذلك الملاك الجاثي في دواخلنا. لقد أفنى زمننا نفسه لفرط ما آمن بأن الأمور يمكنها أن تكون حلوة وتكفّ عن أن تكون عبثية. وداعاً سوف أعود إلى داخل التاريخ الذي حبسني فيه أولئك الذين لطالما أبقوني في داخله كل أولئك الذين يخشون أن يحبّوا أكثر مما ينبغي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تفسير لاحق
هكذا تعامل يوسف شاهين مع مسرحية كامو، ليس انطلاقاً من النص المسرحي في حدّ ذاته في صيغتيه اللتين أنجزهما كامو خلال حياته، ولكن انطلاقاً من هذا النصّ الملحق الذي سيقول لاحقاً أن ميشال بيكولي قد أعطاه إياه كنوع من التفسير "فكان أن اعتمدته في تفسيري لعمل تعودت أن أحبه وأتبناه" ولكن فقط بعد حين من تقديم المسرحية على تلك الخشبة الباريسية التي شهدت ذات شتاء عودة المخرج السينمائي العربي الغاضب دائماً إلى هواه المسرحي الأول، عودة لم يكن لها غد. ومهما كان من أمر شاهين كان لا بأس بالنسبة إليه مبدئيّاً على الأقل، أن يكون كاليغولا بديلاً من هاملت وألبير كامو بديلاً من شكسبير وإن نغّص عليه عيشه أن المسرحية إنما قُدّمت فقط للجمهور الفرنسي لا للجمهور العربي.
أمامنا وعد شاهين نفسه حينها بأن يقدّم العمل في القاهرة وبيروت "حين تسنح الظروف". لكنها لم تسنح وبقي ذلك التقديم إسهامه الوحيد في المسرح. لكنه بقي كذلك إسهامه الضائع. فالحال أن العرض الذي قُدّم ضمن إطار برنامج مسرحي عنوانه "الكاباريه الشرقي" بمبادرة من "الكوميدي فرانسيز" بدءاً من يوم 15 فبراير (شباط) 1992، لم يعد يوجد له أي أثر اليوم. فسيّد السينما لم يقم بتصوير مسرحيته الوحيدة في شريط سينمائي، ولا يعرف أحد اليوم ما إذا كان الفرنسيون أنفسهم قد صوّروا شيئاً. فهل كان هذا التقاعس من شاهين نوعاً من الاحتجاج على عجزه عن تصوير هاملت؟ ربما.