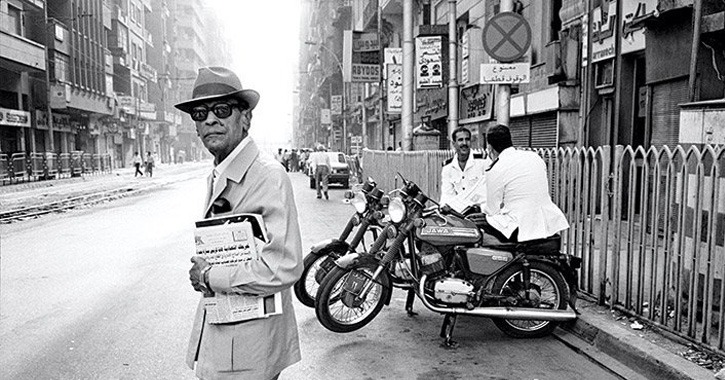كنت أتحدث مرة مع الروائي والقاص المصري الكبير محمد البساطي عن عالمية نجيب محفوظ وإن كان ترك أثراً، بعد فوزه بجائزة نوبل، بروائيين عالميين قرأوا أعماله المترجمة، فقال لي بنبرة جريئة: إذا لم يترك محفوظ فينا نحن أثراً، فكيف سيترك أثراً في الروائيين العالميين؟ مثل هذا الجواب يبدو جريئاً جداً ويعبر ربما، عن "الغصة" التي تركها محفوظ في قلوب الروائيين الجدد وبخاصة المصريين. قد تكون هذه"الغصة" شرعية ومحقة، نظراً إلى احتلال نجيب محفوظ الساحة الروائية وجذبه الاهتمام العام، الثقافي والنقدي، الرسمي والشعبي، واستئثاره بما يسمى "المجد" الروائي. وفي نظر بعضهم أن محفوظ طغى، عن غير قصد، وربما رغماً عنه، على أسماء أخرى مهمة ولامعة، بل كبيرة في حقل الرواية والقصة المصريتين. بعض هؤلاء تمكن من مجاورته روائيا أو تجاوزه أو الاصطدم به والخروج عنه. ولعل هذا الحال يشبه حال محمود درويش الذي هيمن على الشعر الفلسطيني وطغى اسمه على الشعراء الآخرين، وطنيا ونقديا وشعبيا.
في الذكرى الرابعة عشرة لرحيل صاحب "الثلاثية" التي تصادف اليوم، وتحاشيا للكلام الذي يتكرر في مثل هذا اليوم، طرحنا سؤالاً إشكالياً على روائيين عرب، يتعلق بالأثر المحفوظي في الرواية الجديدة التي برزت في مصر والعالم العربي. ومثلما بدا السؤال على شيء من "الاستفزاز" النقدي، بدت الأجوبة مختلفة ومتنوعة، بين اعتراف بهذا الأثر أو نفيه أو تملص منه وتحايل عليه.
حسن داود: صعوبة اقتفاء الأثر
من الصعب الآن اقتفاء أثر نجيب محفوظ في ما يكتب الآن من روايات في البلدان العربية. كان ذلك ممكناً ربما قبل عشرين عاماً أو ثلاثين، حين كان لا يزال متاحاً تصور هيكل عام تنضوي تحته هذا الرواية. كان الروائيون قليلين آنذاك، أما اليوم فنحن بإزاء ذلك الدفق الذي يعجزنا عن تصور كيف يمكن للجان تحكيم الجوائز الكثيرة أن تلم بكل ما يتقدم لها. لقد تفرع صدور الروايات وتشعَّب، أقصد في ما خص عددها واتجاهاتها، وكذلك أماكن صدورها. وهنا أقصد البلدان التي باتت تنشر الأعمال الصادرة فيها لكي يقرأها مواطنوها. والكثير من هذه الأعمال لا يصدر إلى الخارج العربي إلا في ما ندر.
كما لم أعد أعرف إن كانت روايات نجيب محفوظ تقرأ الآن مثلما كان حالنا معها في الستينيات والسبعينيات. الأرجح أننا، لنعرف ذلك، سيكون علينا أن نتحقق من الإقبال على رواياته، بشرائها أولاً، وفي كل بلد عربي على حدة؛ إذ لا ريب أن ذلك الإقبال يختلف بين مصر ولبنان، ومصر والمغرب، ومصر والعراق، وهكذا، الحصيلة التي ستتوفر لنا هي من ثمار تشتت ما كان يمكن أن نسميه المركزية الثقافية (العربية) وانصراف كل بلد إلى الاكتفاء بكتابه.
الدليل على ذلك هو حضور محفوظ المستمر في أعمال النقاد المصريين، وهذا ما انطوت صفحته في البلدان العربية الأخرى. الأرجح أنه سيكون علينا أن نبحث عن جواب للسؤال الذي طرحته صحيفتكم هناك في مصر، ليس حصراً، ولكن أولاً وأساساً.
أحياناً أجدني مُسائلاً نفسي: لو لم أقرأ نجيب محفوظ قبلاً، وفي عمري المبكر، هل كنت سأقرؤه الآن؟ ذلك التساؤل هو طريقة لاختبار إن كان القراء الجدد، وكتاب الرواية الجدد، يفعلون ذلك الآن. في أغلب الظن، وكما يبدو من الحوارات التي تجرى مع بعض هؤلاء الكتاب، ومن كتبهم التي أتيحت لنا قراءتها، أننا بتنا في زمن ثقافي آخر. وأنا غالباً ما أرى أن الانتقال إلى الزمن الآخر، والذي سبقته انتقالات عدة إلى أزمنة ثقافية تتالت، كان يحدث سريعاً وينقضي سريعاً. سبق لي أن سألت طلاباً في الجامعة عن معرفتهم بكتاب وسينمائيين، وشخصيات عامة، سبقوهم إلى الوجود بجيل أو جيلين. كان مفاجئاً جهلهم بهم، وبدا لي أنهم رسموا خطاً يفصلهم تماماً عن كل ما سبقهم.
منذ أن اقتنعنا بأن ثقافتنا تأتي في درجة أدنى بات ما يلهمنا يأتي من الترجمة. وليس ذلك جديداً، فمن عقود كثيرة كنا نتبع تيارات انبثقت من بيئات لم نعش تجاربها: الوجودية، والواقعية، والسريالية، والواقعية السحرية، ثم المدارس المقتصرة على التجارب الأدبية، ثم الأسماء، أسماء الكتاب الذين نتابع أعمالهم بالترجمة غالباً.
الرأي الشائع في بعض الأوساط عن أن نجيب محفوظ كتب عن زمن لم يعد موجوداً، وبأسلوب كتابي تراكم فوقه ما يصعب حصره من أساليب جاءت من بعده، هذا الرأي لا أجده مقنعاً طالما أن بلزاك وستندال ومارسيل بروست وتشارلز ديكنز وجيمس جويس ودوستويفسكي ما زالوا حاضرين في ثقافات العالم. المجلات الأدبية الغربية تُفاجىء المتصفح العربي بأنها تتناول، الآن، وعلى نحو مستمر، أعمالاً لكتاب وشعراء عاشوا من مئتي عام وأكثر، ولن ننسى الاحتفالات بشكسبير التي شملت، من نحو سنتين، العالم بأسره، فيما رحت أحاول أن أقنع ساهرين كنت معهم بأن المتنبي أيضاً شاعر كبير.
أعود إلى الرأي حول قدم عالم نجيب محفوظ متذكراً كاتباً آخرَ عاصره: يوسف إدريس الذي، في ما خصَّ الأقيسة الزمنية، كان مستقبلياً إلى حد أننا نُدهَش من سبقه لأجيال من الكتاب أتت بعده. لكن، يوسف إدريس، هو أيضاً، بات قليلاً، بل نادراً، ما يقرأ.
طارق إمام: البحث عمّا بعد الثلاثية
في ظني، إن التجديد المحفوظي يملك نصيباً في ما يمكن أن نطلق عليه الكتابة الجديدة، على الأقل بالنسبة لي كروائي يكتب الآن. أتحدث هنا انطلاقاً من النصوص المحفوظية "التجريبية"، وهي قائمة في عديد مراحله وتحولاته، بل إنها وسمت آخر ما كتب، بكتابين خارج التصنيف التقليدي، شهدا خلخلةً عميقة للنوع، أحدهما "أصداء السيرة الذاتية"، والآخر "أحلام فترة النقاهة". تجافي "أصداء السيرة الذاتية" النوع الذي وضعت نفسها في إطاره، كشكل غير تخييلي، ناهضةً بنص تخييلي، يراوح بين السيرة والرواية، عبر ابتكار شخصبة "الشيخ عبد ربه التائه"، وهي بالتأكيد صوت تخييلي، يحاور صوت المؤلف/ السارد الذي يفترض أنه يمثل محفوظ نفسه، وببنية تتخذ من الشذرة والومضة خليةً تكرارية. هناك أيضاً "أحلام فترة النقاهة"، العمل الذي يصعب تصنيفه، والذي كتبه محفوظ في ظني وهو يدرك أبعاد اللحظة الإبداعية "الراهنة" في حينها، أقصد حقبة التسعينيات، بما شهدته من صعود لقصيدة النثر من جهة، والقصة الشعرية من جهة أخرى، صعود جاء كاستجابة للدعوات بخلخلة ثبوتية الأنواع المرعية لصالح خطابات أدبية قوامها التهجين، والتململ من وصفات النوع. أحلام فترة النقاهة جاءت اقتراحاً محفوظياً للشكل الفني المراوح، ولأنها "أحلام" فقد أجاد محفوظ استثمارها لتقديم وجهه السوريالي، الأوتوماتي، الذاهب للتجريد. ولنلحظ أن هذين الكتابين الأخيرين هيمن عليهما بالكامل ضمير المتكلم، الذاتي ونسبي المعرفة، في تململ آخر من هيمنة الراوي العليم على مقدرات النص المحفوظي.
أُدهَش ممن يقصرون محفوظ على النص البلزاكي، الذي لم يعد إليه أبداً بعد الثلاثية. وأعتقد، بعيداً عن سلطة الاسم، أن التجربة المحفوظية لا تزال تتوفر على أسباب جدتها، عبر نصوص طليعية، بعضها لم تجرؤ نصوص أحدث على خوض عراكها سواء الموضوعي أو البنيوي. رواية مثل "حديث الصباح والمساء" هي في تقديري رواية طليعية على غير مثال في السردية العربية، ببنيتها الجريئة والغريبة، وطريقتها غير المسبوقة في تقديم كل شخوصها كـ"بروفايلات" وصفية، قصيرة وملخصة، يبدو كل منها على حدة خالياً من الفنية وأقرب للتقرير المختزل، لكنها في سياقها الأشمل تمثل عملاً فريداً فيما يمكن أن نسميه رواية الأجيال على مستوى الأدب العالمي. "ليالي ألف ليلة" عمل آخر شديد التجريب والطليعية. ومن الأعمال المبكرة التي انتبهت مبكراً للتناص الحداثي مع النص التراثي، دون أن يُحاكيه، بل يُعيد تركيبه، وأيضاً عبر بنية مراوحة. وفي عمل مثل "أفراح القبة" ثمة التفات عميق لفكرة النص داخل النص، فنحن أمام رواية بطلها الحقيقي نص مسرحي مضمن، أي إننا أمام نص ميتا روائي يشهد ميتا لغة، تحاور فيه التقنيات بعضها وتعري نفسها.
للأسف، ينصب الاهتمام بمحفوظ عادةً على نصوص كـ"الثلاثية"، و"الحرافيش"، و"أولاد حارتنا"، رغم أن النص الأخير هو نص تجريبي جريء أيضاً، والنموذج الأليجوري مقدم فيه بجرأة فنية، لكن تم إجهاض هذه الجدة لحساب إشكاليات دينية تخص مساسه بالذات الإلهية. إجمالاً، فإن الاهتمام بالأعمال الأكثر شهرة و"ربحية نقدية وأكاديمية" إن جاز لي التعبير، جعل محفوظ الكلاسيكي نموذجاً مهيمناً، واختزله في وجه وحيد على حساب وجوه عديدة من الاجتراء. وربما ينبغي هنا أن أذكر سريعاً أن محفوظ القاص يملك العديد من النصوص التجريبية والمغامرة، التي توارت، ربما بفعل الوهج المبهر لنظيرتها الروائية، أو لإصرار النقد على "اللعب في المضمون".
خليل صويلح: في موقع مضاد
كان الاشتباك الأول مع اسم نجيب محفوظ، عن طريق روايته الأولى "عبث الاقدار"، وجدتها بالمصادفة فوق طاولة من القصب تستعملها أمي لتجفيف الخضراوات أمام باحة البيت. لا أعلم كيف وصل الكتاب إلى بيت طيني عند تخوم الصحراء. على الأرجح كان سيتعرض للتلف لو لم التقطه في تلك اللحظة، قبل أن تستعمله أمي في إشعال موقد النار. لم تستهوني الرواية، فقد اكتفيت ببضع صفحات منها لا أكثر، فبالنسبة لسني حينذاك، وجدت صعوبة في إتمام الرواية. لاحقاً، سأغامر بشراء رواية بعنوان "القاهرة 30"، وجدتها في واجهة مكتبة الحرية في مدينة الحسكة. كانت هذه الرواية أكثر متعة بمراحل من "عبث الأقدار"، أو "خان الخليلي" التي قرأتها أثناء عطلة الصيف. أما القراءة الواعية فكانت مع "أولاد حارتنا" بطبعتها البيروتية، بعد منعها في مصر. رواية ملحمية ثقيلة، لا تقل شغفاً عن "الثلاثية"، فيما ستعبر رواياته الأخرى بانقطاعات تخضع للمصادفة. شخصياً لا أعتبر نفسي حفيداً أصيلاً لنجيب محفوظ، وسأجازف أكثر بالقول إنني أكتب من موقع مضاد. لقد علمنا هذا الروائي الرائد كيف نبني حكاية متينة، وفي الظل قادنا إلى هدم الحكاية بالاشتغال على التشظي والخروج من الحارة إلى فضاء آخر أكثر تعقيداً، وبلغة أكثر شراسة من لغته المتقشفة جمالياً، وبمعنى آخر، ضرورة قراءة تجربته، ومن ثم نسيانها بوصفها مخزوناً حكائياً لا خطاباً سردياً خالصاً، ذلك أن المسافة باتت شاسعة بين قارئ الأمس، وروائي اليوم، نظراً لتعدد المقترحات السردية في الكتابة، سواء في مجابهة الحشمة، أو صوغ المتن الحكائي. في مشغل نجيب محفوظ تحضرني أطياف شخصيات، لا روايةً كاملة، رغم تقديس الآخرين له كأيقونة غير قابلة للمحاكمة. كنت أرغب أن أقرأ سيرته الذاتية، لا "أصداء السيرة الذاتية"، هذه الأصداء التي تخفي أكثر مما تعلن، باتكائه على نبرة صوفية لا حسية، وعلى الصدى لا الصوت بنوع من التقية، فروائي بمقام نجيب محفوظ كان ينبغي أن يكون أكثر جسارة في إماطة اللثام عن سيرته المضمرة، لكنه، في المقابل سيزعزع متأخراً أسلوبيته الروائية بكتابه "أحلام فترة النقاهة"، سواء لجهة سريالية الأحلام التي دونها، أم لجهة النبرة التجريبية في تشكيل قماشة المنام. في كل الأحوال، ستبدو العمارة الروائية العربية مائلة، من دون الملاط الحكائي الذي رسخه نجيب محفوظ بدأب واضح، كما كان برزخاً ضرورياً نحو الضفة الأخرى للكتابة السردية العربية، فقد كان حضوره مهماً، والنأي عنه، بالنسبة للأصوات الروائية الجديدة بالأهمية نفسها. سأستعيد بما يشبه الحلم مشهد "عبث الأقدار" في صباي، وأنا أصعد إلى منصة التتويج بجائزته المرموقة التي تمنحها الجامعة الأميركية في القاهرة سنوياً لأحد الروائيين العرب، وسأقول في ختام شهادتي "لقد قادني نجيب محفوظ إلى التهلكة"، ذلك أن الكتابة ضرب من التهلكة، حين يرتبط اسم صاحبها باسم أب روحي من هذا المقام.
أحمد المديني: جديد دائما لأنه كلاسيكي
كم عدد من يستحق أن نطلق عليه لقب روائي في الأدب العربي، بمعنى الرائد، وصاحب المشروع، والمثابر المنتظم في خط تأليف تصاعدي؟ بدءاً من الفهم الأولي للرواية بوصفها محاكاةً للواقع وتجسيداً لعوالمه بما يشخص حيوات الناس وأزماتهم ومصائرهم في المدينة الحديثة. وانتقالاً إلى ابتكار حياة معادلة ومحتملة مزاوجة بين الواقع في ذاته وطموح الكائن ضمن فئة اجتماعية لتجاوز وضعه الطبقي، والشخصي المحض، والربح الإنساني، أحياناً، في ظروف محكومة بالقهر والانسداد وجمود التقاليد وهيمنة قيم ومعتقدات عقيمة ومضادة. ثم عبوراً بموجة تحولات المجتمع (العربي، دائماً) بين صراع القوى الوطنية من أجل الحرية ونزوعها نحو طموح التحرر عند قوى جذرية بديلة، وتحقيق الأحلام وانكسارها على صخور القوى المضادة والقيم المناوئة وتحديات القوى الأجنبية، بصفاتها السياسية الأيديولوجية والعقيدية والخلقية، وتدافع الأفراد والجماعات وسطها، وخصوصاً البحث عن وضع لفرد يريد أن يجد له مصيراً ممكناً في خضمها. وهو المصير الذي تحمله الأسئلة الكبرى الوجودية التي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة لنجيب محفوظ بوصفه الروائي العربي المؤسس للرواية العربية بحق، رائدها، العابر للأجيال، ومختلف المدارس الواقعية للرواية، وضعاً وتطويراً وتحديثاً. بإيجاز من نقل العرب من شفوية الحكاية إلى فن السرد بجمالية؟
كل دارس وقارئ حصيف للرواية العربية، ومؤرخ لمراحل كتابتها في جميع مراتبها ونظمها، يحتاج إلى الانطلاق من نجيب محفوظ، ويستحيل أن يقفز على ظله، وفي جهد التحديث خاصة، أو سيُجافي الحقيقة، الحقيقة النقدية المستنبتة من سرد تخييلي دأب صاحبه منذ أربعينيات القرن الماضي، وإلى أعوامه الأدبية الأخيرة في خواتيم القرن، على ربطه وتشكيله بالبنيات المؤسسة للمجتمع الناطقة بأصواته، والبؤر التي تتمحور وتنبثق منها رؤاه بتعبيرها الرئيس وتجلياتها المتباينة.وواكب هذا متابعة حثيثة، بالوعي، أولاً، وصنع المعمار البنائي الموازي لبانوراما الحياة وهيكل الواقع الكبير، إذ تستقل ضمنه التركيبات الصغرى المتعالقة مع البنيات الكبرى، وبالنمذجة الروائية شخصيات نمطية ومتفردة وهامشية، مثلث يسمح باستيعاب الماضي والحاضر والمستقبل، من منظور واقعي صرف. حتماً، فهكذا جنس الرواية، وليس تهويمات في الفراغ وسديم المناجاة، إنما هذه الواقعية تبدأ من الكل إلى الجزء، ومن المادي الصلد لترقى فوق مدارج الروح بحثاً عن وجود مفرد ويقين مفتقد غير مبتذل.
كما الواقع، المصدر الأم لفن التخيُّل، لا يجمد، والتاريخ كوعي كلي عميق وجدلي، لا ظاهراتي فقط، في صيرورة، فإن الرواية متن لغوي بلاغي أليغوري، وبأدوات ومقتضيات السرد تحديداً، أساساً، إعادة تشكيل وبناء وتصوير وتفكيك وتركيب للعوالم والمجتمعات والذوات، بمنطق وإيقاع الزمن المتبدل واستشراف آخر قادم، بين الأمل واليأس عمادهما في الكتابة التحول والتحويل؛ هو فهم وتطبيق ذكي ومتخلل عند نجيب محفوظ وسم نصوصه دائماً بالجدة، تاركاً بينه وبين أعماله الواقعية، البانية الأولى، الثلاثية، خاصة، مسافة واضحة للحس النقدي وفي تربتها البكر زرعت بذور تحديث الرواية العربية وأينعت في أعمال جيل تعلم من صاحب الثلاثية، واجتهد ويواصل في صيغ تجديد من طبيعة زمانه وفهمه للرواية. نقول إن هذا الفهم لم يتوقف عند محفوظ في حدود، فهو تواصل بالاستغراق في مزيد من أسئلة لا يجيب عنها الواقع لجفافه، أو تصطدم بالقمع والاستبداد، وكان الحلم وحده لها بديلاً. هذا كان دائماً التعويض والرهان الأخير ربما في مسيرة محفوظ السردية، كما حفلت بها قصصة وسيرته ونصوصه الحرة الطليقة. هي الرؤية الحلمية نهج وخلاصة تجربته الأخيرة باعتبار أن الروائية المحفوظية سلسلة من التجاب، يمكن اعتبار التجريب واحداً من أولياتها وتمظهراتها لا صرعة كما يفهم تجريب الصرعة والنزق. في أجواء وسراديب هذه الرؤية انضوت أغلب الروايات ذات الطموح التجديدي لما بعد المحفوظية، بمراحلها كافة، وما فتئت المقاربات تغتني حسب تبدل الأحوال والرؤى الكامنة في الواقع قاعدة التخييل.
لقد أثمر نجيب محفوظ كل شيء تقريباً في الرواية العربية، بين أطوار التأسيس والتشييد والتجديد، وسرده المنبع الأول لهذا الأخير؛ صنع التحول، وتلاعب بالزمن بتكسير الخطية، واستثمر تيار الوعي، وفكك المتماسك الظاهر، وقلب مفهوم البطل وتراتبية البطولة، وذوت النظرة إلى الحياة والعلاقة بالمجتمع، ونسب معنى الحقيقة وخلخل براديغم اليقين، جاعلاً لكل حقيقته، ببولويفونية مبكرة وباستخدام ناضج للمونولوغ الداخلي، جاءا باهرين في" ثرثرة فوق النيل" (1971) كاسراً بهذا فكرة التماهي بالواقع، ومهشماً المرآة الستاندالية التي طاف بها طويلاً في حارات القاهرة، منتقلاً من الرصد الأفقي إلى الاستبطان والتصوير العموديين. وبذلك زحزح الهندسية الجغرافية في الرواية العربية نحو صنع تفضية للإحساس والزمن. نقف عند هذه الخصائص، لم تمتد إلى طرائق الحبك والسبك والسرد والوصف والسجلات اللغوية والأسلوبية، هذه وغيرها طبقة متينة راسخة في مدون الرواية العربية.
والسؤال الأهم في نظرنا بعد هذا، هو ماذا أضاف ما يسمى الجيل الجديد، أو الأجيال؟ لأن مفهوم التجاوز غبي وينم عن جهل وتنطع. أعلن ألان روب غريي مرات أن أستاذه الأول في الرواية هو فلوبير، منه تعلم صناعة الكلمات ووصف الأشياء، وكذلك أندريه جيد، أي إنه ينتمي إلى سلالة وتسلسل، لذلك فإن مفهوم (الجديد) الذي وسم تياره ورفقته مرتبط بسابق فيه قطيعة مع واقعية ما (بلزاك) ضمن استمرارية، أي كل السرد الكلاسيكي العظيم، وهو محك كل جديد سيصبح قديماً ورهانه الخطير أن يصبح كلاسيكياً. نجيب محفوظ جديد دائماً لأنه كلاسيكي فمن يطوله، من يطول جيمس جويس وبروست وكافكا، خاصة؟
بقي أن يفهم كتاب الرواية العرب (الجُدد) أن عليهم أن يتحولوا إلى روائيين كاملين، ولا يكفي الكم في هذا، ولا تصفيق الجمهور، بل المشروع. ثانياً، هذا المشروع ليس سوبر ماركت يذهب إليه كاتب ما سوي الموهبة أو بعكازات، ليقتني منه ما يطيب له من موضوعات، ثم يعالجها فيمطط الحكايات بالتدوينات التاريخية منسوجة بغثاثة المناجاة وتباريح الآهات وتراسل الغراميات، وحتى بحطام البلدان وتشرد الشعوب؛ إنه عمل آخر تماماً، شاق وطويل سلمه، هو "سباق المسافات الطويلة" بعنوان عبد الرحمن منيف الذي مثلت روائيته مشروعاً كاملاً. بعد ذلك سيأتي الحديث عن تجديد المحدثين ودلالته قياساً بالقدامى أو هؤلاء في علاقة بالخلف، وحده، سيأتي بدايةً تدويناً تأريخياً، ثم تأملاً نقدياً، ثم درساً لنظرية أدبية، باختصار، بأنساق، وهذا لا يتأتى إلا إذا كملت النصوص، ويذهب الجديد إلى ماضيه السرمدي؛ عندها وحين يصبح الجدد كلاسيكيين، فقط!
نبيل سليمان: علاقات ملتبسة
يهمني أن يبدأ حديث الرواية العربية الجديدة من فضّ التباسه بالرواية الشبابية ومفرداتها. وبما أن الحديث يأتي في ذكر نجيب محفوظ، فسأذكر أن محاولةً ما كانت منذ خمسينيات القرن الماضي لكتابة رواية مختلفة عن الرواية المحفوظية كما عبرت عنها "الثلاثية" بخاصة. ومن تلك المحاولة المتواضعة والموسومة بالجديد، رواية "جيل القدر" لمطاع صفدي، و"أنا أحيا" لليلى بعلبكي، و"العنقاء" للويس عوض، و"صراخ في ليل طويل" لجبرا إبراهيم جبرا، عدا عن روايات إحسان عبد القدوس.
غير أن هذه المحاولة المتواضعة سرعان ما غدت تياراً في الستينيات، مختلفاً فيما يقدم من رواية جديدة عما أخذ نجيب محفوظ يقدمه أيضاً من رواية جديدة. ومن العلامات الناصعة لذلك التيار الذي تصلَّب واغتنى في العقد التالي روايات صنع الله إبراهيم وعبد الحكيم قاسم وإدوار الخراط وهاني الراهب وإبراهيم أصلان والطيب صالح ووليد إخلاصي وجمال الغيطاني و... على يد أولاء استوى الحديث عن رواية عربية جديدة. ومن عقد إلى عقد سيتجدد هذا الحديث وهو ينأى عن المحفوظية، حيث يؤثر المخلصون لها القول بالتجاور، بينما يؤثر آخرون القول بالتجاوز.
دعونا نقلب السؤال عن أثر محفوظي ما في روايات الأسماء التي ذكرتها للتو، ثم نتابع البحث عن هذا الأثر في روايات إميل حبيبي أو غادة السمان أو عزت القمحاوي أو إبراهيم الفرغلي أو سميحة خريس أو ممدوح عزام أو حبيب عبد الرب سروري أو رشيد الضعيف أو علوية صبح أو واسيني الأعرج أو رجاء عالم أو الياس خوري أو عشرات غيرهم وغيرهن.
ثمة من سيُجلجل مبتهجاً وعجلان بنفي الأثر المحفوظي، لكنني أعتقد أن للنزوع التجريبي الذي يشكل علامة فارقة للرواية العربية الجديدة، أساساً مكيناً في التجربة المحفوظية، وحده أو مع التجريب في مظان شتى من الرواية العالمية.
كذلك هي البوليفونية وتعدد الأصوات، من النعمى التي نفحتنا بها رواية "ميرامار". وأنا شخصياً، ما كان للبوليفونية في روايتي "ثلج الصيف – 1973" أن تكون، لولا "ميرامار"، وكذلك ما حدثني به سليمان فياض عن روايته "أصوات". وليس للمرء أن يفوته ما توسل به نجيب محفوظ من تقنيات العبث في "خمارة القط الأسود" أو "حكاية بلا بداية ولا نهاية" أو "تحت المظلة"، مما كان له أثره الروائي، والمسرحي أيضاً.
تتحكم عقدة قتل الأب أو الجد في حالة نجيب محفوظ، في رهط من الروائيات والروائيين فيشطبن ويشطبون على الرجل الذي رهن عمره للرواية، وليت الأجيال تتوارث هذه الأمثولة. ولا يختلف من يشطبن ومن يشطبون عمن لا يرون لمحفوظ نظيراً. ولهؤلاء وأولئك أردد: لأنني أُجِلُّه، لا أصنِّمه.
طالب الرفاعي: المحلية المنفتحة رمزياً
ترك نجيب محفوظ إرثاً روائياً وقصصياً متنوعاً وكبيراً متداخلاً مع عوالم الرواية العربية الجديدة. ولذا فإن كل كاتب عربي شاب يسير على درب قراءة وكتابة الرواية العربية، لا يمكنه ألا أن يمر بذلك الإرث وتلك الكتابات ويقف عندها. وإلا فكيف يمكن أن يتدرج أي روائي عربي في حضوره الإبداعي والثقافي، دون أن يمر بأعمال صاحب نوبل العربية اليتيمة!
إن واحدة من أهم خصائص كتابات محفوظ، هي قدرته الساحرة على استحضار المكان في أعماله الروائية تحديداً. حتى إنه أطلق على أكثر من رواية اسماً لحي من أحياء القاهرة. مع ملاحظة أن عبارة "الرواية العربية الجديدة" تبدو جد مُلتبسة، فهل يقصد بها الرواية الجديدة حسب كتابات النقاد الأجانب، وتحديداً الفرنسيين؟ أو قصد بها، الرواية العربية الشبابية، لأجيال عمرت بناء الرواية العربية بكل ماهو جديد، خاصة في العقدين الأخيرين؟ أما أن السؤال، قصد إلى رواية جديدة متخلصة من إرث الرواية الكلاسيكية، بسطوة وحضور الراوي العليم.
إن ما يجب الوقوف عنده، هو أن نجيب محفوظ نذر عمره لكتابات في القصة والرواية، ومؤكداً في الرواية أكثر مما في القصة، وأن الدارس لأدب محفوظ يجد بوضوح خاصيتين تطبعان أدب محفوظ: الأولى، ارتباط أدبه بشكل كبير بواقع المجتمع المصري، مما يجعل من أعماله سجلاً توثيقياً لقضايا مصر، بينما الخاصية الثانية تتمحور حول البُعد الرمزي في مجموعة من أعماله. وهذا يقول إن محفوظ انغمس في محليته، وأغنى هذه المحلية بكتابات منفتحة على رمزية كبيرة.
إن الحديث عن اتصال أعمال نجيب محفوظ بالرواية الجديدة، ومدى تأثر جيل من الكتاب الشباب العربي بأدبه، إنما يقودنا إلى عوالم الكتابة الروائية العربية الجديدة، والتي تحمل من الغث أضعاف ما تحمل من السمين، وهذا الكلام ينسحب على عموم أقطار العالم العربي. حتى إن أعمالاً لا تمت بصلة لجنس الرواية صارت تطبع وتوزع على أنها رواية! مع وجود أعمال قليلة لافتة، وهذا القليل يستحق أن يحتضن بوصفه يشير لما هو قادم ومؤمل، مثلما يجب على الكاتب العربي الشاب الاهتمام ودرس أعمال عربية كثيرة تكاد تكون علامات عالية، إبداعياً وإنسانياً، وإنه من المؤلم أن تقابل كاتباً شاباً عربياً يتنكر لكتاب وكاتبات يشكلون الذاكرة الأهم والأجمل للرواية العربية.
صلة نجيب محفوظ الأهم بالرواية، سواء كانت كانت كلاسيكية أم حديثة، هي قدرته الساحرة على رسم شخصيات إنسانية، من مختلف أطياف المجتمع، وقدرة هذه الشخصيات على أن تنتفض ناهضة متى ما مسها نثار مياه القراءة الجادة والعميقة.
سهير المصادفة: كان يحلق وحده
أظن أن نجيب محفوظ أثر تأثيراً كبيراً في جيلنا. كنا نحن الجيل الذي بدأ الكتابة والنشر في تسعينيات القرن العشرين، لم نتعرف إلى أعماله في سن صغيرة. فأنا مثلاً انهمكتُ لفترة في قراءة الأدب الأجنبي المترجم، أو بالأحرى الممصر آنذاك بلغة بسيطة، وطوال المرحلة الإعدادية قرأت روايات أغاثا كريستي وإحسان عبد القدوس. وبمجرد وصولنا إلى الثانوية، وكما عربة طائشة وجدت طريقاً معبداً، انهمكنا في السياسة ومناقشة أحوال بلدنا ومصائرها المختلفة، وكان نجيب محفوظ يحلق منذ بداياته وحده، خارج الأيديولوجيات والانتماءات السياسية والأحزاب، كان بعيداً مثل نجم بعيد لا يستطيع أحد الاقتراب منه؛ فاليسار الذي انتمينا إليه كان يفضل يوسف إدريس، ولذلك اكتفينا برؤية أعمال نجيب محفوظ على الشاشة المصرية، وقد أنجز معظمها سينمائياً، وهنا أظن أن السينما ظلمته كثيراً؛ فأخَّرت قراءة أعماله، رغم أنها قدمت جماهيريته وشهرته الواسعة.
عندما هدأت دماؤنا الفائرة بالسياسة والثورة والتغيير، جلسنا لنقرأ باهتمام أعمال نجيب محفوظ الكُبرى. كانت دور النشر العربية قد بدأت مشاريعها الجادَّة لترجمة الأدب الأجنبي ترجمة جيدة، فتعرفنا إلى دوستويفسكي، وماركيز، وكافكا، وكازنتزاكس، وآخرين، واكتشفنا في الوقت نفسه أن نجيب محفوظ هو الأقرب للأدب العالمي، وأن الرواية ليست مجرد حكاية، ولا فكرة، ولا حتى عريضة دفاع عن نظرية ما، ولا مجموعة شخوص متناحرة لتسليتنا، وإنما الرواية هي كتاب الحياة ومدونة كل أحلام الشعوب وانكسارتها وتوقها الدائم إلى تحسين شروط مأزقها الوجودي. تجوَّلنا في أماكن أحداث رواياته، فزرنا حواري مصر القديمة وخان الخليلي والأزهر والحسين، وتأملنا من جديد "السكرية"، و"قصر الشوق"، ورأيت بنفسي الحرافيش البسطاء وهم يتحدثون عنه في مقهى الفيشاوي، ويتساءلون مَن مِن آبائهم يشبه سي "السيد عبد الجواد"، ومن من أمهاتهم تشبه "أمينة" في ثلاثيته الشهيرة.
أظن أن تأثير نجيب محفوظ على رواياتي هو الأكبر؛ فأدبه كان منحازاً للمحكوم طوال صراعه مع الحاكم، وللمظلوم في وجه الظالم، وللإنسان في كل مكان دون شوفينية تحد البصر والبصيرة، كان منحازاً للمُستعمَر ضد المُستعمِر، ولأحلام وطموحات الإنسان العربي دون أيديولوجية حنجورية محددة، قاصرة بالضرورة على رؤية العالم بأطيافه المختلفة، أو على طرح أسئلة الوجود الكبرى باستخدام الرمز والفلسفة وعلم النفس ومحاورة التاريخ وجغرافيته عبر العصور المختلفة، بأسلوب سهل ممتنع عصي على التقليد. علمني الجرأة في فتح آفاق جديدة عندما قرأت له "أولاد حارتنا"، وعلمني ألا أكف عن التجريب؛ فلقد كان أيضاً مجرباً عظيماً ومات وهو يجرب طرائق جديدة في السرد، فكتب "أحلام فترة النقاهة"، و"أصداء السيرة الذاتية". وطوال مساري الأدبي أرى مثله أن الروائي يجب أن يظل إلى جانب الحرافيش البسطاء، ملح الأرض، الذين يسعون إلى لقمة العيش والعدل والجمال والخير والحرية والسلام.
إبراهيم فرغلي: تجاوزه وجه من التأثر به
بالتأكيد ترك نجيب محفوظ أثراً كبيراً في الرواية العربية الجديدة وفي توجهات الروائيين الجدد. هذا الأثر يمتد بطبيعة الحال إلى أجيال سابقة، وخصوصاً جيل الستينيات الذي قدم تجارب سردية حاول بها أن يرسخ بناء محفوظ وتأسيسه للرواية الواقعية بنماذج جديدة من الأشكال السردية التي حاولت توسيع رقعة الشكل السردي إلى نماذج للواقعية الجديدة؛ سواء لدى ابراهيم أصلان أو جمال الغيطاني وبهاء طاهر وصنع الله إبراهيم.
ولا أظن أن الأجيال الأحدث أفلتت من هذا التأثير، لكني أعتقد أن التأثير لا يعني بالضرورة أن النصوص التي تأثرت بمحفوظ قدمت تجارب شبيهة لما قدمه، بل العكس، بمعنى أن كتاباً كُثُراً كانوا حريصين (حرصاً عنيداً أحياناً) على أن تتخلص نصوصهم من أثر نجيب محفوظ، فقدموا محاولات لمعارضة رواية محفوظ، إما بالتحول إلى عوالم المهمشين في أحياء عشوائية نشأت على تخوم القاهرة في العقود الأخيرة (وهي محاولات للبحث عن بدائل للحارة المصرية القديمة ومجتمع الطبقة الوسطى في مصر التي قدمها محفوظ كاشفاً عن قدرة كبيرة على فهم تناقضات الشخصية المصرية)، أو بتبني الفانتازيا والواقعية السحرية (يشترك مع جيل التسعينيات في ذلك أكثر من تجربة للمحمد البساطي، خصوصاً في "صخب البحيرة")، أو الأجواء الكابوسية الكافكاوية، أو حتى اقتراح كتابة تعتمد على التكثيف والمشهدية والشذرات السردية والأحلام مثل كتابات مصطفى ذكري التي تبدو منتمية أكثر لكتابة بورخس مثلاً، أو بتجربة نصوص ملحمية لرواية الأجيال في بعض النصوص... أي إن تأثير محفوظ لم يقتصر على محاولات كتابة رواية شبيهة بل كانت معارضته ومحاولة الحوار مع نصه أو حتى تجاوزه في تقديري هي في حد ذاتها انعكاس لنوع من الأثر العميق لمحفوظ على الكتابة، خصوصاً أنه ظل يطور أدواته وتجاربه، على مر السنوات، وتجاوز هو نفسه الرواية الواقعية التي بدأ بها مسيرته إلى تجارب رواية الأصوات كما في "ميرامار" مثلاً وغيرها، والرواية الجديدة المبنية على صوت الراوي بضمير المتكلم كما في "السراب"، والعودة لتراث "ألف ليلة" في "ليالي ألف ليلة"، والرمزية الأسطورية في "الحرافيش"، والتجريب بالمزج بين الفانتازيا والواقع كما في "ثرثرة فوق النيل"، وفي تجارب أخرى اتخذت سمتاً مختلفاً، مثل "قلب الليل" وغيرها، ووصولاً لمرحلة تجريدية وسمت "أصداء السيرة" و"أحلام فترة النقاهة". وطبعاً لا بد من الإشارة إلى أنني من المتأثرين بمحفوظ، ولكني حاورت نصوصه من خلال تجربة روائية ما بعد حداثية في "أبناء الجبلاوي".
هناك في تقديري أيضاً أثر آخر تمثل في محاولات استعادة النص المحفوظي الواقعي بتقليده، أو بالأحرى بالنقل عنه، كما هو، ويلاحظ أن بعض تلك التجارب التي نقلت عن النص المحفوظي الواقعي، من حيث البناء أو العوالم، أو إعادة إنتاجها، حظيت بالانتشار والرواج اللذين وضعاها في قوائم الأكثر مبيعاً مثل "عمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني، أو رواية "1919" لأحمد مراد، وإن بدت الأخيرة نقلاً مشوهاً لأنه أراد أن يمنح كتابته سمتاً شخصياً من خلال استخدام العامية وتعمد إظهار فجاجة بعض الشخصيات، والنقل المشهدي أحياناً الذي يوحي بالنقل من أفلام الأبيض والأسود القديمة. لكن البناء بالكامل كان منسوخا من الرواية المحفوظية التقليدية رغم بناء النص على سقالة التاريخ. وسبب مسخ هذا النوع من التقليد أنه شكلاني، لا يكاد يُدرك الطابع الصوفي والرمزي والفلسفي العميق لنص محفوظ الذي يحمل على الشخصية الواقعية رمزية وأفكاراً هي التي جعلت قراءته اليوم من الجيل الجديد أمراً مؤكداً لمدى عمق تلك التجربة. لكنَّ ثمة تأثيراً مُدهشاً لمحفوظ في تقديري تمثل في إنتاج مسلسل "أفراح القبة" من خلال تحويل الرواية التي تحمل العنوان نفسه لعمل درامي شارك في كتابة السيناريو الخاص به كل من محمد أمين راضي ونشوى زايد، حيث شاهدنا نصاً يعيد اكتشاف وتأمل محفوظ بشكل معاصر وتحويل الخامة السردية لعالم الرواية المبني على قصة بطلها الرئيس عرض أو نص مسرحي يتمرد عليه الممثلون، إلى مادة درامية مختلفة ومعاصرة، حرضت على إعادة تأمل هذا النص الروائي بشكل مختلف، وهذا واحد من التأثيرات المهمة جداً لنجيب محفوظ في الجيل الجديد من الكتاب عموماً، وكتاب الدراما على نحو خاص. ولهذا أعتقد أن التأثير الحقيقي والعميق لمحفوظ ليس في النقل عنه بشكل حرفي، بل يتجلى في البناء المُوازي أو البناء المضاد الذي يشكل في التحليل الأخير للمشهد السردي أبنية موازية للمبنى المحفوظي المتنوع في مواد بنائه والعميق في أثره ودلالاته.
نعيم صبري: أثر موجود حتى في اللاوعي
نجيب محفوظ هو مؤسس الرواية العربية الحديثة، وطورها كما تطورت في العالم أجمع، فلولاه لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. وقد بدأ بالرواية التاريخية وكان قد جهزع ديداً من الموضوعات التاريخية من التاريخ المصري القديم كرؤوس موضوعات للعمل عليها، لكنه بمعدل تطور شخصيته السريع المتناسب مع نموه الثقافي الذي كان يعمل عليه بتخطيط محكم ودأب شديد، رأى أن يتوقف بعد ثلاث روايات ويشرع في كتابة الرواية الواقعية تفاعلاً مع أحداث الوطن والعالم، فكتب "القاهرة الجديدة"، ثم "خان الخليلي" وسط أحداث الحرب العالمية الثانية، وواصل حتى "بداية ونهاية" و"السراب" التي تعامل فيها مع الرواية النفسية. انتقل بعدها إلى رواية الأجيال في "الثلاثية"، وهى رواية واحدة باسم "بين القصرين"، ولكنها صدرت في ثلاثة أجزاء لطولها ولاعتبارات عملية تجارية. قامت الثورة في ١٩٥٢ فتوقف حائراً لصدقه الإنساني، توقف اعتقاداً أن ما عمل من أجله ربما يكون قد حدث وتغير المجتمع للأفضل. توقف ليدرس ويراقب لمدة خمس سنوات ظن خلالها أنه قد نضب أدبياً؛ لفرط صدقه مع النفس. اتجه لدراسة السيناريو وكتبه ببراعة. كسب من ورائه أضعاف ما كسب من الأدب، لكنه بعد خمس سنوات تركه غير آسف، على حد قوله. تركه عندما شعر بالرغبة في الكتابة، فكتب "أولاد حارتنا"؛ دخولاً إلى مرحلة جديدة تنزع نحو الفكر الفلسفي الكوني لمعاني الحياة. وفجأة أبدع "اللص والكلاب"، مقتحماً أسلوب تيار الوعي الذي ترسخ في الآداب العالمية على يد جويس ومارسيل بروست وغيرهما، فواكب أحدث الأساليب وانطلق متألقاً في مجموعة روايات الستينيات حتى "ثرثرة فوق النيل" التي تنبأ فيها بما سيحل بالوطن بعدها بعام. وكتب روائعه التالية من "الحرافيش"، و"ليالي ألف ليلة" و"رحلة ابن فطومة"؛ وصولاً إلى أصداء السيرة الذاتية والأحلام.
لما سبق، لا أظن أن أحداً يمكن أن يؤثر في فن الرواية لدى قومه مثلما فعل الرجل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في اللا وعي، أو بوعي.