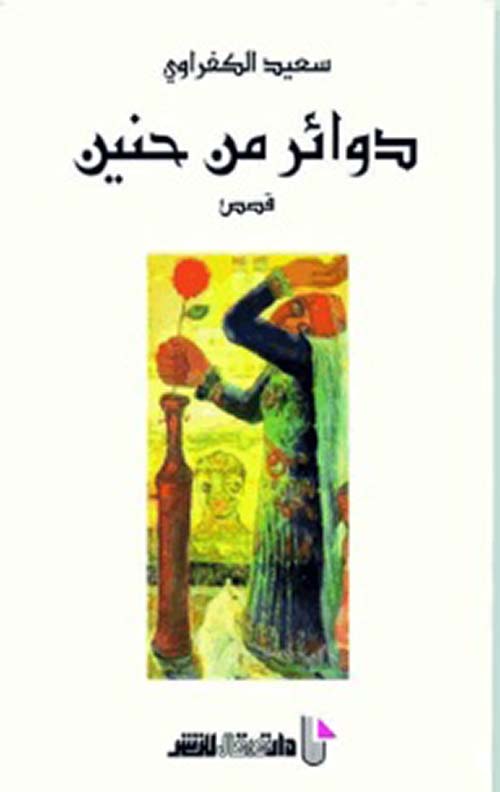يتعامل كثير من الروائيين مع القصة القصيرة كما لو كانت "استراحة المحارب"، فلا بأس عندهم في أن يكتبوا بعض القصص بين كل رواية وأخرى. لكن الكاتب المصري سعيد الكفراوي، الذي غيَّبه الموت أمس عن عمر يناهز 81 سنة، ظل راهباً في محراب القصة القصيرة ولم تغوه مقولة "زمن الرواية"، فأصدر 12 مجموعة قصصية، بدءاً من العام 1985. ولا شك فى أن هذا الإخلاص النادر لفن القصة القصيرة قد مكَّنه من أن يصل بها إلى مستوى رفيع وأن يقدم كتابة مغايرة عن القرية، عالمه الأثير، تختلف عن كتابة مَن جايلوه الذين كانت القرية محور أعمالهم من أمثال عبد الحكيم قاسم ومحمد مستجاب وخيري شلبي ومحمد البساطي.
ومن المعروف أن الكفراوي كوَّن نادياً أدبياً في مدينة المحلة الكبرى القريبة من مسقط رأسه في شمال القاهرة، ضمَّ أسماء أصبحت لامعة في مجالات مختلفة مثل الناقد جابرعصفور والروائي محمد المنسي قنديل والباحث الأكاديمي نصر حامد أبو زيد والشاعر فريد أبو سعدة. ورغم أنه بدأ كتابة القصة في الستينيات، فإنه لم ينشر أولى مجموعاته إلا فى منتصف الثمانينيات، ما يعكس حرصه على التميز وربما كان هذا سبب عزوفه عن كتابة الرواية وهو ما يتضح من قوله: "عشتُ بأمل أن أكتب رواية لم تكتب ولكن ما حققته لي القصة القصيرة كثير جداً".
والطريف أن نجيب محفوظ استوحى من الكفراوي شخصية "إسماعيل" في رواية "الكرنك" بعد أن تعرض كاتبنا للاعتقال عام 1970 وقبل وفاة عبدالناصر بأيام بسبب نشره لقصة "المهرة" في مجلة "سنابل". وتحكي هذه القصة عن "مُهرة" احتكرها الأخ الكبير لنفسه وحرم أخاه الأصغر من امتطائها، ففسرتها السلطة آنذاك تفسيراً سياسياً.
عينٌ لاقطة
والحق أن هناك ما يشبه الإجماع على تميزه في مقاربة عالم القرية، وقد عبر عن ذلك صنع الله إبراهيم مثلاً بقوله إن الكفراوي "يتفرد بين الكتاب الذين عالجوا هذا العالم في قصصهم بسمات واضحة، فعينُه اللاقطة وقلمه المتمكن يعملان في تلك المنطقة الغامضة المشحونة بالطقوس والخرافات".
ويرجع تميز الكفراوي إلى تركيزه على علاقة الإنسان بالحيوان داخل البيئة الريفية والإحساس بالطبيعة واختلافات فصولها وخلط الحلم بالكابوس. والحقيقة أن ما كتبه في هذا الصدد لم يكن وليد المشاهدة فحسب بل وليد الذاكرة عن القرية المحفورة في الروح. يقول الكفراوي في ذلك: "غايتي أن أستحوذ على زمن يضيع"، وهو ما يتضح في قصة "لابورصانوفا" من مجموعة "مدينة الموت الجميل"، والتي يقول في استهلالها: "كان أبي الشيخ قد عمَّدنى ثلاثاً في بحر النيل... كنتُ طفلاً صغيراً أعشق النهر والحارة وجوادي الأشهب... شرقتُ بالطمي وصرختُ مفزوعاً وأنا أغطس في النهر. صاح بي أبي: إجمد يا ابن الناس، ماء النيل يرُم العظام ويروي القلوب".
يعود الكاتب – هنا – إلى طفولته، مستعيداً ذكرياته مع الأب ونهر النيل الذي تمَّ تعميده فيه وكأنه كما قال فى مدخل مختاراته "زبيدة والوحش" (الدار المصرية اللبنانية) مُقدَّر عليه أن يأتي بالماضي ويثبته على صفحات هذه الحكايا.
وهكذا تظل كتابة الكفراوي كأنها خيط مشدود إلى عالمين؛ أحدهما قديم يكاد يندثر والآخر ينهض من تحت ركامه، لكنه مثقلٌ بالخوف والقلق. وهذا التقسيم التقليدي للزمن بأبعاده الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، لا يستقيم في الحديث عن زمن القص عند الكفراوي، وهو ما أطلق شكري عيَّاد "الزمن البئر" الذي "لا يتميز فيه الماضي عن الحاضر أو المستقبل وتتقطَّر فيه تجارب الإنسان والتي لا تختلف في جوهرها بين إنسان عاش منذ آلاف السنين وإنسان يولد اليوم أو يموت غداً في قرية مصرية".
بين الواقعي والأسطوري
هذه الرؤية الخاصة للزمن التي تتعامل معه بوصفه بعداً واحداً تتماثل مع سعي الكاتب إلى التخلص من مركزية الحدث أو الراوي، والاعتماد بدرجة كبيرة على الذات الساردة ونوازعها وأحلامها. وأنا لستُ مع تقسيم أحد الباحثين قصص كاتبنا إلى فانتازية وواقعية سحرية وواقعية محضة، وأخرى على النهج الكافكاوي. ففي تصوري أن قصص الكفراوي ضد المذهبية ولا تنطلق من أفكار مسبقة على نحو ما يبدو في قوله "ما يفسد العمل الفني هو الأفكار. فالأفكار شقيقة الأيديولوجيا، والعمل الأدبي يقوم على التخييل وليس على الوقائع".
ومع ذلك يبقى ذلك الحوار الدائم – كما يقول شكري عيَّاد – بين الواقعي اليومي بتفاصيله المحددة، والأسطوري الخارق في تآلف تام متأثراً في ذلك بالقصص الشعبي خاصة "ألف ليلة وليلة" التي جذبته لعالم السرد منذ صباه. على أنه ينبغي ملاحظة أن هذا المزج بين الواقعي والأسطوري لم يكن وليد تأثر مباشر بآباء الواقعية السحرية العالميين. فرغم الاشتراك في التوجه العام، استطاع الكفراوي – كما تقول اعتدال عثمان – أن يكون أحد صناع "الواقعية السحرية بمذاقها المصري الأصيل الحريف المعيش في الريف والمدينة".
وكانت كلمته في مؤتمر أدبي عُقِد في باريس لافتة، في التسعينيات، لأنها وضحت رافده الأساسى في الكتابة، المتمثل في حكايات القرويين وعلاقاتهم بالحيوانات، حين يقول: "أنا فلاح ولي جدة لها علاقة – قد تكون أسطورية – ببقرة لا تحلب إلا على يدها، وذات مرة ذهبت إلى المدينة وبقيت هناك ثلاثة أيام وأبَت البقرة أن يحلبها أحد آخر. وكما هو معروف فإن الحليب إذا بقى في البقرة يوصلها إلى الموت وعندما عادت جدتي وفي وسط الزحمة والضجة سمعت البقرة صوتها فنزل الحليب".
علاقة وطيدة بالشعر
هذه الحكايات الأسطورية والحقيقية في الوقت نفسه هي المعين الأكبر لكتابة الكفراوي. وقد ظللت لفترة أتعجب من العلاقة القوية التى تربط كاتبنا بشاعرين كبيرين هما أدونيس وعفيفي مطر، غير أن قراءتي لأعماله وحواراته أزالت هذا التعجب. ففي أحد الحوارات يوضح العلاقة الوثيقة بين القصة القصيرة والشعر بقوله: "الشعر يمنح تلك القدرة على الخروج من حيز الاستعارات الميتة. وكان وعيي دائما أن القصة شقيقة الشعر وقراءتي للشعر خدمت نصي فصار الشعر جزءاً من بنائه وغير متعارض معه".
وصف أدونيس كتابة الكفراوي بأنها كتابة "الأحشاء"، متجاوزا تلك الثنائية التي تصف الكتابة – عموماً – بأنها إما كتابة "الجسد" أو كتابة "الروح". ولا شك في أننا نلحظ تلك القربى الروحية بين كاتبنا وعفيفي مطر، فكلاهما ابن القرية المصرية وكلاهما استطاع أن يجعل من أساطير القرية وعاداتها معيناً لا ينضب.
ولهذا لم تكن الإروسية – عند الكفراوي – نزوعاً جسدياً، بل منتزعة من لحم الحياة ومواجهة للموت الذي مثَّل هو الآخر محوراً أساسياً في أعماله؛ ليس بوصفه نهاية للحياة بل انتقالاً لحياة أخرى أو امتداداً للموتى داخل الأحياء. ففي قصة "شرف الدم"، يرى الشاب رميم أهله بعد الوفاة عدا والده، فظلَّ يبحث عنه في كل مكان وكلما ازداد بحثه توغَّل في العمر إلى أن بلغ عمر أبيه، وعندما نظر في المرآة وجد صورة والده فيها.
وفي قصة "عزاء"، يحكي الراوي عن تلك الطفلة الكفيفة التي كانت تقرأ القرآن بصوت عذب ثم تموت فجأة فيخرج الجميع ليشيعوها كأنما يزفونها إلى عريسها الذي سوف تلقاه فى العالم الآخر.
إن رحيل سعيد الكفراوي خسارة كبيرة لفن القصة القصيرة التي أخلص لها فأعطته نفسها وباحت له بأسرارها وحققت له مقولة أستورياس: "من يجعل وهو يرحل أو يموت أهله يذكرونه ويستمرون على الإحساس بأنه يعيش معهم لا يكون قد رحل نهائياً، لايكون قد مات تماماً".