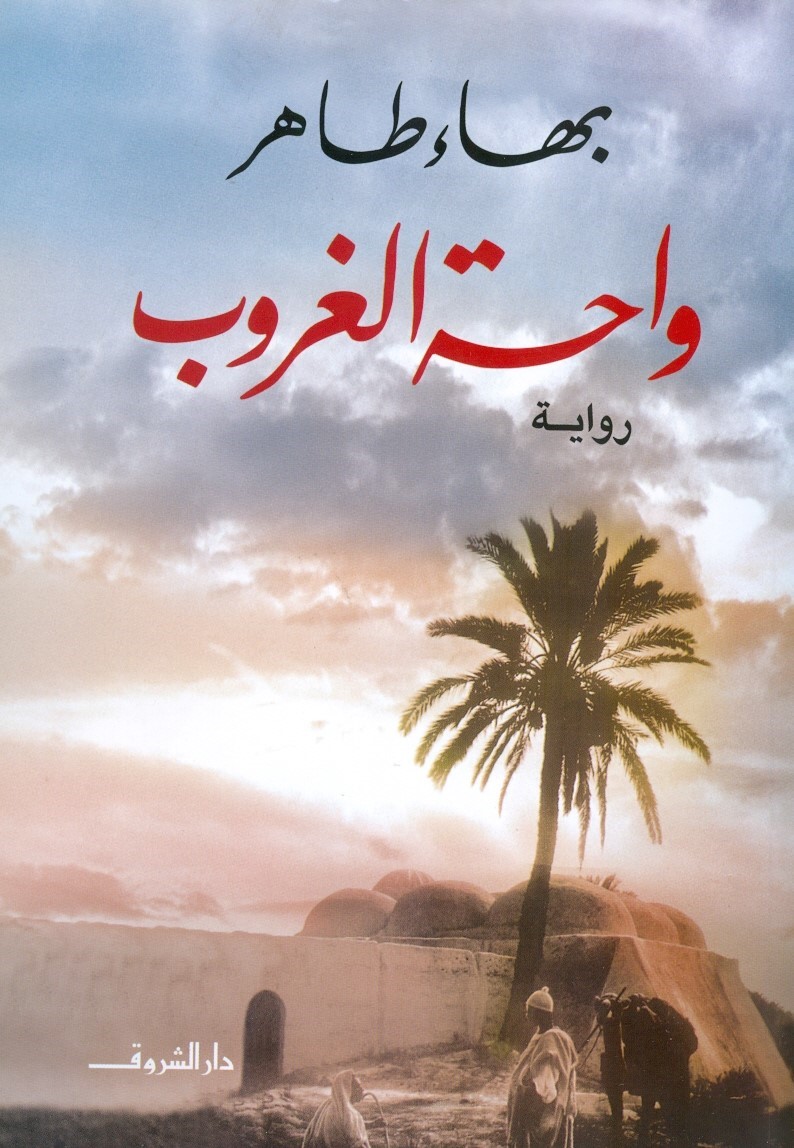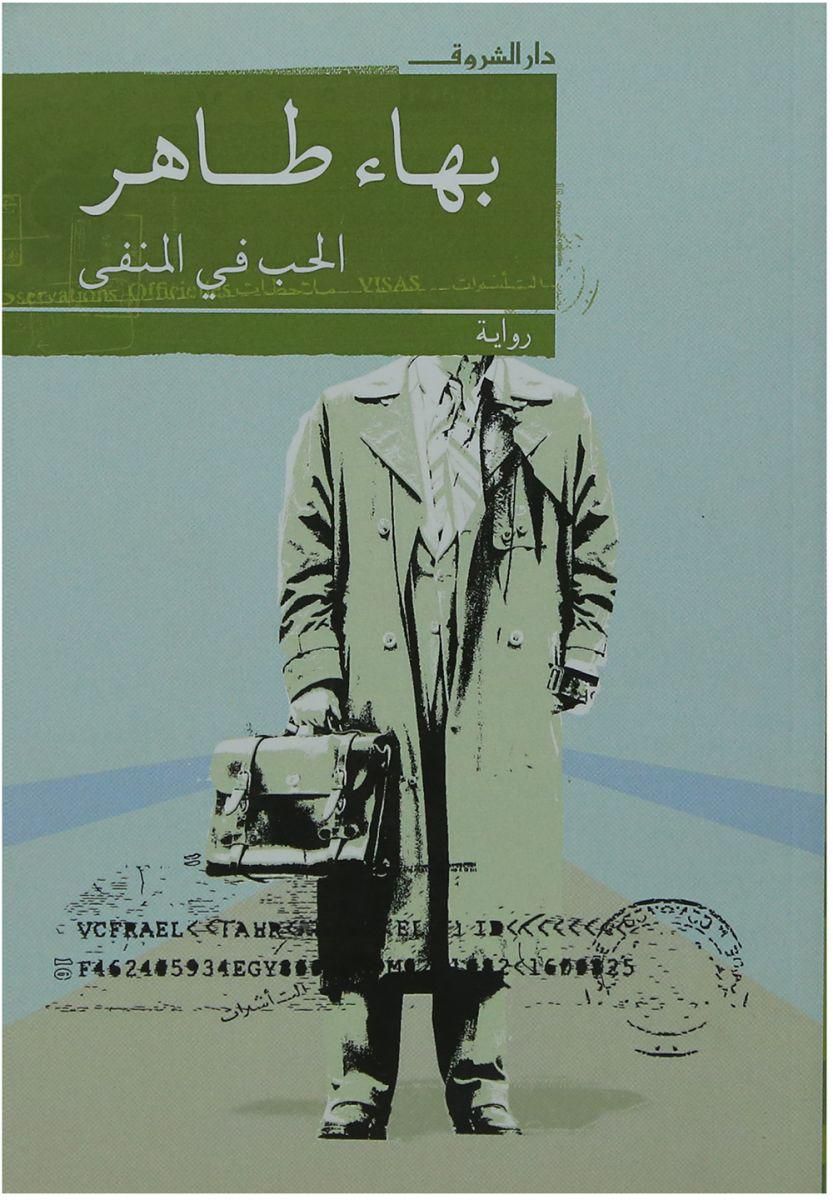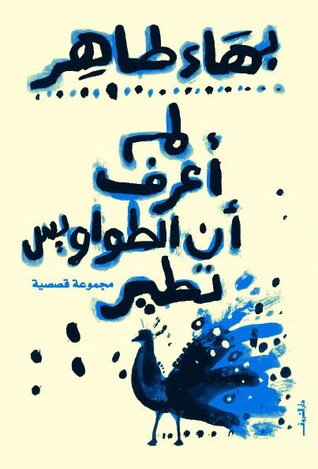خرج الروائي والقاص المصري الرائد بهاء طاهر عن صمته الذي فرضته عزلة الشيخوخة، والتقى جمعاً من الأصدقاء، ومعظمهم من قرائه والمعجبين برواياته، وأكد في هذه الإطلالة التي لقيت ترحاباً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن صحته بخير على الرغم من وطأة الشيخوخة. وهنا بروفايل نقدي لهذا الروائي المتفرد بفنه السردي وعالمه الواسع ولغته.
في العام نفسه الذي شهد انتفاضة الطلبة الشهيرة ضد الإنجليز في مصر (1935)، احتجاجاً على تدخل بريطانيا في الشأن المصري، ونصيحتها باستبعاد العودة للعمل بدستور 1923، ولد بهاء طاهر، وتحديداً في 13 يناير (كانون الثاني)، ليقدر له أن يصبح نموذجاً للتجديد في القصة والرواية ضمن جيل الستينيات.
بدت ثوريته في أعماله الأدبية على مستويات عدة، فهو لم يأتِ بمنهج مغاير في الكتابة وحسب، وإنما حملت نصوصه في طياتها انتفاضات ضمنية ضد القمع، والظلم، والطبقية، والكراهية، والعنصرية، والفساد.
وعلى مدار منجز أدبي لم يتجاوز ستة نصوص روائية هي "شرق النخيل"، و"قالت ضحى"، و"نقطة النور"، و"خالتي صفية والدير"، و"الحب في المنفى"، و"واحة الغروب" (والأخيرة حصل بهاء طاهر عنها على جائزة البوكر العربية)، وخمس مجموعات قصصية هي "الخطوبة"، و"بالأمس حلمت بك"، و"أنا الملك جئت"، و"ذهبت إلى شلال"، و"لم أعرف أن الطواويس تطير"، إضافة إلى بعض الكتابات المسرحية والإسهامات النقدية، برهن بهاء طاهر على اختلافه وخصوصية منهجه السردي. فأبطاله في مجمل أعماله لم يسلكوا المنحى المثالي الذي كان يقره بعض الكتاب من جيل سبقه، كضرورة أن تمضي بالنص الأدبي عادة إلى نهايات لا توافق الواقع، ولا تصدقه، بل كانت شخوصاً بشرية خالصة تحمل تناقضات النفس، خيرها وشرها، وتتقاطع في سمة غالبة من الاغتراب الداخلي وازدواج المشاعر، حيث يختلط الحب بالكراهية، والتعاطف بالإدانة، فتكون المحصلة النهائية نفساً مأزومة ممزقة وعاجزة تتجلى بين السطور.
وربما كان باعث خلقه تلك الشخوص؛ أزمته مع ثورة يوليو (تموز)، التي آمن بأهدافها، وأحب زعيمها (جمال عبد الناصر)، بينما رفض الدعاية لها، وانتقد استبداد سلطتها، ورصد ما أحدثته من أمور جسام وتحولات كبيرة خلال حقبة الستينيات؛ تلك الحقبة التي ظلت تطل برأسها كفضاء زمني في معظم أعمال بهاء طاهر، كأنما ظل جزء منه قابعاً فيها لا يغادرها، يعيشها وإن مضت، ويستحضرها كلما تسلم هذا "الجزء من نفسه"؛ زمام السرد.
العجز في نصوص ما بعد النكسة
في عام 1972 صدرت المجموعة القصصية الأولى لبهاء طاهر "الخطوبة" لتكون لقاءه الأول مع عوالم السرد، وقوبلت باحتفاء من الوسط الأدبي، ودفعت الكاتب يوسف إدريس لأن يصف طاهر بأنه كاتب لا يستعير أصابع غيره، ولا يقلد أحداً. وفي معظم قصص المجموعة تغلب تيمة العجز وكسر الإرادة والقمع، فنجد في قصة "الخطوبة" التي حملت المجموعة اسمها، وكتبت في فترة ما بعد نكسة يونيو (حزيران)؛ بطلاً ينكسر حلمه في الاقتران بالفتاة التي أحبها تحت وطأة السلطة الأبوية. وبالنظر إلى منهج الكاتب المشحون بالرمز طيلة مسيرته الأدبية، فربما كانت في هذه القصة إحالة إلى السلطة السياسية التي اغتالت الحلم بهزيمتها في 1967. وفي قصة "الأب"، وهي من المجموعة نفسها، تتكسر الأحلام مرة أخرى فوق صخرة الواقع، فتتبدد أحلام الزوج في السفر وارتشاف الحياة، وتتطاير كفقاعات في الهواء أمام واقع الفقر ومصيدة الزواج والإنجاب. وهكذا الحال أيضاً في قصة "المظاهرة"؛ إذ تنكسر إرادة الراوي في بيع إرثه وتحقيق أحلامه، وأن يحيا الحياة التي يريدها.
ميزت هذه التيمة معظم أعمال بهاء طاهر، كما اتسمت كتاباته - كغيره من جيل الستينيات - بالاهتمام بالعوالم الداخلية للنفس الإنسانية وما يدور في أعماقها، فكان من الطبيعي أن يبرز حضور تقنيات سردية بعينها كالمونولوغ، والتذكر، والحلم، والرمز.
التحول سمة الشخوص
نتيجة أخرى تتجلى عبر منجزه الأدبي، لا سيما الروائي؛ تتصل باعتنائه في مجمل أعماله برصد التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية واقترابه من التحولات الفردية والنفسية، فشخوصه غالباً ما تغير مسارها، كما تغير مشاعرها ومبادئها أيضاً تحت وطأة هزيمة ما، فـ"ليلى" في "شرق النخيل" تحولت مشاعرها من الحب إلى اللا حب، وتغير مسار شعورها متخلياً عن رجل مقابل اعتناق قضية.
كذلك تبدلت "صفية" في "خالتي صفية والدير" من هيامها بـ"حربي" إلى كراهيته والسعي لقتله والثأر منه، بعد أن هزمها مرةً بالتخلي حين طلبها لخاله القنصل، ومرة ثانية حين قتل زوجها القنصل، وأعاد إنتاج يتمها بموت ذلك الزوج الستيني. أما بطلة "قالت ضحى" فتحولت على أكثر من صعيد، لا على صعيد شعورها بالراوي الذي تخلت عنه، وإنما نال التحول من منهجها في التعاطي مع الحياة تحت وطأة هزيمتها من الأب والزوج والحبيب، لتصبح امرأة أشد قسوة، تتورط في عمليات الفساد، وتدير بيتها للقمار. وليست "ضحى" وحدها في هذه الرواية من أصابتها لعنة التحول، فالراوي أيضاً تحول من الثورية والإيمان بالحرية والمناداة بها إلى السلبية والتخبط والعزوف، وسقط في فخ الخيانة حين وشى بصديقه مخافة العصي والهروات.
وهكذا، استمرت لعنة التحول تحل بالشخوص في كل نص روائي لبهاء طاهر، وبدت جلية في روايته "الحب في المنفى" على مستوى عديد من الشخوص، بداية من "يوسف"، الذي تحول من الناصرية - التي ورثها عن أبيه - إلى السلفية حين أصبحت طريقه للحصول على المال، مروراً بـ"خالد" (ابن الراوي) الذي أصابته أيضاً هذه اللعنة، فتحول من طالب هندسة متفوق في الرياضيات والشطرنج، إلى سلفي متطرف يحرم كل شيء حتى هذه اللعبة، ويسهم في تحول أمه "منار" من صحافية مهتمة بحقوق المرأة والشأن العام، إلى الكتابة في الشؤون الدينية.
أما الراوي فتحول تحولاً ضمنياً ناعماً من مندد بالانفتاح إلى مستفيد منه، وإن ظل وفياً لمبدئه الصحافي في مناصرة المظلومين والضحايا، لا سيما في لبنان، بعد احتلال إسرائيل له عام 1982.
وفي رواية "واحة الغروب" تحول "محمود عزمي" من الإيمان بالثورة العرابية إلى الكفر بها، إلى حد وصف الثوار بالبغاة. وهكذا، لا يكاد يخلو أي عمل من أعمال بهاء طاهر من هذا التحول، وهو أمر يحيل إلى فلسفته ورؤيته التي تفيد بأن النفس الإنسانية تمضي فوق خيط رفيع بين الأضداد المتباينة، فلا شيء يعصم الشريف من الوقوع في براثن الخطيئة، ولا أبدية لمبدأ أو منهج أو شعور.
وعلى الرغم من هذه الرؤية التي ترسخ قاعدة التحول، واستثناء الثبات، ظل بهاء طاهر ثابتاً على عقيدته التي تؤمن بالحرية، وتندد بكل أشكال التسلط والاستبداد، وتنأى عن كل من يصفق له، فالرجل الذي أحب عبد الناصر وآمن بالثورة وأهدافها هو نفسه الذي رفض الترقي أثناء عمله في مصلحة الاستعلامات في ستينيات القرن الماضي كيلا يكون بوقاً للثورة وترساً من تروس الدعاية لها. وهو أيضاً الذي تعرض للتضييق ومنع من الكتابة أثناء حكم السادات، لرؤاه المتعارضة مع المنهج السياسي والاقتصادي للحاكم، وهو الذي أبى أن يدلو ولو بتصريح واحد لأي صحيفة من الصحف الرسمية طيلة حكم نظام مبارك، وأعاد جائزة "مبارك للآداب" التي حصل عليها في عام 2009 بعد عامين من تسلمها عقب ما شاهده من وحشية النظام في التعامل مع المتظاهرين في مستهل 2011، قائلاً: "أنا لا أستطيع أن أحمل هذه الجائزة وقد أراق نظام مبارك دماء المصريين".
آلام سنوات من المنفى، وإن كان اختيارياً، لم تكن إلا لتترك بصمتها في كل نص أبدعه بهاء طاهر، لكن حزنه الشفيف حين امتزج بعبقرية السرد، أتاح له قدرة على تجسيد مآسي الواقع بصدق وحرفية لا يملك القارئ أمامها إلا أن يذرف مشاعره دفعة واحدة. فداخل أبنيته الأدبية يقبض على الفساد، والقهر، والاستبداد، والسلبية، والطبقية، وتضليل الوعي، وتداعيات بروز تيارات الإسلام المتطرف، إضافة إلى همه الأكبر، وهو اغتصاب الأرض والتاريخ والحرية. ووسط هذه المآسي التي تظللها تيمة القهر إما بالخوف، وإما بالجهل، وإما بالفقر، تتسلل في أعماله نزعة من تمرد وثورة. إلا أن هناك دائماً من يخون، وكأنما الخيانة قدر الثورات، وقدر الأدب أن يوثقها، وهذا ما بدا في "واحة الغروب" بحضور خيانة الخديوي توفيق للثورة العرابية، وخيانة الراوي "الثوري" لصديقه في "قالت ضحى"، وخيانة بعض الشخوص في "حب في المنفى" للحقيقة.
الثنائيات المتقابلة
مزيج من الثنائيات المتقابلة والمتناقضة يطل عادةً من السياقات الأدبية التي أنتجها بهاء طاهر خلال مسيرته الإبداعية، وبرزت براعته في المزج بين تلك المتناقضات في نعومة وانسيابية، تارة بين الماضي والحاضر، وتارة بين الجسد والروح، وأخرى بين الواقعي والفانتازي، والشباب والكهولة، والسلطة والمواطن، وأيضاً بين الشرق والغرب. فلم يخفِ بهاء طاهر يوماً إيمانه بضرورة الانفتاح على الثقافات الأخرى في علاقة تكاملية بعيدة عن التبعية والإذعان، وعزز إيمانه؛ تجربته الخاصة وتنقله في كثير من الدول لسنوات طويلة بعيداً عن الوطن، وقد تجلت تلك الرؤية عبر حضور الغرب في معظم أعماله الأدبية، تارة عبر الفضاءات المكانية، وتارة عبر الشخوص. وكانت روايته "حب في المنفى" أكثر أعماله التي برزت فيها هذه الثنائية، والتي عقد فيها مقارنات ضمنية بين شرق يدعي أفضلية دينية، بينما فيه من يكذب ويظلم ويحتال، وغرب متهم بالمادية، بينما فيه من يتحرى الصدق والجد، ويسعى لنصرة المظلومين. وفي سبيل تأكيد هذه الرؤية استدعى بهاء طاهر شهادات حقيقية للصحافي اليهودي الأميركي "رالف" عن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان (صبرا وشاتيلا)، وشهادة أخرى لممرضة أجنبية عن عين الحلوة.
برزت هذه الثنائية أيضاً في درته "واحة الغروب" التي تمثل الشرق فيها؛ شخصية ضابط الشرطة "محمود عبد الظاهر"، بينما كان حضور الغرب على مستويين، الأول في زوجته "كاثرين" الإنجليزية من أصل إيرلندي، وهي متفتحة ونشيطة ومتحركة، ولديها مشاعر طيبة تجاه الشرق، وليست كالمستعمر، وهو صاحب الحضور الثاني للغرب في النص، والذي كان طامعاً، يجل ماضي الشرق وتاريخه، ويتعالى على حاضره. وقد أبرزت هذه الثنائية، سواء في "واحة الغروب"، أو في غيرها من أعمال الكاتب، رؤيته الموضوعية التي اختبرها في سنوات الغربة، أن الغرب ليس خيراً خالصاً، وأيضاً ليس شراً خالصاً.