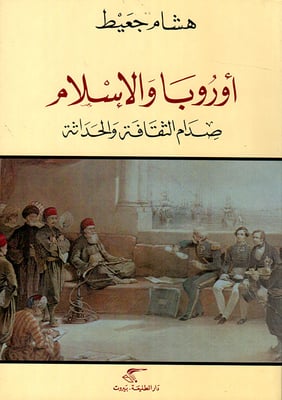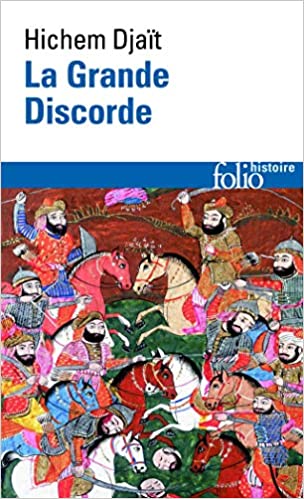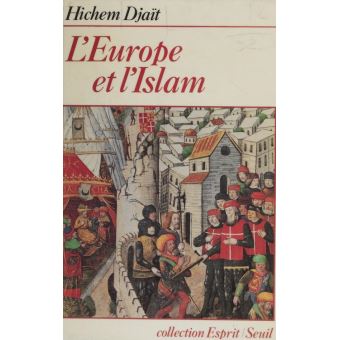برحيل المفكر التونسي هشام جعيط يختفي وجه من وجوه التحديث والتفكير الحر في الثقافة العربية المعاصرة، فهو أسهم مساهمة فاعلة في إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي، وبخاصة تاريخ الإسلام المبكر، مسترفداً جملة من العلوم الحديثة مثل الأنثروبولوجيا والفيلولوجيا.
برز جعيط خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي ضمن نخبة من المفكرين المغاربة "الذين حملوا إلى الفكر العربي صوتاً جديداً قوياً يطرح أسئلة جوهرية على النخب العربية مشرقاً ومغرباً، في شأن الهوية والتاريخ العربيين وسبل الانتماء إلى الحاضر والمستقبل"، كما تقول الكاتبة عزيزة بن عمر.
ولد سنة 1935 في تونس العاصمة في أسرة تولى أفرادها مناصب رفيعة في السياسة والقضاء والتدريس والإفتاء. ورغم انتماء أسرته إلى ثقافة محافظة فإنها عملت على تزويده بثقافة عصرية، مزدوجة اللسان منفتحة على العلوم الجديدة. فانتسب إلى المدرسة الصادقية التي تعد رمز التعليم الحديث في البلاد التونسية منذ القرن التاسع، إذ دعا مؤسسوها، منذ افتتاحها، إلى الاقتباس من الغرب "ما فيه يصلح حال الوطن"، وفيها تخرج زعماء الحركة الوطنية، ورواد الفكر الإصلاحي، وبناة دولة الاستقلال مثل: الحبيب بورقيبة، ومحمود المسعدي، وأحمد بن صالح. انتسب، بعد حصوله على البكالوريا، إلى جامعة السوربون في باريس، وفيها تحصل على شهادة التبريز في التاريخ سنة 1962، وعلى شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، ليتولى بعد ذلك التدريس، في أهم الجامعات الأوروبية والأميركية (جامعة ماك غيل - مونريال، وجامعة كاليفورنيا، والسوربون- فرنسا، تونس...). ثم انتخب، بعد ذلك، رئيساً للمجمع التونسي للعلوم والآداب "بيت الحكمة" بين 2012 و2015.
الأب المؤسس
يعد جعيط الأب المؤسس لدراسات الإسلام المبكر في الجامعة التونسية، وقد عمل، مع عدد من طلابه، على وضع أسس مدرسة تونسية في التاريخ تساهم في تطوير البحوث التاريخية العربية. ولا شك في أن انتساب جعيط إلى السوربون أتاح له الاطلاع على أهم المدارس التاريخية الحديثة التي احتضنتها الجامعات الفرنسية، كما أتاحت له التعرف إلى المناهج الجديدة في التعامل مع الحدث التاريخي. ومكنه تردده على المحاضرات التي تنعقد في مدرجات السوربون من الاستئناس ببعض العلوم الحديثة في قراءة التاريخ مثل الأنثروبولوجيا والفيلولوجيا وعلمي الاجتماع والنفس. هذه الثقافة المتنوعة هي التي دفعت جعيط إلى إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي، واجتراح قراءة جديدة مختلفة تستضيء بعلوم كثيرة من أجل محاصرة الظاهرة التاريخية، كما دفعته إلى إعادة النظر في جملة من المسلمات التي باتت من أثر التكرار بعد التكرار، أشبه بالحقائق الثابتة.
لقد رسخ في ذهن هشام جعيط أن العرب لم يكتبوا بعد تاريخهم، أو بعبارة أدق كتبوا "تاريخاً مفعماً بالأيديولوجيا والفلسفة" وكأنهم لا يؤمنون بـ"علمية المعرفة التاريخية ومعقوليتها"، والحال أن التاريخ في نظر جعيط "علم دقيق يقارب في دقته علوماً صحيحة كالرياضيات". فلا كتابة للتاريخ من دون وعي نقدي، يستقرئ كل المصادر وفق رؤية علمية صارمة، تقبل وتستبعد، تؤكد وتستدرك. وينبغي أن يشمل هذا الوعي النقدي كل المصادر التاريخية، بما في ذلك الأمهات مثل تاريخ الطبري و"الكامل في التاريخ" لابن الأثير. وظل جعيط يؤاخذ المؤرخين العرب على جنوحهم، بعد التخلص من الاستعمار، إلى كتابة "التاريخ الوطني" معزولاً عن الحضارة الأم، منفصلاً عن الجسد العربي الإسلامي، فجاء هذ التاريخ مبتوراً لا يفصح عن الواقع بقدر ما يفصح عن أيديولوجية كاتبه.
لخص الباحث في التاريخ نادر الحمامي، موقف جعيط قائلاً: "لقد أشار جعيط إلى ارتباط الكتابة التاريخية العربية في العصر الحديث، بفكرة الدولة الوطنية، مما جعل العرب يكتبون في التاريخ الوطني لدول بعينها. فما العلاقة مثلاً بين تاريخ العراق القديم باعتباره قلب الحضارات الكبرى، والعراق بوصفه دولة وطنية؟".
المفكر القلق
انطلاقاً من هذه الأسس النظرية وضع هشام جعيط عدداً من الكتب التاريخية التي انعطفت بخاصة على مرحلة الإسلام المبكر، بالنظر والتأمل ومن أهمها "الكوفة نشأة المدينة العربية الإسلامية" و"أزمة الثقافة الإسلامية" و"الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي"، و"أوروبا والإسلام: صدام الثقافة والحداثة". أما أشهر أعماله فهي ثلاثية "السيرة النبوية"، و"الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر". وصفت الباحثة رجاء بن سلامة هشام جعيط بـ"المفكر القلق الذي ينفر من الاختصاص الضيق"، فهو دائم البحث والتساؤل، لم يقر له قرار، كل كتاب جديد مغامرة بحثية جديدة مفتوحة على مغامرة ثانية.
لا شك في أن هشام جعيط استفاد في بحوثه من تطور مناهج المعرفة التاريخية في أوروبا، واعتمد، على وجه الخصوص، المنهج التاريخي، يسترشد به في كل بحوثه. لكن هذا المنهج لم يكن في أعمال الباحث، منغلقاً على نفسه، مكتفياً بذاته، بل كان مفتوحاً على العلوم الأخرى ويستفيد منها. ويفسر جعيط هذا المنهج قائلاً إنه "استقراء الباحث للماضي متسلحاً بمعرفة دقيقة بالمصادر والمراجع وبالتعاطف اللازم مع موضوعه برحابة صدر ورجاحة فكر".
يتفق النقاد على أن استدعاء جعيط للمنهج التاريخي يرتد إلى تأثره بالمستشرقين الذين تشبثوا بهذا المنهج القائم على الصرامة في البحث، والدقة في التحليل والتأويل. وهو بذلك يستدرك القراءات التمجيدية للتاريخ التي لا تقارب الظاهرة التاريخية مقاربة موضوعية، بل تكتفي، في الأغلب الأعم، باستدعاء النصوص القديمة وتزكي أساليبها في التوثيق والتحقيق. في هذا السياق يؤكد جعيط أن سيرة ابن هشام وابن إسحاق، على سبيل المثال، لا تقدم للباحث إجابات علمية دقيقة نظراً إلى تأخر تدوين هذه السير ولغلبة النزعة الوعظية عليها.
عن المنهج الذي اختاره لأهم كتبه، ونعني بذلك "كتاب السيرة النبوية" يقول هشام جعيط في المقدمة، إن هذا الكتاب أخذ منه عشرين سنة من القراءة والتمحيص. فقد عاد إلى مئات الكتب، ودقق عدداً كبيراً من المصادر عن كثب، كي يتمكن من معرفة الطرق التي توخاها الرسول لتكوين "الأمة" أي لصياغة كيان متضامن، متكامل.
كان هدف هشام جعيط من هذ الكتاب إعادة كتابة السيرة النبوية بطريقة علمية مغايرة للسير السابقة، كما جاء في المقدمة، مؤكداً أن دراسته للإسلام المبكر موضوعية وليست فلسفية. ويحدد منهجه، منذ المقدمة، تحديداً صارماً. فمن حيث الأسلوب: يتحاشى جعيط "الأسلوب الوهاج المشوب بالضبابية"، مستأنساً كما قال بالأسلوب القرآني الذي جمع بين "دقة التعبيرـ ووضوح المعنى". أما من حيث المضمون فقد اعتمد المنهج التاريخي الذي يعتبره منهجاً عقلانياً موضوعياً مستثمراً، كما قال، آخر ما توصلت إليه أدبيات التاريخ المقارن للأديان ومناهج التأويل الحديث.
لعل من أهم مزايا هشام جعيط أنه أعاد إلينا العلاقة القديمة بين المعرفة والتعاطف، فكل قراءة تقوم على التعاطف مع الموضوع، بحسب عبارته، فإذا فقد الباحث ذلك التعاطف فقد البحث توهجه وقيمته.
كل من يقرأ كتب هشام جعيط يلحظ أثر هذا التعاطف في كل صفحاتها، فجعيط المولع بالأدب، والقارئ النهم للرواية الحديثة، والمقبل على شعر السياب ينشده بشغف كبير، لم يفقد أبداً وهو يدخل مختبره، رهافة الأديب وحساسية الشاعر.