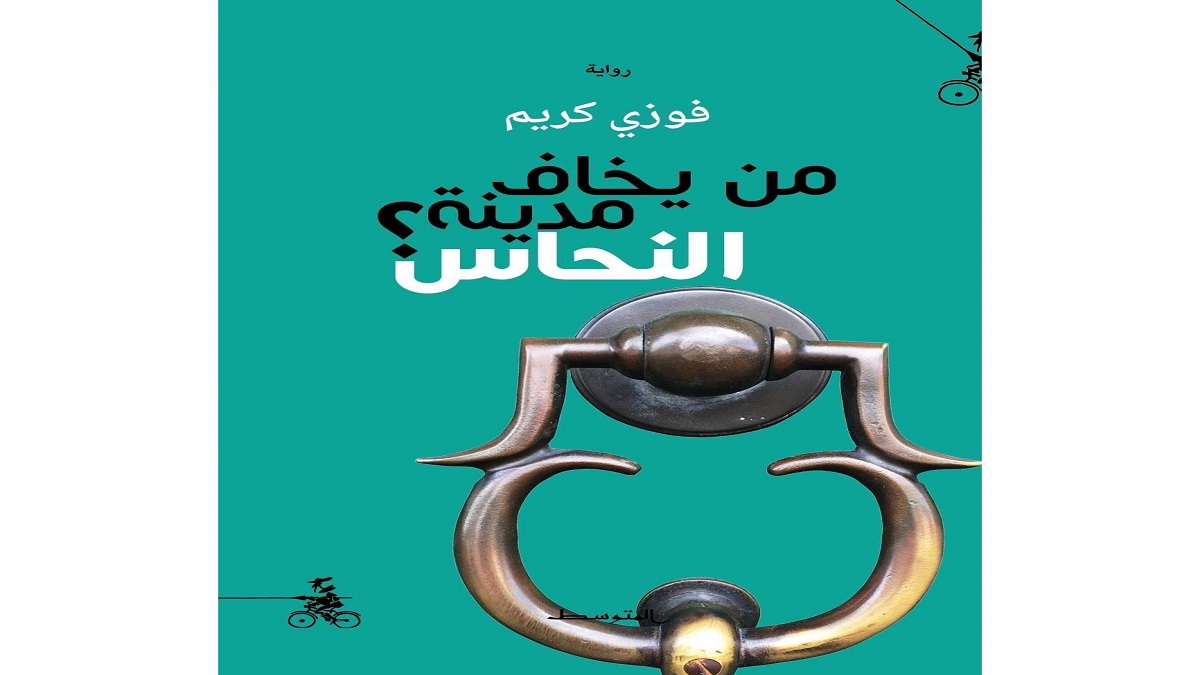لعل رحيل شاعر ومثقف بحجم فوزي كريم يبدو مقاماً جديراً بمقال الرثاء، وموضعَ حالٍ يقتضي التأبين، وهو ما سيحظى به، بلا شك، بوصفه شاعراً أساسياً في جيل الستينيات وفي الشعرية العراقية والعربية بشكل عام، وإنساناً يستحقُّ الصلاة الجماعية للشعراء في يوم رحيله.
ولأن ما من شاعر تغيب روحه مع رحيله الجسدي، فإن أفكاره ومواقفه وقلق أسئلته تواصل الحضور، "حيث تبدأ الأشياء" فيصبح الرحيل أبعد من كونه انخراطاً في طقس عزاء جماعي، ويغدو حافزاً لمراجعة الإرث الذهني والروحي للشاعر في تجربته الممتدة لأكثر من نصف قرن بوصفها رحلة تامة ومتاهة انتهتْ بالاكتمال.
ذلك أن شعر فوزي يزخر بالمراثي، منذ مرثيته المبكرة لحسين مردان، وصولاً إلى "مرثية الحمل الضال" لمحمود جنداري: وهو ما سميتُهُ "مرثية الذات عبر الآخر" في دراستي عن ديوانه "قصائد من جزيرة مجهولة":
"لم أكنْ عِظةً لأحدٍ
لم يكنْ وطني، يومَ غادرتُ، غيرَ القميصِ الذي أرتدي
واحتمالات أن لا أعود".
والمرثية كما يراها فوزي نفسه تختلف عن التعزية، بمعنى إنها لليست مجرَّدَ عَبرة أسى، بل عِبرة تجربة:
"تنتظرُ عزاءً من أحد؟
إني أنتظر مراثيَ".
واقتداء بهذا الفهم أهدى أعماله الشعرية بمرثية جماعية لافتة: "إلى: محمود جنداري، جاسم الزبيدي، عباس فاضل، محسن إطيمش، منهل نعمة، محمد شمسي، شريف الربيعي، موفق خضر، عبد الجبار عباس، غازي العبادي، موسى كريدي، أحمد فياض المفرجي، أحمد أمير، عبد الأمير الحصيري، سامي محمد، إلى أرواح هؤلاء وكل المنسيين من أبناء جيلي، ممن هرستهم عجلة المرحلة البربرية، أهدي قصائدي هذه، عاجزة عن العزاء والسلوان".
وبعيداً عن مقام الرثاء فإن فوزي كريم مثقف نقدي حيوي، وكثيراً ما يجدُ متعة أبيقورية في السجال، فكانت جلسات مقاهي أوحانات دمشق، خلال زياراته المتكررة، زاخرة بالحوار والاختلاف، خاصة بعد أن أجرى عمليه القلب المفتوح، وأصبح من أصحاب "الكأس الواحدة" أو يكتفي طيلة السهرة بمتعة النديم الذي يضفي على السهرات ظرفاً بغدادياً أنيقاً. ففي شخصيته وشعره ثمة "تكامل القديس والساحر"، كما يقول سعدي في تقديمه لأعماله الشعرية. بيد أن هذا التكامل يبدو لي كناية عن قلق داخلي، فحين كتب فوزي كريم كتابه النقدي "تهافت الستينيين: أهواء المثقف ومخاطر السياسة"، وهو الذي سبق أن وضع توقيعه إلى جانب فاضل العزاوي وسامي مهدي على "البيان الشعري" لجيل الستينات الذي كتبه الأول، لم ينجُ في الواقع من تلك الأهواء والمخاطر التي قادته إلى جذرية في المواقف إزاء التحولات السياسية عندما وضع توقيعه في مكان آخر لاحقاً! إذ رأى في نقده الذي قارب التهكم من تغني سامي مهدي بالجماليات القومية، في كتابه "الموجة الصاخبة" مقابل حماسة فاضل العزاوي لحركات التحرر في العالم، والنزعة الكونية لجيل الستينات في كتابه "الروح الحية" رأى أنَّ السياسة "تمتص المواهب الكبيرة" لكن السياسة ليست مجرَّدَ انصياع إلى يقين الخيار عبر الانتماء الحزبي، ولكنها تشمل كذلك مواقف وخيارات وتفاعلات إزاء ما يحدث من حولنا عن قرب او في العالم عن بعد، أو حتى في التاريخ العام.
وفي "ثياب الإمبراطور: الشعر ومرايا الحداثة الخادعة" لم تبُدُ مرآته الذاتية صافية بما يكفي لعكس صورة واحدة للشاعر والمثقف بل حتى بين رؤيته النقدية وتاريخ تجربته الشعرية، اتنقد ما سماه الحداثة المتطرفة على صعيد التجريب اللغوي والشكلي، وعبَّر عن موقف مضادٍ لقصيدة النثر. ولعل شغفه العالي بالموسيقى الذي دعاه إلى تأليف كتاب "فضائل الموسيقى" جعل موقفه يتسم بتلك الجذرية، وهو ما تبناه في مجلته "اللحظة الشعرية" التي أصدرها في لندن في التسعينات.
حين قرأت "ثياب الامبراطور" استذكرتُ ديوان فوزي كريم "قارات الأوبئة" بوصفه نموذجاً يعبر عن عمق المأزق والقلق الداخلي في تجربة الشاعر المحافظ! فهو عمل شعري يبدو غريباً عن مجمل تجربته، ويتناقض مع موقفه الجذري ذاك. كان "قارات الأوبئة" كناية عن نشيد طويل مقسم إلى فصول، يتخلى عن الإيقاع، والتقفية والجمل القصيرة المعهودة، في تجربته منذ ديوانه الأول "حيث تبدأ الأشياء" ليعاودها في تداخل بين الشعر النثر لينطلق نحو تدفق شعري حرِّ، حر على مستوى الأداء وعلى مستوى الاستجابة لإغواء التأليف والبيان وغرابة الصور التي عاد وأسقطها على من انتقدهم من شعراء بوصفهم "شعراء صنعة بلاغية"، وهي مدرسة ليست غريبة أو طارئة في تاريخ الشعر العربي منذ العصر العباسي، وأطلق عليها النقاد العرب اسم البديع، لكنه رأى أن هذا النمط من الشعر خالٍ من أية تجربة روحية بل لا يعدو كونه تأليفاً. ولا ينطوي على دلالة خارج البلاغة الزخرفية. فانتقد شعر أبي تمام بوصفه مغلقاً ومنكفئاً إلى الداخل حيث الذخيرة البلاغية، والانهمام بالصنعة والتكلف، وصولاً إلى ما سماه "مطحنة أدونيس اللغوية" وانتهاءً إلى التجارب الجديدة في الشعر العربي، لكنه اعتنى بالمقابل بترجمة الشاعر الإيطالي كواسيمودو بما يعكس جانباً آخر من القلق وربما التنافر بين شعره ونظريته النقدية فشعر كواسيمودو زاخر بالمجازات والاستعارات والتشبيهات المتناسلة ويمثل إلى جانب مونتالي وأونغاريتي مثلث الشعر "الهرمسي" في إيطاليا وأوربا عموماً، وشعرهم يتسم بالبحث الدائم عن لغة فريدة سعوا عبرها للانفصال عما كان سائداً في الشعر الإيطالي، فبدت نصوصهم أقرب إلى الدلالات التشعبية في الشعر الفرنسي خاصة لدى مالارميه. ولا شك أن فوزي كريم كان واعياً لذلك التناقض في نظريته الشعرية فحاول في تقديمه التركيز على انحيازه لما ينطوي عليه شعر كواسيمودو من غنائية وإيقاعية لا يمكن ظهورها في الترجمة!
وهكذا، فهو حينَ يأخذ على التجريب في الحداثة خلوها من الروح إنما يقدم في الخلاصة فهماً ذهنياً، لا روحياً للحداثة. ويستعيد على العموم جدلاً قديماً في النقد العربي، منذ ثنائية الشعر: "المطبوع والمصنوع" التي أطلقها ابن رشيق في كتابه "العمدة" التي صنَّف فيها شعر كل من أبي تمام وأبي نواس وبشار وابن المعتز ومسلم بن الوليد وسواهم على أنه شعر صنعة وديباجة، تلك الثنائية التي ستبدو تعسفية أذ ما جرى النظر لها بوصفها اختلافاً حتمياً، أو معياراً داخلياً للشعر، بينما تنطوي في جوهرها على ما ينعكس ائتلافاً في تجربة شعرية واحدة. شأن تجربة فوزي كريم نفسها التي طاولتها "أوبئة القارات"، على رغم أنها ظلت أمينة بشكل عام على تقاليد شعر الرواد، السياب والبياتي، وهو وإن أبدى عناية نقدية بشعر السياب، إلا أن تأثيرات قصيدة البياتي في البناء المقطعي القصير والمحكم بدت أكثر وضوحاً في شعره.
كان فوزي كريم ينتمي فعلاً إلى تلك "الروح" الستينية وإلى "صخب الموجة السياسي" على رغم محاولته النظرية لإثبات "التهافت"، فقد طاولته "أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي". وشاعر الدَّعة والرقَّة والخلوة، الذي عنون ديوانه الثاني "أرفع يدي احتجاجاً" وقع فريسة الحماسة المتطرفة للمشروع الأمريكي في العراق-هكذا كان يسمِّيه- مذكراً بالتجارب الكولونيالية الناجحة، في الإعمار، لا الاستعمار، ولكن كما ترى يا فوزي هي أرض خراب أخرى، وها قد أصبح منفاك في لندن أبدياً.
في آخر لقاء لنا في بغداد، قال بنبرة تجمع بين الزهد والأسى، وهو يرى ما آلت إليه أمور بغداد "العبَّاسية" وهي المنطقة التي ولد فيها: يبدو أن هذه البلاد لم تكن لنا في يوم من الأيام، ولن تكون، فأجبته مستعيراً عنوان إحدى مجموعاته أجل فنحن "لا نرث الأرض"، لكن أمريكا أيضاً لم تكن تريدُ النفط من غزو العراق!