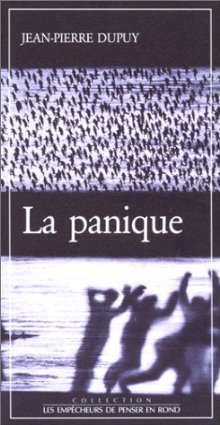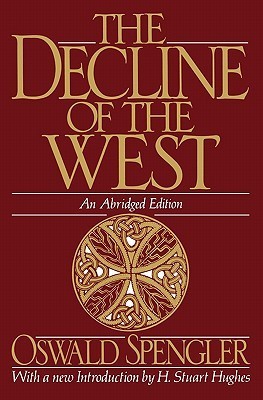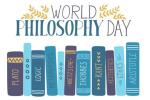تختتم البشرية عاماً منقضياً أفرج عن جميع أسراره، لكنه لم يبح بكل تداعياته الكورونية والبيئية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجيوسياسية. وتستقبل عاماً مقبلاً لا تقوى على استجلاء سماته وخصائصه واستطلاع تحدياته وإشكالاته وصعوباته. يجدر بنا عند هذا المنعطف أن نستذكر تصورات الفيلسوف الألماني أوسڤالد شبنلغر (1880-1936) التي استودعها كتابه الشهير "أفول الغرب" (Der Untergang des Abendlandes) الذي نحتفل بمئويته الأولى، إذ إنه أنهى إنشاء قسمه الثاني في العام 1922. كان متأثراً بتشاؤمية نيتشه، وبتطورية داروين التي كان يدافع عنها في ألمانيا عالم البيولوجيا والفيلسوف الألماني إرنست هكل (1834-1919). ومن ثم، انطوت كتاباته، لا سيما "الإنسان والتقنية" (Der Mensch und die Technik)، على تصور تحذيري يستبق مآلات البشرية المتمادية في هدم إنسانيتها.
احتمال انعقاد الشروط الأساسية
اعتمد شبنغلر في كتابه "أفول الغرب" منهج غوته (1749-1832) المورفولوجي الذي استخدمه الأديب الألماني لكي يتحرى عن تطور الأشكال الطبيعية. لذلك جاء عنوان الكتاب الفرعي (تصميم ملامح مورفولوجيا تاريخ العالم) يفصح عن مقاصد شبنغلر في تقصي أشكال التاريخ البشري وهيئات الحضارات الإنسانية. فإذا به يعارض الثقافة بالحضارة، إذ تدل الأولى على عظمة الإبداع الفكري في حياة الأمة، في حين أن الثانية تنطوي على دلالات الانحطاط والانهيار والانحلال. ومن ثم، كان شديد الحرص على استخراج سمات الثقافة الجرمانية يعاينها في قيم الواجب والنظام والشرعية، ويقارنها بقيم الحضارة الغربية الساقطة المتجلية في الحرية والمساواة والأخوة. أما يقينه الفكري السياسي فكان يملي عليه أن يرفض الاتجاهين المتطرفين المتواجهين: الماركسية والليبراليا البرلمانية، ويعتمد الاشتراكية القومية الألمانية المحافظة المبنية على المؤالفة بين النظام الملكي وقواعد الاقتصاد الموجه.
في اختتام العام المنقضي وافتتاح العام المقبل لا بد للإنسانية من أن تكب على التفكر في مصائر الأرض والبيئة والحياة والإنسان، من غير المغامرة القصوى في استشراف أفول الغرب والشرق. غير أن أفظع ما يرعب الناس إنما يعتلن في صور الفناء المرتسمة في أفق الزمن القريب، وذلك من بعد أن أيقن الجميع أن الكوارث الطبيعية المفتعلة وغير المفتعلة، والحروب الإبادية المشتعلة والقابلة الاشتعال، والجوائح الفيروسية المصطنعة وغير المطصنعة، أخطار وشيكة الحدوث تهدد الجنس البشري برمته. يحاول المهندس البوليتكنيكي وفيلسوف العلوم الفرنسي جان-بيار دبوي (1941-....) أن يستطلع أصناف الأخطار التي تتهدد الطبيعة والحياة والإنسان، فإذا به في كتاب "الهلع" (La panique) يحلل ظاهرة الرعب الأعظم الذي ينتاب الناس في قرائن سقوط القيم الإنسانية الهادية، وفي كتاب "من أجل كارثانية مستنيرة: عندما يصبح المستحيل أكيداً" (Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible devient certain)، يبين كيف أن البشرية تستطيع أن تفني نفسها كل سنة حين تقرر أن تستخدم أسلحة الدمار النووي، أو حين تهلك البيئة وتعدم شروط الحياة من جراء إسرافها في استنزاف موارد الأرض الطبيعية وينابيع المياه السليمة وطاقات الهواء النقي. أما في كتابه الأخير "الكارثة أو الحياة: خواطر في زمن الجائحة" (La catastrophe ou la vie. Pensées par temps de pandémie) الصادر في العام 2021، فإنه يستشيط غضباً على المثقفين المعاصرين الذين يسخفون الوباء الكوروني ويستخفون بأخطاره الداهمة، ومنهم الفيلسوف الفرنسي أندره كونت سبونڤيل (1952-....) الذي يشكك في الظاهرة الوبائية كلها.
ومن ثم، فإن دبوي ينتقد انتقاداً لاذعاً الحكومات الغربية التي تتخبط تخبطاً مخزياً يجعلها تناصر الخيارات العلمية المتشنجة التي تستميت في الدفاع عن مقام الاقتصاد والإنتاج، وتهمل الناس وترهبهم وتحبس على حرياتهم، وحجتها في ذلك كله أنها تروم صون الحياة الإنسانية، في حين أن من أبسط قواعد التضامن الأخلاقي الاعتناء بصحة الناس في المجتمعات الفقيرة، ومساعدتهم في الحصول على اللقاحات الضرورية والعلاجات الملائمة.
هل الإنسان صاحب القرار في استنقاذ الأرض؟
لا شك في أن مصير الإنسانية مرتبط بأمرين لا ثالث لهما: حكمة الإنسان في تدبر شؤون الأرض والفضاء القريب، ومصادفات الانفجارات الفضائية والالتحامات الكوكبية والاختراقات النيزكية والجوائح الوبائية الإبادية. ليس لي القدرة الراغبة في الترصد الفلكي والتكهن الاستنبائي. يبقى أمامي الاعتصام بحكمة الإنسان على إشكاليتها المستعصية، غير أن المسألة ترتبط بما يعاينه الكائن العاقل هذا في صميم جوهره. قل لي كيف تعرف ذاتك، أخبرك بطبيعة قراراتك، وسمة أفعالك، ومصير وجودك كله! والحال أن الإنسان ما إن وعى ذاته وعياً تفكريا ناضجاً حتى أدرك ضرورة البحث عن ماهيته.
كان الفلاسفة الإغريق يسلمون بانتماء الإنسان إلى الكون الأرحب (الكوسموس)، فلم يسائلوا إنسانية الإنسان في عمق فرادتها. ذلك بأن الاستفسار عن الماهية الإنسانية كان غريباً عن فضائهم الفكري، إذ إن الإنسان كان في نظرهم الحيوان الأوثق التحاماً بالكون والأشد ملاءمة له، ومن ثم فإن تصورهم الأنثروبولوجي وثيق الاقتران بالتصور الكوسمولوجي الأوسع. لذلك ما كان يفطنون لما هو إنساني في الإنسان، بل كانوا يبحثون عما فيه من بذار إلهية أو عناصر إنسانية، فيكبون بالأحرى على تهذيب المسلك الحياتي، وضبط أهواء النفس، وتدبر المعية الاجتماعية.
الاختلاف في تعيين جوهر الإنسان
أعود إلى السؤال عن جوهر الإنسانية في الإنسان، إذ إنه السؤال الذي يحدد مصير البشرية في قرائن الوجود التاريخي الراهن. فما الذي نعتبره في الإنسان بمنزلة الجوهر والعمق والصميم؟ ما الإنساني المحض في الإنسان؟ جرت العادة على استخراج ضمة من العناصر والمكونات والثوابت، منها الحرية والعقل والوعي واللغة والوصالية بين الذوات. بيد أن مثل هذه المحددات تنطوي أيضاً على أبعاد أخلاقية تجعل الإنسان في موضع المساءلة، لا بل الاتهام الذي يكشف عن مسؤولياته الخطرة في رعاية شؤون الوجود. ها هي ذي الأديان التوحيدية ترسم في الكائن الإنساني صورة آدم العبد المفروز لخدمة الإنسانية (اليهودية)، أو الابن المنتدب لوراثة وديعة الكون (المسيحية)، أو الخليفة المصطفى من أجل صون الشريعة الإلهية (الإسلام). أما شرعة حقوق الإنسان، فتتصوره صانعاً ماهيته التاريخية، يستخرج أصول الحياة من صميم الكرامة التي انعقد عليه كيانه الواعي، فتعهد إليه بواجب إدارة الحياة بالفطنة والاعتدال والإنصاف.
لا غرابة، والحال هذه، من أن ينتصب الإنسان الحديث في وسط الكون كائناً مقتدراً، مخططاً، مدبراً، مستشرفاً. يتعزز مثل المقام المركزي هذا على قدر ما يعمد الفكر الأنثروبولوجي المعاصر، في مصادره المتافيزيائية والأخلاقية والبسيكولوجية، إلى افتراض الانعطابية والانجراحية والخطائية الإثمية في صميم الكيان الإنساني، ومن ثم فإن جميع التصورات تتناصر على دعم هذه الافتراض سواء في مقولة الخطيئة (الأديان التوحيدية)، أو في مقولة الشر الجذري (كانط)، أو في مقولة قتل الأب (فرويد)، أو حتى في مقولة الجرم القانوني الذي يقصي الضعفاء والمرذولين والأقليات المنبوذة (فكر شريعة حقوق الإنسان). وعليه، فإن مسعى الفكر الفلسفي الذي يروم تجاوز هذه الحداثة إنما ينحو منحى الانعتاق من مثل الاستذناب الإثمي هذا، فالناس لا يريدون اليوم أن يشعروا بذنب المسؤولية الكونية الخطرة. بليغة العبارة التي لخص بها جيل دلوز في كتابه "نيتشه والفلسفة" (1962) المأزق الأنثروبولوجي الذي أفضى إليه استذناب الإنسان: "ليس الحقد والضمير السيئ والعدمية سمات في علم النفس، بل إنها بمنزلة أساس الإنسانية في الإنسان. إنها مبدأ الكينونة الإنسانية بما هي عليه".
ذهنية الاستذناب والتجريم
إذا كان الأمر على هذا النحو، كان علينا أن نسأل: هل يليق أن نستذنب الإنسان ونجرمه ونحكم عليه حتى يدرك خطورة مسؤوليته؟ أم ينبغي لنا أن نحرره من عقدة الخطيئة حتى يتدبر الكون والوجود والحياة بوعيه المعافى وحريته المبدعة وحسه الأخلاقي المتطلب؟ إذا حررنا الإنسان من تهمة الانحراف، فإننا نضعه في موضع المسؤولية الأخطر التي تستوجب وعياً فائقاً، وإدراكاً صائباً، وعزماً شريفاً. يحضرني هنا ما ساقه الفيلسوف الألماني هايدغر في تقريع الذات الإنسانية الحديثة التي استباحت الكينونة والكائنات والوجود والموجودات، فجعلت الإنسان رأس الهرم الكوني وسلطته على مصائر الطبيعة، منذ أن استقر في وعي الناس أنه "سيد الطبيعة ومالكها" (دكارت). ذلك بأن العلوم والتقنيات الحديثة نجحت في تحقيق حلم الذات الدكارتية المركزية المهيمنة، بحيث إن الإنسان أضحى يتغنى بقدراته الفائقة في تغيير طبائع الكائنات والموجودات والأشياء، مستهلا التحولات الخطرة باستبدالات عضوية بيولوجية قد تفضي به إلى استنبات كائن إنساني مختلف القوام والهيئة والوعي.
لا ريب في أن الأنا الدكارتية المفرطة في هيمنتها استولدت تصورات أنتروبولوجية سوغت نشوء جواهر ذاتية ترسم ماهية الإنسان، سواء في الجوهر المونادي المتوحد (لايبنيتس)، أو في الأنا اللامتناهية (فيشته)، أو في الروح المطلق (هيغل)، أو في الإنسان الأعلى (نيتشه) الذي يصر على هدم جميع القيم وابتكار قيم أخرى تمجد الذات الإنسانية الحرة المتفوقة. يعاين هايدغر في التعريفات الأنثروبولوجية هذه آثار التصور المتافيزيائي الذي يقيم الإنسان في مقام المرجعية المطلقة الآمرة الناهية ويهمل النظر في أصل الأصول، عنيت به الكينونة الأرحب. والحال أن التحول الذي ينبغي الانخراط فيه من الآن فصاعداً يتطلب إزاحة الإنسان عن عرشه وإخضاعه لمشيئة هذه الكينونة التي تتجلى على خفر عظيم في الكائنات والموجودات والأشياء. وحدها الكينونة، في سر انبساطها، تستطيع أن تلهم الإنسان سبيل صون الأرض والطبيعة والحياة والكون، إذ تعهد إليه بمسؤولية الرعاية الفطنة. ليس الإنسان سيد الكينونة، بل راعيها الوديع المتضع.
مسؤولية الحكمة الفلسفية
لا بد، والحال هذه، من مساءلة الوظيفة الكيانية الجديدة التي استودعها هايدغر الإنسان المعاصر، ولكن من غير أن يحدد له كيفيات استخدامها وإنجازها وتطبيقها. كيف يرعى الإنسان المنعتق من مطامح الهيمنة الكينونة التي تنتظر منه أن يصون خصوصيتها ويحافظ على حيويتها الخاصة؟ وكيف يمكن الإنسان أن يتخلى عن مشاريعه العلمية والتقنية والإبداعية لكي يسلك في مسالك التأمل الصبور والسكينة المترقبة، على حد ما يشير إليه هايدغر في كتاباته الأخيرة؟ إذا كانت الكينونة سر الكائنات وعمق الموجودات ومنفسح الأشياء وباعثة الوقائع ومرشدة الأحداث ومستثيرة الأفكار، كان على الإنسان أن يخشع خشوع التقوى والإنصات ويصغي إلى نداءاتها. يبدو أن صورة الإنسان الجديد في فكر هايدغر الأنطولوجي تحرره من أثقال الذنب والخطيئة، ولكنها تجرده من مسؤوليات القرار العقلاني العازم، إذ تحيل كل المراسيم الحاسمة في الوجود على مشيئة الكينونة عينها.
ليس يفيدنا، في مطلع العام الجديد، أن نحقر الإنسان أو أن نمجده، إذ إنه كائن التوسط والترجح والتذبذب بين الحكمة والضلال، بحسب عبارة الفيلسوف الفرنسي الشهير بسكال (1623-1662): "من يبر بر الملائكة، يأثم إثم الشياطين" (Qui fait l’ange, fait la bête). وعليه، تتعادل اليوم، كما في كل عصر من عصور الإنسانية، مقادير التفاؤل والتشاؤم، وتتكافأ احتمالات النهوض والسقوط، وتتآلف مقاصد الخير ونيات الشر في الشخص عينه، وفي الوضع نفسه، وفي التصميم ذاته. كما أنه لا يجوز لنا أن نجرد الإنسان من كل قرار مصيري، وحجتنا في ذلك أنه تجبر واستعلى وطغا فانتهك الطبيعة وأذل الكائنات وأخضع الكينونة لسلطانه العقلاني الخانق، كذلك لا يليق بنا أن نطلق العنان للعقل العلمي التقني الانتفاعي، وأن نستسلم لمشيئة الاقتدار الذاتي التي لا تراعي موازين الحياة الدقيقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لست من الذين يستحسنون الإنذاريات التشاؤمية واستنباءات الفناء الكوني الوشيك. ولكن ترعبني الهوة المتعاظمة بين التقدم العلمي التقني الراهن، والتقهقر المعنوي الأخلاقي في مسلك الإنسانية جمعاء. من المحزن كذلك أن يعاين المرء المسافة المرضية بين النبوغ العلمي والفكري والتقني في حياة الأفراد، وسذاجة الاقتناعات الإيديولوجية الذاتية التي تفضي بهم غالباً إلى قرارات واختيارات ومبايعات عنفية معيبة لا تليق بكرامة الكائن الإنساني فرداً وجماعة، لا سيما في حقول التصرف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والبيئي. قد يغرينا اليوم أن نسترسل في أدبيات الاضطراب الكوني والاختلال البيولوجي الكوروني، غير أن الفوضى النازلة بنا لا تنطوي موضوعيا على احتمالات الفناء القريب. لن يفنى الإنسان في المنظور الزمني القريب، ولكني موقن أنه سيتبدل بيولوجيا، لا سيما حين ينجح العلماء في استيطان كوكب المريخ أو أي كوكب آخر، من غير رجعة ممكنة إلى الأرض.
وعليه فإن السؤال الأخطر ينشأ من معاناة الأرض والحياة والبيئة في زمننا الحاضر: ما الأصول والمبادئ والقيم التي ينبغي أن نعتنقها حتى نجعل الأنظمة السياسية والاقتصادية والمصرفية، والمختبرات العلمية والتقنية، ومنتديات الأوليغارشيا العالمية النخبوية تدرك أن تعاقب السنين على حياة الإنسان في قرائن المشاحنات الأيديولوجية المتفاقمة سوف يجر على الإنسانية أوخم الآثار المدمرة؟ في الوقت عينه، لا بد لنا من التأمل في مسيرة الوعي الإنساني الأرحب حتى نستطيع أن نعتصم ببعض من الرجاء الخلاصي الفطن، مستلهمين قولة الشاعر الألماني هولدرلين، "حيث الخطر، هناك ينمو الإنقاذي أيضاً" (Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch). لذلك قد تنقلب الكارثة (désastre) بهاءً خلاصياً يتلألأ في تواطؤ نجوم (des astres) الانفراج الكوني الذي يسعف الوعي الإنساني ويرشده إلى سواء السبيل. على الرجاء الفلسفي هذا، نستقبل العام الجديد ونسكب فيه أبهى مقاصدنا الطيبة.