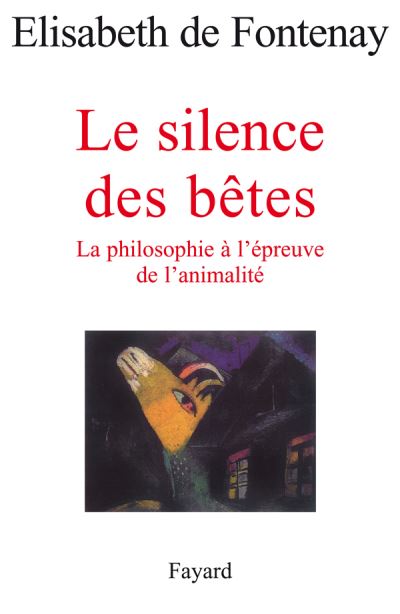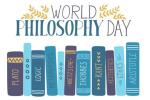الإنسان كائنٌ تطوَّر، فعقَل ووعى وأدرك، وبدَّل تبديلاً جليلاً في وعيه، في حين أنّ الحيوان كائنٌ حيوانيٌّ ما فتئ على حاله منذ مئات آلاف السنين، عاجزاً عن اختبار ما يختبره الكائن الذي انتصب إنسانَ الوعي والفكر والحرّيّة والمسؤوليّة والقرار. حار العلماء في نسبة الواحد بالمئة التي تفصل بين الإنسان والشَّنمبازِه: أفيكون المقدار النسبيّ هذا موضعَ الفرادة الإنسانيّة المطلقة؟ وكيف يمكن الانتقال من المشترك العريض الواسع إلى الحيّز الفريد الضيّق من غير أن يعترف المرءُ بأنّ الإنسان ينطوي على حيوانيّةٍ راسخةٍ في كيانه وبأنّ الحيوان يحمل شبهَ إنسانيّةٍ ناشبةٍ في قوامه البيولوجيّ؟
يتأثّر التصوّر الثقافيّ السائد في معظم المجتمعات الإنسانيّة بنصوص الأديان التوحيديّة التي تجعل الإنسان سيّدَ الطبيعة والمخلوقات والكائنات والحيوانات والموجودات والأشياء. في سفر التكوين تظهر ظهوراً جليّاً صدارةُ الإنسان على الحيوان: "وقال الله: لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا وليتسلّط على سمك البحر وطير السماء والبهائم وجميع الأرض وكلّ الدبّابات الدابّة على الأرض" (الفصل الأوّل، الآية 26). منذ ذلك الحين، دأب الإنسان التوحيديّ على إخضاع الطبيعة وكائناتها لسلطانه العقليّ والعلميّ والتقنيّ القاهر. لذلك كان عالم البيولوجيا والباليونتولوجيا الفيلسوف البريطانيّ توماس هاكسلي (1825-1895) يردّد أمام صديقه داروين أنّه من أشدّ المقتنعين بالهوّة العميقة التي تفصل بين الإنسان العاقل المتحضّر، والبهيمة الحمقاء الهوجاء الرعناء.
الحياة المشتركة والقربى المعيشيّة بين الإنسان والحيوان
تجتهد الفيلسوفة الفرنسيّة إليزابِت دُفونتُونِه (1934-....) في تصوّر المجالات الحيويّة المشتركة بين الإنسان والحيوان. في كتابها "صمت الحيوانات" (Le silence des bêtes) تُبيّن أنّ العقل ينبغي أن يتجاوز الصراع المصطنع بين المذهب الثنائيّ الذي يرسم الحدود الفاصلة بين الطرفَين، والمذهب الاتّصاليّ الذي يعترف بقدرٍ عظيمٍ من التشاركيّة بينهما. تذهب دُفونتُونِه إلى أنّ القطيعة مفتعلة، إذ إنّ الحيوانيّة في مقامها الأصليّ تسائلنا وتكشف لنا عن انعطابيّتنا وانجراحيّتنا. أمّا الذي يميّز الإنسان من الحيوان، فليس الذكاء بحدّ ذاته، بل الكلام وقدرة الإنسان على تغيير الاجتماع بواسطة الخطاب المقنع. ذلك بأنّ الثديّيات الأوَل التي تشتمل على الليموريّات والقرديّات والبشريّات استطاعت أن تنتظم في اجتماعٍ بدائيٍّ يفصل الذكور عن الإناث، ويستعين بأصنافٍ شتّى من الحيَل والمواربات والتدابير الفطنة من أجل صون السلم والوئام في حضن القبيلة. غير أنّ القرود شبه الإنسانيّة انحصرت في مقامٍ واحدٍ لم تستطع أن تتجاوزه حتّى تغيّر في تصوّراتها ومسالكها وتصرّفاتها. لذلك نشأ الاختلاف الخطير بين الفئتَين، إذ إنّ الحيوانات، مهما دنت من المقام الإنسانيّ، لا تستطيع أن تعي ذاتها، وتُفصح عن هذا الوعي، وتكتب تاريخها، وتتحرّى عن تطوّر مداركها.
ومن ثمّ، فإنّ التطوّر الإنسانيّ لا يقوم على منطق تاريخ الكائنات الحيّة الطبيعيّ فحسب، بل يتحدّد بواسطة استساغة المكتسبات الثقافيّة المتوارثة من جيلٍ إلى آخر. أمّا الاستنساخ الذي أصاب الحيوانات (النعجة دولّي)، فإنّه يستثير انعطافاً جليلاً في تاريخ التطوّر البشريّ. ذلك بأنّ الهندسات البيولوجيّة ستُفضي عاجلاً أم آجلاً إلى تغيير وجه الإنسان وبنيته وقوامه وهيئته ومداركه. ولسنا ندرك اليوم المآلات المنقطعة النظير التي سنُقبل إليها في العقود القريبة الآتية.
أخلاقيّات الاستثمار الإنسانيّ الانتفاعيّ
ومن ثمّ، ينبغي المطالبة ببعض الحقوق الأساسيّة لفئاتٍ من الحيوانات تشمل الثديّيات والفقريّات (الشَّنمبازِه، الغوريلّا، الأورَن-أوتَن، البونوبو...). إنّها كائناتٌ تستحقّ الاحترام، إذ إنّها تجسّد في وعينا ذروة الغيريّة التي نواجهها في فضائنا اليوميّ، فتتجاوز في فرادتها غيريّة الآخر الإنسانيّ من بين نظرائنا الأقربين. في هذا السياق، تواجهنا مشكلة الحقّ في الحياة، لاسيّما حين نعاين أغلب الناس يقتاتون باللحوم الحيوانيّة. فهل يجب الاستغناء عن اللحوم في النظام الغذائيّ الصحّيّ؟ كثيرةٌ هي المنظّماتُ التي توصي باجتناب هذه اللحوم من أجل الحفاظ على سلامة الجسم البشريّ. من الواضح أنّ المناقشة تدخل هنا نطاق التصوّرات الوجوديّة الأساسيّة التي ينعقد عليها وعيُ الأفراد والجماعات الثقافيّ.
منذ أقدم العصور يحيا الناس في قربى وثيقة من الحيوانات حتّى إنّ التشارك تخطّى مستوى الفيروسات المنتقلة بين الإنسان والحيوان ليصيب عمق المشاعر المتبادلة. أمّا الاستعانة الطبّيّة بالأعضاء الحيوانيّة، فأضحت السبيل الأقرب إلى معالجة أسقام الإنسانيّة. في بعض الأحيان، يعتقد العلماء أنّ الاستنساخ ينبغي أن يبدأ عند الحيوان قبل أن ينتقل إلى الإنسان، إذ إنّ التجارب المفتعلة في الحيوان أقلُّ ضرراً من تلك التي تجري على جسم الإنسان.
من الثابت، في هذا السياق، أنّ تعاضد الأبحاث في علوم الأحياء والحيوان والباليونتولوجيا (علم الإحاثة) والأركيولوجيا (علم الآثار القديمة) والأعراف الأخلاقيّة والمسلكيّة أفضى إلى الاعتراف بالتشاركيّة العظمى بين عالم الإنسان وعالم الحيوان. ومن ثمّ، فإنّ النظريّة العلميّة الجديدة المسمّاة "نظريّة التطوّر الائتلافيّة" تثبت حقيقة الترافق الاتّصاليّ بين المجموعتَين. أمّا افتراض الهندسة الذكيّة في أصل الكون، فمسألة فيها نظرٌ، إذ إنّ العلماء، بحسب دُفونتُونِه، لا يستطيعون أن ينكروا رحابة التنوّع الذي نشأ عليه الكون، والتباس المقاصد التي ينطوي عليها تطوّرُ الكائنات.
كان جان-جاك روسو يعتقد أنّ الأبحاث العلميّة المقبلة ستُظهر أنّ قردة الشَّنمبازِه ربّما كانت من جنس الإنسان، وقد انتظمت في هيئات مختلفة. غير أنّنا بتنا اليوم نعاين مهارات القردة في مناطق شتّى من العالم، لاسيّما في أفريقيا حيث أنثى الأورَن-أوتَن تحيك حياكة العقَد البسيطة المتكرّرة، وشَنمبازِه الكونغو يرسم شبكات العنكبوت، وشَنمبازِه التاي المتوحّش يمارس نهجاً في الصيد غريب الأطوار لا يجاريه أيُّ حيوان آخر فيه، والبونوبو كانزي ينطق نطقاً بدائيّاً يُذهل العلماء.
حقوق الإنسان وحقوق الحيوان
لا شكّ في أنّ القول بالتشاركيّة بين الإنسان والحيوان يضطرّنا إلى استثارة مسألة الحقوق الحيوانيّة. على وجه العموم، ليس للحيوان من حقوق، بخلاف الأشخاص والأشياء. والحال أنّه كائنٌ يحيا وينفعل ويحسّ ويشارك الإنسان في بعض أفعاله البسيطة. يُصرّ الفيلسوف الأمِريكيّ توماس رِغان (1938-2107) على منح الحيوان ضمّةً من الحقوق، لاسيّما في حال الثديّيات، ابتداءً من انقضاء السنة الأولى. في كتابه "قضيّة حقوق الحيوان" (1984)، ينادي بضرورة الاجتهاد في تشريعٍ يصون حقوق الحيوان، من غير أن يجعل الحيوان كائناً حقوقيّاً. ولكنّه يعترف بأنّ هذا الكائن لا يمكنه إلّا أن يكون ذاتاً أخلاقيّةً منفعلةً وحسب. السبب في ذلك أنّه يستطيع أن يتمتّع ببعض الحقوق، في حين أنّه يعجز عن أن يضطلع اضطلاعَ الكائن الفاعل بأيّ ضربٍ من ضروب الواجب، على نحو ما يصنع الإنسان العاقل المسؤول. لذلك لا مسؤوليّة قانونيّة على الحيوان مطلقاً. أمّا هذه الحقوق، فتشبه شبهاً كبيراً حقوق الكائنات العاقلة العاجزة كالأطفال والشيوخ المسنّين والمرضى النفسيّين والمعوّقين.
وعليه، يمكن القول إنّ توماس رِغان ينتمي إلى مذهب كانط الأخلاقيّ، ويعارض المذهب الإحساسيّ النفعيّ الذي يدافع عنه الفيلسوف الأوستراليّ بِتِر سينجِر (1946-....). إلّا أنّه يخالف كانط الذي يُصرّ على احترام الكائنات العاقلة وحسب. فيبيّن أنّنا نحترم هؤلاء الأشخاص الذين إمّا لم يبلغوا مرحلة النضج العقليّ كالأطفال والمعوّقين، وإمّا فقدوا الأهليّة العقليّة كالمسنّين الغارقين في خرف الشيخوخة. ومن ثمّ، فإنّه يبيّن أنّ المشترك الأغلب السائد بين الكائنات العاقلة ليس العقلانيّة الذكائيّة القادرة على حلّ أعسر المعادلات الرياضيّة، أو العقلانيّة الأخلاقيّة المسؤولة عن القرارات الوجوديّة، بل أمران جوهريّان: انعقادُ حياةِ كلِّ كائنٍ إنسانيٍّ على حياةٍ خاصّةٍ تَعنيه وتهمّه وتُقلقه، وانفطارُ كلِّ وجودٍ إنسانيٍّ على الاعتناء الفريد بالحياة الشخصيّة الذاتيّة. ومن ثمّ، فإنّ ما يحدث في حياتنا يَعنينا على وجه الإطلاق، سواءٌ أثار هذا الحدث اهتمام الآخرين أو لم يُثره. ذلك بأنّ المشترك الإنسانيّ يتجلّى في انفطار الكائن الإنسانيّ على ذاتيّةٍ تجعله صاحبَ قوامٍ حياتيٍّ خاصّ. إذا كان القوام الحياتيّ الخاصّ هذا معياراً حاسماً في إثبات قيمة الإنسان، صاحبِ الحقوق الأخلاقيّة الأساسيّة، فإنّ كلَّ صاحبِ قوامٍ حياتيٍّ خاصًّ يتمتّع بالحقوق الأساسيّة عينها هذه، سواء انتمى إلى الجنس البشريّ أو إلى الجنس الحيوانيّ.
أمّا الفيلسوف الأوستراليّ بيتِر سينجِر، فإنّه يعارض تصنيف الكائنات الحيّة وفاقاً لانتمائها إلى هذا الجنس أو ذاك. اعتقاده الراسخ هو أنّ هذا الانتماء لا يمنح بحدّ ذاته الصدارة الكيانية والحقوق التفضيليّة. في كتابه "تحرير الحيوان"، يبيّن أنّ الإحساس هو المعيار الملائم الذي يؤهّل الكائنات للانتماء الشرعيّ إلى المجال الأخلاقيّ. ذلك بأنّ الكائنات التي تحسّ وتتفاعل تفاعلاً مبنيّاً على مشاعرها الذاتيّة ينبغي أن تتساوى في الحقوق الأخلاقيّة، أي أن تُصان مصالحُها صوناً عادلاً.
الاختلاف في رسم الحدود بين الطبيعة والثقافة
لا ريب في أنّ مسألة حقوق الحيوان تطرح علينا إشكاليّة رسم الحدود الفاصلة بين الطبيعة والثقافة. أبان عالم الأنتروبولوجيا والفيلسوف الفرنسيّ فيليب دِسكولا (1949-....) أنّ التمييز الذي ينشئه الفكر الغربيّ بين الإنسان والحيوان ليس سليم التسويغ، متين الحجّة. ينطوي كتابه "في الجانب الآخر من الطبيعة والثقافة" (Par-delà nature et culture) على رؤيةٍ تنسلك في سياق تطوير أبحاث أستاذه كلود-لِڤي ستروس الأنتروبولوجيّة. لذلك نراه يحرّض الجميع على تجاوز التعارض الحادّ بين الطبيعة والثقافة، وينصحنا بتدبّر علاقتنا بالعالم المحيط وبالحيوان الذي يقيم فيه، ويضع الأسس النظريّة في سبيل أخلاقيّاتٍ جديدةٍ تضبط طرائق انخراط الإنسان في سياق الحياة المتدفّقة.
يعتبر دِسكولا أنّ العالم الذي نصفه بغير صفة الإنسانيّ إنّما يشتمل على الحيوانات والنباتات والأرواح والأشياء الطبيعيّة والمصطنعة. وهذه كلّها، بخلاف النظرة السائدة، تختزن من القصديّات اللصيقة بها ما يجعلها تستنهض الإنسان وتحثّه على إنشاء نمطٍ آخر من علاقات الاحترام والصون والرعاية. ثمّة مقاصدُ نشأت عليها هذه الكائنات غير الإنسانيّة ينبغي إلقاء البال إليها، وتدبّر معانيها، واستجلاء آفاقها، حتّى يستقيم وضع الإنسان في الكون. في هذا السياق، يذكّرنا دِسكولا بإقامته البحثيّة في منطقة الأمازون عند قبائل الأشوار المدعوّين سكّان النخيل. هناك اطّلع على التمييز الذي يعتمده هؤلاء الأشواريّون بين الكائنات الإنسانيّة والكائنات غير الإنسانيّة، إذ ينسبون إلى الحيوانات والنباتات والجوامد صنفاً من الأرواح اللطيفة التي تخترقها وتعهد إليها بمقاصدَ مقاميّةٍ تعزّز التوازن البيئيّ والكونيّ الأشمل.
ومن ثمّ، فإنّ الفصل المعرفيّ الإبّيستِمولوجيّ بين الطبيعة والثقافة يَسقط سقوطاً شرعيّاً في أنظومة التصوّرات التي يحملها وعي الأشواريّين الذين ينشئون اتّصاليّةً عضويّةً (continuum) بين الإنسان والطبيعة، مستندين إلى الخلفيّات الميتولوجيّة التي رسمت وحدة الكون، وأثبتت أنّ الطبيعة فعلٌ إنسانيٌّ اجتماعيٌّ. لذلك تتطلّب مثل الوحدة الكونيّة هذه أن ينعقد نظامٌ آخر من الأخلاقيّات يراعي انتظام العلاقات الناشطة بين جميع الكائنات الإنسانيّة والحيوانيّة والنباتيّة والجماديّة. لا بدّ إذاً من تجاوز الثنائيّة الأونطولوجيّة التي يعتمدها الغرب في الفصل بين الكائنات الإنسانيّة وغير الإنسانيّة. وعليه، يستجلي دِسكولا ضروباً أربعة من التصوّرات الأونطولوجيّة التي تختبرها المجتمعات الإنسانيّة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التصوّر الأوّل هو التصوّر الطبيعانيّ (naturalisme) الذي تعتمده المجتمعات الغربيّة وتفصل بموجبه بين الطبيعة والثقافة، إذ تمنح الإنسان القدرة على تجاوز انتظاميّة القوام الطبيعيّ وابتكار وضعيّاتٍ وبنياتٍ ومنجزاتٍ تنتصب أمام الطبيعيّات وتتفاعل وإيّاها تفاعلاً حرّاً. الثاني هو التصوّر الإحيائيّ (animisme) الذي ينسب إلى الكائنات غير الإنسانيّة من الصفات الاجتماعيّة ما يؤهّلها للانخراط في علاقة تفاعليّة بالعالم الإنسانيّ. ومع أنّ الجسديّات الظاهرة تختلف بين عالم الإنسان وعالم الحيوان، فإنّ الباطنيّات مشتركةٌ بين جميع الكائنات، الإنسانيّة وغير الإنسانيّة. الثالث هو التصوّر الطوطميّ (totémisme) الذي يدرك العلاقات الإنسانيّة بالاستناد إلى حركة الارتباطات والانقطاعات الناشطة في العالم غير الإنسانيّ. حين تتماهى القبيلة بهذا الطوطم أو بذاك، فإنّها تعتنق جسديّته الظاهرة وباطنيّته المنحجبة على حدٍّ سواء. من جرّاء ذلك كلّه، يتحوّل العالم غير الإنسانيّ إلى كتلةٍ من الرموز والدلالات والشهادات التي تُفصح عن تنوّع الواقع الإنسانيّ وغناه. أمّا الرابع، فإنّه التصوّر القياسيّ (analogisme) الذي يقطع كلَّ اتّصال بين العالمين الإنسانيّ وغير الإنسانيّ، سواءٌ على مستوى الجسديّات أو على مستوى الباطنيّات، ويعتصم بثنائيّةٍ متماديةٍ مسرفةٍ تُبطل كلّ أنواع التلاقي أو التشارك أو التعاطف.
التوازن الكونيّ والتعاضد الأخلاقيّ بين الكائنات
من الضروريّ، والحال هذه، أن نتدبّر اليوم علاقتنا بالكائنات غير الإنسانيّة التي تستوطن عالمنا الواحد، وفي صدارتها الحيوانات التي يشتدّ ارتباطُنا بها على تعاقب الأزمنة. من الثابت الأنتروبولوجيّ أنّ الكلب والهرّ والحصان والعصفور والدلفين من أرقِّ الكائنات الحيوانيّة التي يأنس إليها الناسُ ويشاركونها في حياتهم ومشاعرهم وأفعالهم. ومن الثابت الحياتيّ أنّ الناس يلوذون بالحيوانات طلباً للرفق والمودّة والتشارك الصامت. لذلك يجدر بنا اليوم أن نقدر الحيوانيّة حقَّ قدرها، ولكن من غير أن ننجرف لنسقط في البهيميّة.
كان نيتشه يعلن أنّ الإنسان ليس إكليل الخليقة، إذ إنّ كلّ كائن من الكائنات التي تصاحبه في العالم يختزن مقداراً مماثلاً من الكمال. قد يكون هذا الكلام صائباً في الحقل العلميّ الذي يثبت أنّ التعقيدات العضويّة والبيولوجيّة ناشطةٌ في جميع الكائنات. أمّا السؤال الأخطر الذي يستثيره مثل التأمّل الفلسفيّ هذا، فيستفسر عن درجات الوعي الإنسانيّ والوعي الحيوانيّ والوعي الروبوتيّ الذي يتوسّط الاثنَين ويوشك أن يتجاوزهما. إذا ثبت أنّ الروبوتات حيواناتٌ آليّةٌ شبهٌ إنسانيّة خارقة الذكاء، فأيّ نوع من العلاقات التشاركيّة يمكننا أن نعقدها بيننا وبينها (أو بالأحرى بينهم!)؟ تشتدّ حدّةُ السؤال الفلسفيّ هذا حين يتّضح لنا أنّنا سائرون في ركب الهندسة الجينيّة التي تُعدّ العدّة من أجل الانعتاق من قيود الغلاف الأرضيّ، واستيطان الكواكب الأخرى في هيئاتٍ بيولوجيّة وإدراكيّة تتخطّى حدود المعقول الممكن في الزمن العلميّ الراهن.