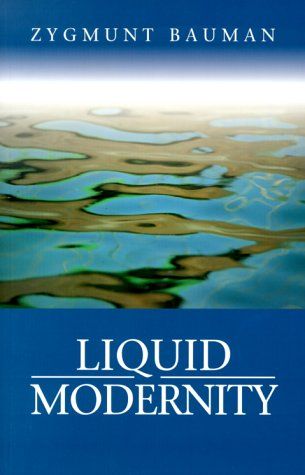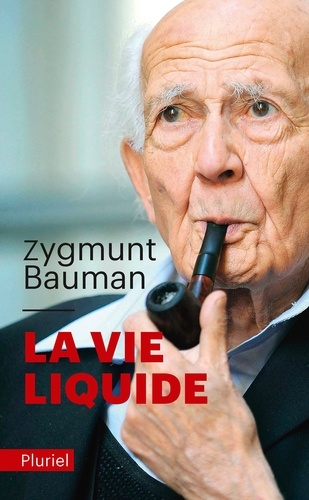استحدث عالم الاجتماع البولوني-البريطاني زيغمونت باومان (1925-2017) مفهوماً لافتاً وصف به الوضعية الثقافية الغربية بالحداثة السائلة (Liquid Modernity). في ظنه أن الاجتماع الإنساني المعاصر يختبر اليوم نوعاً من السيلان الذي يفقده معالم الطريق الثابتة ودلائل المسلك الواضحة، جاعلاً الناس في عري معياري يضطرهم على الدوام إلى التكيف ومستجدات التغيير التي تنزل بهم. خلافاً للمستندات المعرفية والأخلاقية الصلبة التي كانت المجتمعات الإنسانية تتكئ عليها من أجل بناء التصورات واستخراج الأحكام ورسم السبل، أضحت كل الحقائق والوقائع في حال السيلان الذي يفكك عرى العناصر التكوينية ويعطل صلات الالتئام الضامنة، فيسقط الوجود كله في دوامة التغير والتبدل.
مصائر زمن ما بعد الحداثة في الحداثة السائلة
باومان من مواليد مدينة بوزنان (بولندا)، درس في جامعة وارسو، وانتقل من ثم إلى تل أبيب. ولكنه ما لبث أن التحق بجامعة ليدز (بريطانيا) لتدريس علم الاجتماع والاستقرار النهائي في المدينة البريطانية. منذ عام 1998 طفق باومان يستخدم استخداماً نقدياً صريحاً اصطلاح الحداثة السائلة عوضاً عن اصطلاح ما بعد الحداثة. في رأيه أن الحداثة السائلة تعارض الحداثة الصلبة التي كانت تحتضن أشكالاً شتى من الانتظام الاجتماعي الثابت، المرسوم الحدود، المضبوط الإيقاع. أما في الحداثة السائلة، فإن الإنسان ينتمي إلى الاجتماع بواسطة فعل الاستهلاك المتفاقم، ويحدد هويته بفضل القرارات والاختيارات والإيثارات التي يبرمها. غير أنه يشعر كل يوم أن الحياة تضطره إلى تجديد هذه القرارات من جراء التحولات الجسيمة المتسارعة التي تصيب الاجتماع الإنساني، لا سيما في المجال الاقتصادي والتقني والعلمي. من خصائص الانتسابية الاجتماعية السائلة الحرية الفردية الذاتية التي تفرض على الإنسان أن يواجه مصيره وحيداً، قلقاً، حائراً، متردداً. من خصائصها أيضاً التغير المطرد المذهل، والزائلية العابرة، والاضطرابية الأمنية الوجودية، إذ إن الفرد لا يستطيع أن يضمن أمن حياته ويستقر على خطة مضمونة من خطط الوجود. ومن ثم، فإن كل فرد من أفراد المجتمع السائل هذا يوشك أن يحيا حياة منعزلة، مجردة من أي قيمة اجتماعية تضامنية، بحيث يقذف به الزمان المضطرب في لجة الارتباك الأخطر ويلقيه على قارعة التاريخ وهامش الحياة.
سقوط الحلول الفردية
يتجلى هذا السيلان على وجه الخصوص في المجتمعات الغربية التي تحتضن أفراداً يتمتعون بكامل حقوقهم الفردية، ولكنهم يحيون حياة الانعزال الذي يضطرهم إلى البحث المرهق عن حلول فردية مجتزأة يعالجون بها مشكلات جماعية بنيوية يستثيرها تعقد الاجتماع الإنساني المنبثق من الحداثة الغربية الصلبة. لا عجب، والحال هذه، من أن يعجز هؤلاء الأفراد عن ابتكار الحلول الناجعة، لا سيما في مسائل الإعضال الخطيرة التي تصيب المجتمعات المعاصرة، ومنها على سبيل المثال التلوث البيئي، والبطالة المهنية، والاعتلال الجرثومي الفيروسي. من القضايا المربكة أيضاً أن العلاقات الإنسانية، كالارتباطات العشقية، أضحت تعتريها عوارض الإهمال والنسيان والتذبذب في قرائن التحول الجسيم الذي ينتاب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
من البنية الحديثة الصلبة إلى الشبكة الرخوة
يسوق باومان مثالاً على هذا السيلان، فيتناول مفهوم الشبكة الذي حل محل مفهوم البنية، وذلك من أجل وصف الارتباطات الإنسانية المعاصرة. من الواضح أن هذا الاستبدال يعبر عن طبيعة التحول الطارئ في الحداثة السائلة، إذ إن البنى التي كانت سائدة في الحداثة الصلبة كانت تضم شتيت العناصر ضماً محكماً في عرى وثيقة لا تنفصم، وذلك خلافاً للشبكات التي غدت تنتشر اليوم انتشاراً واسعاً والتي تملك القدرة على الربط والحل، والجمع والتفتيت، والضم والفك.
في هذا السياق، يوضح باومان أن زمان الفيلسوف الفرنسي سارتر (1905-1980) ما برح ينتسب إلى الحداثة الصلبة، إذ إن المؤسسات الوطيدة المواظبة على الديمومة الفاعلة كانت تحتضن جميع مسارات الحيوية الاجتماعية. من جراء هذا الثبات، انتظمت المسالك اليومية المألوفة في حياة الناس وتزينت أفعال الإنسان ونتائجها بمعانٍ واضحة الدلالة، بحيث إن كل فرد من أفراد المجتمع كان يعلم ما ينبغي له أن يصنع حتى يحيا حياة مستقرة هادئة، في معترك الحاضر وفي استشرافات المستقبل على حد سواء. كان على الأفراد أن يختاروا السبيل الأنسب وينهجوا نهجاً يلائمهم من غير أن يخضعوا كل يوم لمخاطر الانزياح والانحراف. أما في حال الضلال، فكان في مستطاع الجميع، بمؤازرة حكماء المجتمع، أن يحكموا حكماً موضوعياً على المسلك المنحرف. وعليه، كان الناس، بحسب عبارة سارتر، يستطيعون أن يبتكروا مشروع حياتهم الخاص، ويعقدوا العزم على تحقيقه تحقيقاً كاملاً.
أما في زمن الحداثة السائلة، فإن جرأة سارتر الوجودية لم تعد تكفي من أجل الفوز بمثل العزم الوجودي الثاقب المستشرف هذا. ذلك بأن أحوال المجتمع تتبدل في كل لحظة تبدلاً يجعل الإنسان عاجزاً عن تحديد مفاهيم الوجود، ومنها المشروع الحياتي وأسلوب الحياة، والمهمات الشخصية، والعادات المسلكية المألوفة. غير أن الأخطر يظهر في صعوبة التمييز الموضوعي الدقيق بين ما يجب الأخذ به، وما يجب تركه. يبدو أن التحولات الطارئة باتت تمنع الإنسان من استجماع هذه المفاهيم وضبطها ضبطاً صلباً في أنظومة متماسكة، ومؤسسة ثابتة، ونظام معتمد راسخ.
أسباب التحول السيلاني
تعود أسباب هذا السيلان إلى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، وإلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بالمجتمعات في عام 2008، فأفضت إلى تغيير طبيعة العمل الذي تحول من الهيئة المادية إلى الهيئة اللا مادية، واستولدت الاضطراب البنيوي الجسيم، واستثارت موجات النزوح الإنساني الذليل. أما العلة الكامنة في أصل هذه الأزمة، فالعولمة المتوحشة التي هيمنت على الأسواق الإنتاجية بواسطة الشركات التجارية الضخمة العابرة الأمم، فأفقدت الأوطان السيطرة على المسار الاقتصادي وعطلت التمثيل الديمقراطي. في إثر انعطاب السلطان السياسي المحلي، انهارت مقومات الدولة الوطنية المستقلة، وانبعثت مطامح الجماعات العرقية أو المذهبية الانفصالية التي غدت تهدد مصير السلم الأهلي.
ينطوي مجاز السيلان على قدرة إلهامية بليغة، إذ إنه يفصح عن حقيقة العالم الرخو اللزج الذي نحيا في أكنافه. من سمات الحداثة السائلة السرعة في الجريان، والنفاذية في التواصل والترابط، والانتقالية اللا مستقرة في الأوضاع والأحداث. لا ريب في أن هذه السمات تجعلنا ندرك الأمور عند فواتها، أي تجعلنا نفوز ببعض من القدرة على ضبط الوقائع بعد انقضاء فترة التحكم الممكن. حينئذ تتجاوز المتغيرات الطارئة قدرتنا على استيعاب الصدمة والاضطلاع بعواقب التحول التي لا سبيل إلى الانعتاق منها. ومن ثم، يزج بنا هذا العجز في منزلة بين منزلتين يدعوها باومان البرزخ المتوسط أو الموضع البيني (interregnum). من إرباكات المقام التنازعي هذا أننا لا نحيا الحياة التي ألفناها، إذ إنها انقضت من غير رجعة، وأننا لم نبلغ الحياة الجديدة الثابتة التي نصبو إليها. حتى لو افترضنا أن الحداثة السائلة ستفرج لنا عن وضعية وجودية راسخة في المقبل من الأيام، فإن شرط نشوء هذه الوضعية أن نكتسب القدرة على إعادة برمجة أذهاننا حتى تتعود اقتبال التسارع المخيف في الأحداث، معرضين عن وهم التنعم بالسكينة والسلام.
آثار الحداثة السائلة في حياة الناس ومسار المجتمعات
تنشأ مأساة الإنسان في زمن الحداثة السائلة من عجزه عن مواجهة التيار الجارف الذي يغمرنا بموجاته المتدافعة، ويلقي بنا في وضعيات استثنائية مربكة لم نألفها من ذي قبل. لا يستطيع الإنسان المجروف أن يصنع الفعل الابتدائي، بل جل ما يمكن أن يأتي به يقتصر على رد فعل ثانوي مقيد بالفعل التغييري الصادر عن كتلة نافذة صماء من العوامل التقنية والاقتصادية المتشابكة المتواطئة. حين يقتصر فعل الإنسان على الرد الثانوي، تتفاقم مأساة الوجودية، وتنعدم قدرته على استعادة زمام الأمور، فيلفي نفسه في مواجهة قدر محتوم لا يستطيع الانعتاق منه.
من جراء هيمنة العولمة الكاسحة، تنهار حقوق الإنسان الفردية وحقوق الأقليات، إذ إن السلطة لم تعد محلية الصنع والتأثير، بل أضحت متشتتة في أصقاع الأرض، منحجبة في خفايا المشيئات الاقتصادية العالمية. وعليه، يغدو الإنسان مقذوفاً في لجة الارتباك والاضطراب والحيرة والخوف، عاجزاً عن استنباط الحلول بمؤازرة المؤسسات القانونية الوطنية المحلية. فإذا بالمجتمع يكف عن الوثوق بالدولة الوطنية العاجزة والالتجاء إليها والاحتماء بها، ويصبح خاضعاً لنفوذ القوى العالمية التي لا سلطة له عليها. الأفدح أنه لم يعد يستطيع أن يؤلب الناس على السلطة الخفية هذه، إذ لا تستقيم الثورات من دون منظورية السلطان الجائر. في حال العولمة التي تجتاح الأفراد والمجتمعات، ليس من بنية سياسية منظورة ظالمة يمكن الانقلاب عليها من أجل تغيير الواقع الجائر.
ومن ثم، أصابت الحداثة السائلة النظام الديمقراطي نفسه، إذ إن الناس ما برحت تقترع لمنتديات الأحزاب والسياسيين والحكومات التي فقدت السلطة الشرعية والقدرة الضرورية على تدبير الواقع وعلى إبرام القرارات المفيدة. ذلك بأن السلطة الحق في موضع آخر غير الموضع الذي يظن الناس أنها ما زالت منحصرة فيه، وهي آخذة في تجاوز قوانين الدول الوطنية والتنعم بحرية مطلقة في إقرار التدابير التي تستحسنها. بيد أن باومان لا يكفر العولمة تكفيراً قاطعاً، بل يكتفي بافتضاح عيوبها ومظالمها، وينعتها بالعولمة السلبية التي تستولد مشكلات عالمية لا تصح فيها المعالجة الديمقراطية المحلية. ما برحت الحداثة في نظره المشروع الشرعي والأفق المنشود، شرط أن يتنادى الحكماء إلى تأويلها لكي يستخرجوا منها وعود المعنى الإنساني المنحجبة فيها.
كثرة الأوصاف في تشخيص انعطابات الحياة في زمن العولمة
تكاثرت في حقبة ما بعد الحداثة التوصيفات الاستشرافية التي تناولت طبيعة التحولات الجليلة التي أصابت الحياة الإنسانية. فها هو ذا جان-فرانسوا ليوتار (1924-1998) ينعت الزمن الراهن بزمن ما بعد الحداثة، وألن تورن (1925) يعلن نهاية المجتمعات الإنسانية (La fin des sociétés)، وجيل ليبوڤتسكي (1944) يطلق عليه اسم عصر الفراغ (L’ère du vide)، وداني-روبر دفور (1947) يرشق الاجتماع الإنساني بتهمة الانحراف (La société perverse). من الواضح أن هؤلاء الفلاسفة وسواهم أضحوا يتوجسون خشية من الانحلال الاجتماعي والأيديولوجي الذي يضرب بالإنسانية في مختتم القرن العشرين ومستهل القرن الحادي والعشرين، وفي ظنهم أن الظاهرة المقلقة هذه ناجمة عن اجتياح الليبراليا المحدثة وهيمنتها شبه المطلقة على حقلي السياسة والاقتصاد.
أما تجليات هذا الانحلال، فيعاينها المرء في أفول المثاليات العظمى، وسقوط السرديات الكبرى الناظمة، وانتشار الريبية والنسبانية في المدارك والمعارف، واعتلاء المال والمنفعة المادية عرش القيم الأساسية، وانهيار صروح الأنظومات الأخلاقية الهادية، واضطراب العلاقات الإنسانية والروابط المهنية، واستفحال ذهنية الاستهلاك والاتجارية المتفلتة. على الرغم من أن هذه التجليات تفضي رويداً رويداً إلى الخواء الوجودي، فإن صفة التحول تفرض حتى على هذا الخواء أن يتحول إلى واقع آخر، إذ تنتقل المجتمعات الإنسانية، ربما عن غير عمد، إلى ملء الفراغ إما بواسطة استعادة صيغ التدين العتيقة، وإما بواسطة تحشيد الشعبويات القومية وتجييشها في سبيل استغلال مظالم المقهورين المنبوذين المهمشين الذين يشعرون بوطأة التحولات الجسيمة وبأثرها الفتاك في حياتهم الشخصية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ما السبيل إلى تجاوز المحنة؟
ما الحيلة الحكيمة أو المخرج المفيد؟ يحث باومان المجتمعات الإنسانية السليبة السلطان على استثمار نفوذها التربوي من أجل تعزيز الوعي الفردي المستنير الذي يحترم الذات ويحترم الآخر على حد سواء، مدافعاً عن قيمة المساواة والاختلاف في سياق اجتماع عالمي شديد التعقيد أضحى فيه مقام الفرد خاضعاً لاعتبارات الفعالية التقنية الإنتاجية. من أنجع الوسائل أن يتضامن الأفراد المستنيرون من كل حدب وصوب، وأن يتنادوا إلى إنشاء شبكة عالمية من التوعية الراقية التي تستثمر المحلي في العالمي، أي القيمة الإنسانية الخاصة في الرحابة التعددية الكونية. لذلك استنبط مقولة "العولمي-المحلي" (Glocal) يستعين بها من أجل تعزيز التكاملية القيمية بين الحضارات الإنسانية، من غير التفريط بصدارة شرعة حقوق الإنسان الكونية.
من جراء التحول السيلاني هذا، أخذ باومان أيضاً يعيد النظر في مهمة الفكر والعلوم على وجه العموم، وعلم الاجتماع على وجه الخصوص. ذلك بأن الفكر لا يستطيع بعد اليوم أن يؤثر تأثيراً فعالاً في مسار الأحداث، بل يكتفي باستنباط صور جديدة قد يرتسم الواقع على هيئتها في المقبل من الأيام. ليس للمفكر أن يقرر، بل أن يستوضح بنية التحول الحاصل، وأن يمنح الناس القدرة على تصور الإمكانات المحتشدة في تضاعيف التأزم المتفاقم، حتى إذا شاؤوا أن يصنعوا مستقبلهم بمحض عزيمتهم، كان لهم أن يستندوا إلى بصيرة الفكر المستنير. فالحداثة السائلة لا ترحم أحداً من أهل الغفلة والجهل، بل تستحث الحكماء على تدبر مآلات التطورات المتسارعة لكي يختاروا النصيب الأفضل. وظيفة المفكر أن يكشف النقاب عن حال التعقد الشائك في بنية الواقع الإنساني المعاصر، لاسيما في جوانبه المنحجبة التي لا يفطن لها الإنسان العادي. ليس الفكر صانع العجائب، بل محرض الناس على ابتكار الحكمة الضرورية من أجل تصويب مسارات الحياة وإعتاقها من انسداداتها المهلكة.