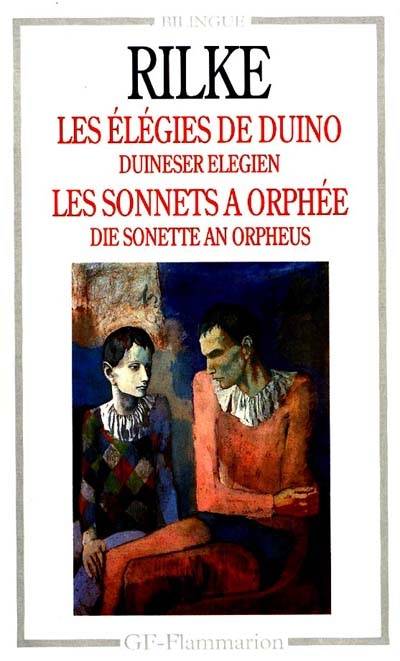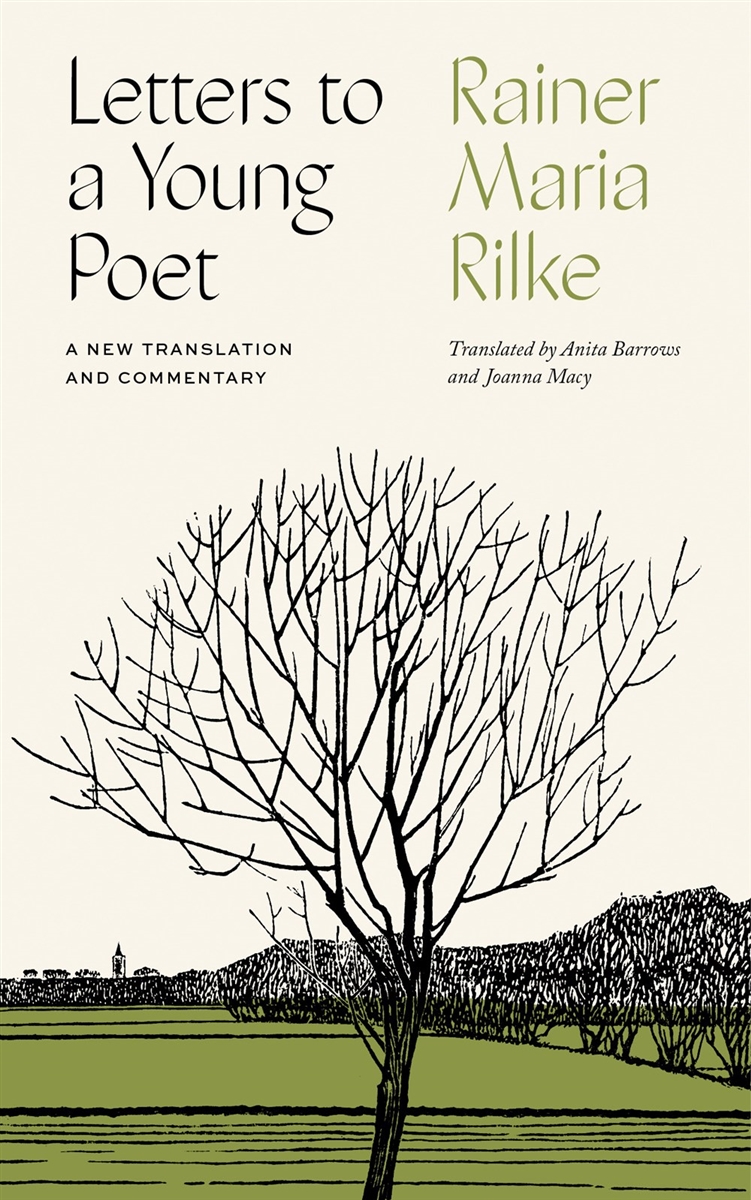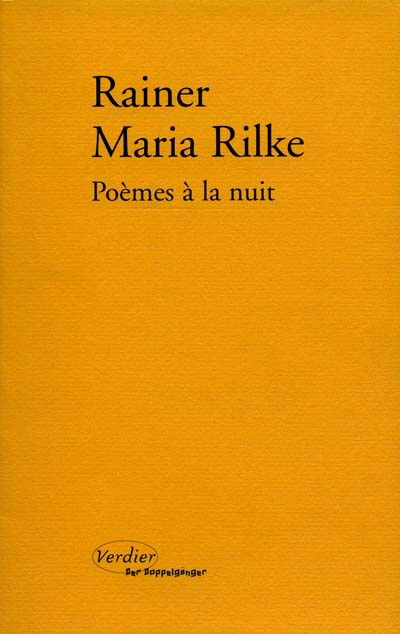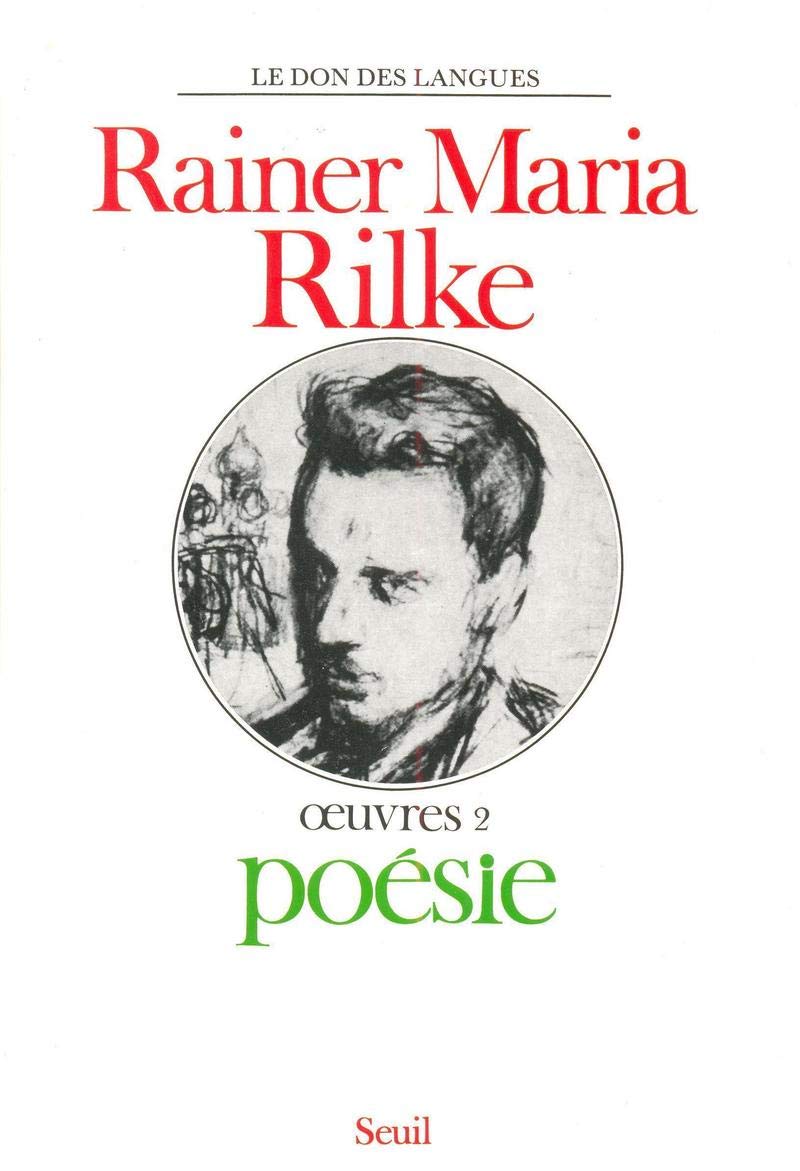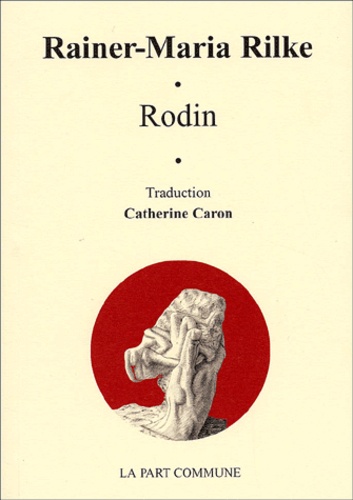راينر ماريا ريلكه (1875-1926) شاعر وروائي نمساوي بلغت قصائده أرقى مراتب تعبير الأسلوب الشعري الغنائي في الأدب الألماني المعاصر. تتسم كتاباته بسمة الغموض الخلاق، ويغلب على إنشاءاته طابع البحث المضني عن طرائق جديدة من التواصل الإنساني الذي يروم التعبير عن اختبارات السر الفائق الوصف في زمن الاستعصاء الوجداني الأخطر. كان كشافاً بارعاً ورحالةً نبيهاً يترصد أخبار الحياة من مشاهد الواقع اليومي. وكان على وجه الخصوص معلماً نابغاً يلقن أصول الدعوة الشعرية في كتابه "رسائل إلى شاعر شاب" (Briefe an einen jungen Dichter)، وروحية العمل الإبداعي في مؤلفه "رسائل العامل الشاب" (Briefe des jungen Arbeiters).
كان الشعر في حياته كل شيء، يغمر وجوده ووجدانه بإيقاعاته الخلابة. نحت لنفسه شخصيةً ذاتيةً منعتقةً من كل الانتماءات الدينية الضيقة والمبايعات الأيديولوجية الرخيصة. من شدة محبته عاصمة الفن والإبداع باريس، قررت بلديتها أن تحمل واحدة من مكتباتها اسمه الشهير تخليداً لذكراه. عاين إحباط الإنسان واضطرابات الأرض، فاقترح الدخول في رحابة الانفتاح المشرع (das Offene) لكي تحصل معجزة التحول الكياني الأعمق. تُملي عليه شاعريته ألا يخشى الحياة في جنون انفعالاتها وكثافة تجلياتها. لا يرهب الإقبال على لذة العيش، إذ إن طبيعته الوجدانية تدفع به إلى اغتراف رحيق الاستمتاع من عمق اللحظات المتراقصة في ميدان اختباراته الحياتية.
تأثر بالحرب العالمية الأولى، فانقطع الوحي عنه، وهوى في أزمة وجودية جسيمة، ولكنه ما لبث أن استجمع قواه واستعاد كتابة القصائد الرثائية (Duineser Elegien) أثناء إقامته في مزوت بسويسراً، حيث اختبر العزلة وسحر العصر القديم. فإذا به ينهي هذه القصائد بعد انقطاع دام عشر سنوات (1912-1921)، وقد اكتنزت بما اكتسبه من خبرات المعاناة الحياتية. ومن ثم، عكف على إنشاء قصائده الشهيرة (Die Sonette an Orpheus) الممهورة بإيحاءات شاعر الإغريق الأسطوري أورفيوس.
رمزية باريس في اختبار تناقضات الحياة
أتى باريس من الريف الأوروبي، أي من مدينة براغ البعيدة، فنظر إلى العاصمة الفرنسية نظرته إلى هيكل الحضارة الغربية وقدس أقداسها. كان أيضاً يبحث عن تجويد أدائه الشعري باللغة الفرنسية التي أتقنها وكتب فيها بعضاً من أروع نصوصه. وكان يتقن الروسية أيضاً، بيد أن اللغة الفرنسية كانت، في نظره، مصدر الحداثة الأدبية التي استهلها شارل بودلر (1821-1867)، وعززها ستفان مالارمه (1842-1898). لا بد إذا من الكتابة المبدعة بهذه اللغة حتى تتحقق وعود الحداثة في أعمال الشاعر الملهم.
كانت امرأته كلارا فستهوف نحاتةً تتلمذت على النحات الفرنسي الشهير أوغست رودن (1840-1917)، لذلك جعلت زوجها يتعرف إلى النحات ويتعلق به ويطرب لأعماله، حتى إنه أصبح أمين سره وخليل مفاتحاته الوجدانية. أما عنوان إقامته الباريسية في الحي اللاتيني قرب السوربون، فاستخدمه في روايته اليتيمة "دفاتر مالته لوريدس بريغه" (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge) ليقيم فيه بطله ويشرع له سبل المغامرة الباريسية.
ولكنه أيضاً اكتشف في باريس حياة العزلة التي يختبرها الفرد الذي لا اسم له، يغمره ضجيج المدينة المرهق وصخبها الليلي الخانق. وعاين أيضاً مقدار المظالم والآلام التي يتكبدها الإنسان الحديث في المدن المتعاظمة الاتساع والنفوذ. قال في إثر هذه الإقامة إن حياته الباريسية كانت أشبه بلوحة فوتوغرافية حساسة شديدة التعرض لتأثيرات البيئة. تدل هذه الاستعارة على وضعية الانفتاح الأرحب الذي اختبره في التعرض لأشعة الحياة الملتهبة. شأنه في ذلك شأن البيوت الباريسية المصدعة المشرعة التي كان الشاب مالته يتأمل فيها، تنظر إلى الخارج وينظر الخارج إليها من غير استئذان. إنها حال الباطن الإنساني المنفتح على استدعاءات الحياة وأسئلتها المربكة. ومن ثم، ليس للإنسان أن ينطوي على ذاته وينكفئ إلى حديقته السرية، إذ إن الباطن الإنساني تعرض عفوي لأنوار العالم الساطعة المتدافعة الأطياف.
من آثار الإقامة الباريسية وعشق العمل الفني أن ريلكه انفصل عن زوجته كلارا، من غير أن يقطع العلاقة بها، إذ استمرا يلتقيان ويتراسلان ويتناصحان، ذلك بأنه أدرك في باريس أنه منذور للعمل الإبداعي الذي لا يتيح للمرأة أن تنتعش في جواره انتعاش الشراكة الكاملة والمفاتحة الوجدانية. غير أن معنى العمل، في نظره، لا يقترن بالفاعلية الإنتاجية التي تسلب الإنسان كرامته الأصلية، بل يدل على إمكان تحقق الذات الإنسانية الحرة. فالفنانون والشعراء والفلاسفة المبدعون لا يعملون من أجل الإنتاج، بل يعملون عمل التوليد الذاتي الذي ينحت الشخصية الفردية، وفقاً لطاقاتهم الدفينة، في سبيل وهب الذات وهباً مجانياً.
من جراء تعثره بمشهد عزلة الكائنات البشرية في باريس، اشتد عوده وترسخت إرادته العازمة على معاندة الأقدار الظالمة، ولكنه ما لبث أن استعاد طراوة الحس الغنائي في تعابيره الشعرية التي اغتنت بمآسي الحقبة الباريسية. الثابت في هذه الخبرة أنه تنقل بين العزلة الخارجية والعزلة الداخلية، فاستطاع أن يطور أسلوبه الشعري حتى يستوعب إرباكات الوجود الإنساني.
نحت الوجود على طريقة رودن
التقى في باريس رودن، وأيضاً الرسام الفرنسي بول سزان (1839-1906). اعتصرته المدينة في لهيب جهنمها، فعاد إليها في غروب شمسه يطلب المعنى المفقود. تأثر بعشق العمل المبدع في حياة رودن، وبطواعية الأشكال النحتية التي تخرج من العدم. جال به رودن في شوارع باريس. وكشف له عن كنوزها الفنية في كاتدرائياتها ورسوم متاحفها ومحفوظات مكتباتها. اصطحبه إلى مدينة شارتر، حيث أظهر له البهاءات النادرة التي تزخر بها كاتدرائيتها الشامخة المهيبة، لا سيما ملاك الظهر الزوالي (L"Ange du Méridien) الذي استلهمه ريلكه في كتابة القصيدة الأولى من قصائد شارتر الست، ذلك بأن الملاك يتوسط، في قصائده، المقام المربك بين المنظور وغير المنظور، لذلك استحضره ريلكه لكي يستجلي به سبل التحول الوجودي الأعظم.
ساعدته زيارة الكاتدرائيات في الاستدلال على مقام الله في القرون الوسطى المسيحية. فأدرك أن الله كان قريباً من البشر، ولكن هذا القرب أرعب ريلكه، إذ اتضح له أن الأبراج الكنسية الضخمة المسننة المرتقية إلى السماء تشبه النبال الحادة التي تهدد الخالق في موطنه الأعلى تهديداً جعله ينكفئ عن الناس إلى مسكنه السماوي.
أما مطارحاته مع سزان، فجعلته يدرك أن الفن يستطيع أن يواجه فظاعات العالم، ويتدبر جثث التاريخ وجيفه المتناثرة على وقع الأهوال والحروب والمآسي. وحده الفن يؤهل الناس للاضطلاع بالرهبة الكونية الناجمة عن انحرافات الإنسان وآثامه الجسيمة. وعلاوةً على ذلك، اختبر ريلكه التسامي الصوفي في عمل الرسام الذي يقدس الطبيعة حين يجعلها تتجلى في أبهى حللها. تأثر لنا الروايات الأدبية أن شغف ريلكه بالرسم منعه حتى من حضور ما تم والدته، إذ آثر لوحته على مشهد الدفن العيلي. فالرسام يختفي وينحجب في لوحاته التي تجسد الواقع الحق. ومن ثم، كانت لوحات سزان بمنزلة القطيعة الحديثة عن المألوف الفني، إذ إن جميع عناصر اللوحة ومواضعها يقترن بعضها ببعض من غير تصدر أو استعلاء أو أسبقية. بفضل الألوان الزاهية، يعشق الكل الكل في مشهدية الرسم السزاني الإبداعي.
وضعية المعاناة في الكائن الإنساني الحديث
المشكلة أن الحداثة، إذ تتناول الموت تناولاً عدمياً، تبطل فائدة الشعر الذي يعاين ريلكه فيه ثمرةً كيانيةً تنضج وجودنا. إذا أعرض الإنسان عن الموت، أهمل جانباً أساسياً من جوانب الحياة. ومن ثم، كان ريلكه يسعى إلى التأمل في الموت حتى يعيد له القدرة على الانسلاك في تضاعيف الحياة، بحيث يستعيد الإنسان الحديث وحدة الحياة والموت في صميم نضاله الوجودي. الموت والحياة بعدان أساسيان ناشبان في صميم اختبار العالم. من ينكر الموت، ينكر الحياة. الحداثة تسلب الإنسان موته الخاص. ومن ثم، لا بد من استدعاء القدرة الإلهية من أجل أن يفوز الإنسان بنعمة موته الخاص، لذلك تخيل ريلكه حياة الإنسان المعاصر في هيئة الشاب الدنماركي الأرستقراطي مالته الذي قصد باريس لكي يتعلم فن الشعر ويصبح شاعراً.
أفيعقل، والحال هذه، أن تكون البشرية قد طوت ملايين السنين في التلهي بقشور الحياة، عوضاً عن الغوص العميق على أبعادها الجليلة؟ أفيعقل أن نكون قد أخطأنا فهم تاريخ البشرية بأسره؟ أفيعقل أن يتقرب الإنسان إلى الله من غير أن يستنفد جوهره ويقضي على تساميه؟ الحقيقة أن الكائن الإنساني، في نظر ريلكه، يترجح بين هاويتين: الطيف المتلاشي الذي يفقد مركز ذاته، والآلة الإنتاجية التي لا تدرك معنى وجودها. والحال أن الإنسان فقد معنى وجوده، لا بل أضاع السؤال عن الأمر الأهم الذي ينقصه لكي ينوجد انوجاداً حقاً، ما الذي أفتقده في وجودي حتى أستطيع أن أحيا ملء الحياة؟ صحيح أن النقاد عابوا على ريلكه غنائيته المنعتقة من قيود الانتساب إلى معاناة الناس، ونعتوه بشاعر الوردة وشاعر الكاتدرائيات والقصور. غير أنه، في عمق شعريته، ظل قريباً من واقع الاختبار الوجداني الذي يعتصر فؤاد الإنسان المعاصر. إنسان القصائد الرثائية التي وصف بها احتضار الذات الإنسانية يشبه الإنسان المقتلع الجذور في أعمال الروائي التشيكي فرانتس كافكا (1883-1924)، والإنسان المنعدم الصفات في نصوص الكاتب النمساوي روبرت موزيل (1880-1942).
الحب شمولي قدري
لا غرابة، من ثم، أن يختبر ريلكه العشق خارج القيد الزواجي. لا شك في أن علاقة العشق التي ربطته بالمحللة النفسية الروسية - الألمانية لو - أندرياس سالومه (1861-1937) أعادت وضعه ثانيةً في الحياة بحيث تكرر مشهد ولادته الوجدانية. ساعدته صديقة نيتشه وفرويد في الانعتاق من سطحيات زمن المراهقة وإغراءات استسهال الحياة الدنيوية، فتعلم منها معنى التطلب الذاتي والمثابرة على نحت الوجدان نحتاً صبوراً. اختبر أيضاً علاقةً فنيةً غنيةً بالرسامة الألمانية بالادين كلوسوفسكا (1886-1969) المعروفة بمرلين. وانعقدت كذلك في حياته علاقة نسائية أقرب إلى المطارحة الروحية ربطته بالشاعرة الروسية مارينا تسفتايفا (1892-1941) التي لم يلتقها أبداً، على الرغم من من كثافة المراسلات وعمق المفاتحات. من أغرب المصادفات أن يختبر ريلكه أصدق مشاعر الحب مع امرأة لم يرها ويحادثها ويلمسها على الإطلاق.
ومن ثم، يمكن القول إن مراتب الحب في حياته تنوعت تنوعاً مذهلاً بحيث عرف من الوضعيات العشقية أشدها امتحاناً للوجدان الرقيق. إذا كان البعد الجغرافي والجسدي لا يبطل الوصال الوجداني، فإن العمق الروحي الذي ربطهما ما برح الضامن الأساسي في استمرار العلاقة. على غرار مقام الحب العذري في القرون الوسطى، يحث الحب المتباعد الشاعر على إتقان عبارته الشعرية التي يتكل عليها في الإفصاح عن غزارة الانفعال العشقي، إذ تتحول المشاعر إلى مرقاة ترتفع بالنفس إلى أسمى مراتب الصفاء. في مراسلاته إلى أحد الأصدقاء، باح بسر معاناته، إذ كشف عن أن الحب من أعسر الصناعات الوجودية على الإطلاق، ذلك بأن الحب علاقة جذرية، متطلبة، شمولية، تستنهض الكيان بأسره. في توترات الحب يستسلم الإنسان بكليته للاضطرام المتقد في أتون الوجدان، فيفقد السيطرة على حركة وعيه، متكلاً على صدق العاطفة ونبل الهوى.
وعليه، ينعقد بين الحب والشعر تواطؤ مذهل، إذ كلاهما يخضع للتوجسات عينها وللمتطلبات نفسها. في كتاب رسائل إلى شاعر شاب، عاين ريلكه في العشق المتقد بين شاب وشابة وفي صناعة الشعر بريشة المبتدئ أسهل سبل الانحراف عن عمق الحقائق الحياتية. وحدها العزلة الإنضاجية تتيح للحب الناشئ وللشعر المتبرعم أن يفوزاً بالعمق الضروري الذي ينعشهما ويكشف لهما أسرار الوجدان التائه في غياهب العالم. كلا الحب والشعر يلقن الإنسان معنى القدر المرسوم ومغزى الغوص على مضامين المعاناة المضطرمة في قعر الذات الإنسانية.
للحب ناموس واحد اسمه التحول، أي الانبعاث المتجدد الذي يتجاوز مشاعر الأشخاص ويحرر أفئدتهم من قيود اللحظة الساحرة. ليس ريلكه شاعراً رومانسيا يتغنى بعواطف العاشقين ورجفات أغشيتهم الوجدانية، بل شاعر صوفي يستجلي، كما في القصيدة الثامنة من قصائده الرثائية (Duineser Elegien)، محنة الحب المضنية التي تطهر الإنسان من شوائب الأنانيات الخانقة، حتى يصبح العاشق عالماً قائماً بحد ذاته في سبيل الآخر الذي يصبو إلى سكنى هذا العالم، هذا كله يتحقق على صورة ملاك القصائد الذي ينتقل بالمنظور إلى مقام اللامنظور، ويضمن للحب تساميه المنطوي في ثنايا الوجدان الصادق المرهف. الملاك هو الشاعر الذي ينتقل من المنظور إلى اللامنظور، ويملك القدرة على تجاوز باب الحياة والسكنى في موطن الأحياء وموطن الأموات. للشاعر وحده حق المرور وتجاوز الحواجز التي اصطنعتها الحياة على غفلة من وعي الإنسان.
لم يشأ ريلكه أن يخضع لتحليل نفسي اقترحته عليه صديقته سالومه، إذ إن الاضطراب الذي كان يعانيه ناشئ من الفراغ الكياني الأعمق الذي يضع وجود الإنسان برمته في موضع الانعطابية الجذرية الشاملة، ذلك بأن البشرية كلها تتحول إلى كتلة صماء مغفلة تتحرك تحركاً آلياً مجرداً من كل شغف وجداني. حتى الموت عينه يفقد رونق تحديه، إذ إنه يضحي مرحلةً من مراحل تمدد الكتلة المغفلة في الفضاء العدمي. ومن ثم، كان ريلكه يستشعر ما يستثيره الموت في الحداثة الغربية من عدمية لا تكترث بمقام الاستحقاق الأقصى الذي منه يمكن الإنسان أن يستمد معنى إمكاناته الدفينة، بحسب ما كان يذهب إليه هايدغر. خلاصة القول إن الحب ينبسط في جو أو بيئة من القدر تحتضنه أو تكتنفه، وكأنه يستثير العناصر التي تنعقد في رسم أقدار الناس، إذ إنه يتجاوز مجرد العلاقة بين محبوبين ليشمل مجموع الاختبار الإنساني في كليته.
الإقامة الشعرية
ليس من فصل قاطع بين حياة ريلكه الشخصية واختباره الشعري، إذ إنهما كليهما يخضعان لناموس التحول الكياني الأعمق. حين أقام في منطقة الفاله بسويسرا، لم يستطع أن يسكن سكناً وجودياً ملائماً إلا على قدر ما تحول المكان إلى فضاء اختباري رحب أتاح له أن يبسط مكنونات وجدانه الشاعري. فالمكان لا يصبح مسكناً إلا حين يستوطنه الوجدان النابض بأحاسيس الحياة المنعتقة من الحدود والرسوم والأعراف. بالشعر يصبح المكان مسكن الإلهام، ما نعاينه في المشهد الخارجي ينقلب إلى حال وجدية تذكر بما عاينه بول سزان في جبل سانت - فيكتوار (منطقة إكس - أنبروفنس الفرنسية) وما أفرجت عنه قريحته في اللوحة الشهيرة التي تحمل الاسم عينه.
ذلك بأن العالم موضع انتظام التوترات المضطرمة بين عناصر الحياة، وميدان تدبرها تدبراً فنياً راقياً. فالتحول (Verwandlung) ينشأ من انبساط الفضاء الذي تحتشد فيها توترات الحياة، وقد انتظمت واتسقت وانجلت في طاقاتها الإلهامية العظمى. حينئذٍ يستطيع الإنسان أن يختبر الفضاء الداخلي (Innerraum) الذي ينشئ الفتحة الخلاصية المشرعة على آفاق الترميم الذاتي الأصدق. غير أن هذا الانفتاح لا يختبره الإنسان إلا على سبيل الالتماع الآني العابر، إذ ما من أحد يستطيع أن يقيم إقامة دائمةً في اضطرام التفتح المشرع على المجهول المباغت. يحاول ريلكه أن يفسر أصل الصعوبة في استقرار الإنسان على مثل التلألؤ الوضاء هذا، فيبين لنا أننا، ما دمنا نحيا في انقسام وتشرذم وتبعثر، لا نستطيع أن نفوز بوحدة الوجود التي تختبرها العصافير المترحلة (Zugvögel) المتحدة بعناصر السماء والأرض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لذلك كان الشعر نجاة الإنسان من استعصاء القول الخبري الوصفي. فاللغة المنطقية لا تستطيع أن تمسك بالوحدة السرية المنحجبة هذه، ولا أن تستوضح الحركة الناشطة في التحول العبوري من وضعية إلى أخرى، بل تحتاج إلى انسيابية العبارة الشعرية التي تحتمل الترحال والتنقل والاضطراب والالتباس المغني. مثل هذ الحركية كمثل السيرة الذاتية الترحالية التي رسمتها حياة ريلكه المسافر المتنقل من بلد إلى آخر، من مشهد إلى آخر، من اختبار إلى آخر، لذلك يستبق الشعر محطات الإقامة المؤقتة، فيحرض الإنسان على تطلب الأبعد واستحضار الغائب المقبل على الوجود من أحضان الأقدار المباغتة. منطق التحول يجعل الإقامة النهائية مستحيلةً في قرائن التاريخ الحياتي المتحرك.
ريلكه معشوق الفلاسفة
يجمع الباحثون على القول إن ريلكه أثر تأثيراً بالغاً في كوكبة من الفلاسفة الذين عاينوا في شعره حدساً استثنائياً قادراً على إدراك معنى الحياة والموت والحب والتفتح الكياني السري والذات الإنسانية المتحولة. أغلب الظن أنه ألهم هايدغر فكرة التفتح السري، وأعانه على صوغ مقولة سر الوجود الموهوب (das offene Gehimnis) المشرع على آفاق الجدة المباغتة المذهلة. في قصيدة "النمر" (Der Panther)، يبين ريلكه أن الإنسان كائن القلق المنبعث من اقترانه القدري بالكينونة. ومن ثم، فإن هايدغر، حين تساءل في مقالته (Wozu Dichter?) عن ضرورة الشعر وفضائل الشعراء، كان يمتدح عظمة ريلكه في ذكرى وفاته العشرين، ذلك بأنه شاعر زمن البؤس المتافيزيائي الذي يعطل كل الإبداعات، ويجمد الحياة في هيئة التسلط التقني على الأشياء والأغراض. لا بد، والحال هذه، من فتحة خلاصية، من كوة ارتقائية ننفذ منها إلى أرض ميعاد الكينونة الحق، حيث السؤال تقوى الفكر المتأمل المستذكر.