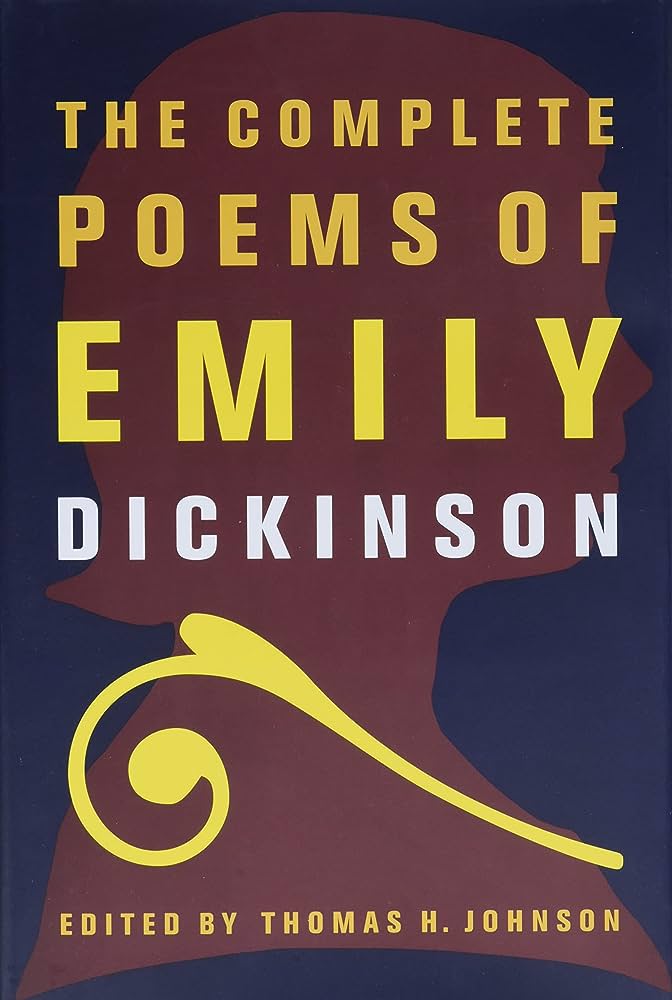ملخص
أعمالها الشعرية الرائدة كاملة بالعربية في 1080 صفحة بتعريب عابد إسماعيل
كان الشاعر يوسف الخال أول من عرف القراء العرب بالشاعرة الأميركية الرائدة إميلي ديكنسون وترجم لها بضع قصائد وكتب موجزاً لسيرتها في العدد الأول من مجلة "شعر"، التي أسسها عام 1957. ومنذ ذلك الحين كاد المعترك الشعري العربي ينساها (ما خلا ترجمات قليلة) خصوصاً بعدما انصرف المترجمون إلى تعريب شعراء كبار، أميركيين وبريطانيين، وفي مقدمتهم ت. س. إليوت ووالت ويتمان وروبرت فروست وييتس وشعراء "بيت جنريشن"، علماً أن هذه الشاعرة الكبيرة تعدّ في مصاف والت ويتمان وإدغار ألن بو وفي مرتبة الشعراء الكبار في العالم، ولو أن ديوانها الكامل لم يلتئم إلا في العام 1955 بعد 69 عاماً على رحيلها، وضم 1775 قصيدة يميل معظمها إلى القصر، حتى ليبدو بعض منها أشبه بمقطوعات شعرية وشذرات من بضعة أسطر، لم تحمل كلها أي عناوين، بل أرقاماً. لكن إغفال العناوين لم يعنِ تفلت القصائد من عقال نظام الوحدة التي تنفرد بها كل قصيدة، كما لم يعنِ استحالة قراءتها قراءة متفوحة، تجري كالنهر الذي يجرف التخوم.
بعد ترجمة يوسف الخال اليتيمة للقصائد تلك لم يُؤت على ذكر هذه الشاعرة العظيمة عربياً إلا في ما ندر، لكن الشاعر والأكاديمي والمترجم السوري عابد إسماعيل شاء أن "ينتقم" لها في لغة الضاد، ولنا نحن القراء، وبدا "انتقامه" أشبه بحدث كبير، في حقل التعريب الشعري وحقل الشعر العربي، فهو نقل كل قصائد الشاعرة إلى العربية، بل أعاد خلقها وصنعها وصوغها في لغة تضاهي الاصل، بحب ووفاء. وصدرت الأعمال الكاملة عن دار التكوين في دمشق في مجلد ضخم يتخطى الـ1080 صفحة. وما كان ليتحقق حلم عابد إسماعيل هذا لولا حماسة الناشر والشاعر سامي أحمد صاحب دار التكوين (دمشق) لهذه الأعمال، ومغامرته في زمن تراجع القراءة والكتاب الورقي في العالم العربي راهناً.
كان إسماعيل، قد ترجم سابقاً أعمالاً شعرية وروائية ونقدية كثيرة، مهمة وطليعية، ومنها ديوان "اغنية نفسي" لولت ويتمان و"الأشعار الكاملة" لسيلفيا بلاث عطفاً على هاري مارتنسون وإيزابيلا فونسيكا ونايبول وبورخيس وسواهم ، وبدا على براعة في الترجمة الإبداعية ومتانة وأناقة، وتمكن من أداء المعاني على خير وجوهها. وترجم كتباً نقدية وفكرية عديدة، في طليعتها كتب الناقد الأميركي الكبير هارولد بلوم، فعرّف النقاد العرب به وبمنهجه ومقولاته وأبحاثه، واستفادوا منه كثيراً.
مغامرة خطرة
في الأعمال الكاملة لإميلي ديكنسون، يحقق اسماعيل إنجازاً فريداً يتجلى في هذه المغامرة "الخطرة" وما افترضت من جهد ومثابرة ومراس، بخاصة أن تجربة ديكنسون غاية في الصعوبة والتعقيد والإضمار والترميز والجمالية والتوقيع الموسيقي الحر، فهي لا تقدم بسهولة مفاتيح قصائدها إلى المترجمين، لكنها في الحين عينه، تتيح للقراء من فرص كي يلجوا عالمها الشاسع، والمتعدد الظواهر والتجليات والتآويل. ولعل هذا ما اعترفت به مثلاً الشاعرة والمترجمة الفرنسية كلير مارلو التي ترجمت كثيراً من شعرها في ثلاثة كتب صدرت عن دار غاليمار (سلسلة شعر)، وهي: "غرفة مع منظر على الأبدية"، و"لأن الوداع هو الليل" و"رباعيات". وكانت هذه المختارات (مع ترجمات أخرى)، نافذة يطل منها القراء الفرنسيون على عالم الشاعرة، فيتعرفون عليها ويقرأون قصائدها الفريدة التي لم يقرأوا ما يشبهها سابقاً. وبدت الترجمة فعلاً إبداعياً وخلاقاً، تطلب منها أيضاً جهداً وحباً، فهي تقول: "امتزجت لغتانا وكتابتنا، وحاولت أقصى ما استطعت أن أوجه اللغة من دون أن أبقى على سطح الكلمات". فالصوت كما تعبر، لا يتم التقاطه بسهولة، فهو متلاعب ومتفرد ومتعدد وتراجيدي. والمشهد الشعري رحب جداً، يتراوح بين المينيمالية الشكلية والفوران أو التدفق الإيقاعي الحر والانبلاج الصوري. أما الجمالية هنا فهي جمالية النقصان أو اللااكتمال، جمالية الرغبة التي تتحقق في عدم اكتمالها أو بقائها رغبة مستمرة.
أما عابد إسماعيل فلا ينثني عن مخاطبتها مخاطبة حميمة في أحد مقاطع مقدمته، كأن يقول: "لا أترجمك كآلة حاسبة، أو كمحترف ينقل نصاً من لغة إلى لغة بأمانة أدبية وأخلاقية عالية. أنا أعيد تأليفك من جديد، مع وفائي المطلق لمعانيك وأسلوبك وصورك. أحاول أن أبتكر تيهك، أو أن أكشف النقاب عن سر عزلتك الخارقة التي تشبه عزلتي. أعي وأنا أترجم معانيك، سر ذاك الشغف بالتواري. خجلك من الظهور أمام الآخرين. ريبتك وترددك وقلقك".
عاش الشاعر والأكاديمي عابد إسماعيل سنوات طويلة مع الشاعرة إميلي ديكنسون قبل أن يقبل على ترجمة شعرها، قرأها وأعاد قراءتها ودرّسها لطلابه في الأدب الإنجليزي والأميركي، ورافقته مرافقة الصديقة اليومية، خصوصاً خلال زمن كورونا وأزمنة الحرب السورية.
وفي مستهل مقدمته الضافية، النقدية والذاتية في آنٍ واحد، التي تعد من أوفى ما كتب عن الشاعرة، والتي تغني القارئ عن العودة إلى مرجع آخر، تبعاً لشموليتها وعمقها. يعترف عابد اعتراف العاشق بأنه كان معها، خلال قراءتها وترجمتها، في "رحلة شعرية طويلة بين ضفتي الأطلسي"، هي التي تسمى (من ضمن تسمياتها المتعددة) "شاعرة العزلة"، وكانا "يبحران معاً صوب البحر الأبيض المتوسط على قارب من القصائد". إنها الترجمة التي تبدو هنا سفراً بين ضفتين متباعدتين جغرافياً، عطفاً على كونها أساساً، سفراً بين لغتين وهويتين، بما تحملان من أصول وخصائص معرفية ووجودية، حتى ليمسي السفر في نهاية المطاف، إقامة في عالم الشاعرة الأميركية، ولكن عبر اللغة العربية التي غدت مع إسماعيل كأنها لغتها الأم. ولا استغراب إن مضى الشاعر المترجم في فضح هوية العاشق الذي هو، حيال قصائد الشاعرة التي أضحت مرآة كبيرة يرى فيها نفسه، لكنه العاشق اليقظ ولو في أوج ما يسميه "الذهول"، الذي منه "يبدأ كل شيء تقريباً، وتولد القصيدة - اللغز، بنحوها وصرفها وإيقاعاتها حتى الرمق الأخير". ولا يني إسماعيل يصف "قصيدة" الشاعرة بـ"القصيدة الميتافيزيقية، الصعبة المراس، التي تشبه الأحجية في بنيتها ومفرداتها وحركتها"، والتي تفترض فك الإشارات الغامضة، غموض الذات الشاعرة، والملتبسة التباس الكينونة. فقراءة ديكنسون توجب الإصغاء ملياً إلى "الرجع البعيد للمفردات".
يصف إسماعيل الترجمة التي اعتنقها ومارسها طوال سنوات، بالإنصات إلى نداء الأعماق، وبالسفر الطويل الذي لا يبتغي الوصول إلى ما يُسمى حقيقة النص. ففكرة المعنى، في نظره، تظل تتأرجح بين الظل والضوء، الاختلاف والتأجيل، في قصيدة ينعتها بالكثيفة، والملغزة، والمثخنة بالأسئلة، وفيها تنصهر الغرابة بالابتكار. أما الغرابة فهي التفلت من قيد النظم، معنى ومبنى، والابتكار هو قطيعة فنية مطلقة مع الماضي البائد، كما يعبر. ويضيف: "وفي المحصلة، هي عبقرية الانزياح التي تصدم وتدهش وتكسر كل قاعدة. تقتحم التقليد من أوسع أبوابه، وتخلخل أركانه، وتبث روحاً جديدة في النظام الرمزي والبلاغي لشعرية القرن التاسع عشر في أميركا، وما بعدها". هذه العبقرية التي تقف خلف كل تجديد شعري، تفرض على الترجمة ذاتها، بهواجسها وأنوائها وعثراتها، حتى ليغدو المترجم مبدعاً للقصيدة، ولكن مبدعاً آخر، أو ثانياً. وهنا لا بد من تذكر ترجمة الشاعر الفرنسي جيرار دو نيرفال لتحفة الشاعر الألماني غوته "فاوست"، فحين قرأها غوته الذي يجيد الفرنسية، انحنى أمام الشاعر الشاب، واعترف بأن هذه الترجمة ترتقي إلى مصاف الأصل وتتخطاه في أحيان.
ديكنسون المجددة
يواصل إسماعيل قراءته النقدية لمفهوم التجديد في قصائد إميلي ديكنسون الذي لا يتزحزح عن مركزه، والذي لا يبلغ نهاية ما، والذي يتجلى في المعمار البلاغي المعقد، والأفق الدلالي الشاسع. فشعرها يحمل كثيراً من المفاجآت، ومنها مثلاً بروز اسم مزدوج الدلالة، أو فجوة دلالية بين جملتين، أو فكرة صادمة بين هلالين أو نجمتين. ويشير إلى بعض المخاطر التي تواجه المترجم كما القارئ، مثل الوقوع في شرك صورة يختلف ظاهرها عن باطنها، أو في فخ منصوب في الهامش أو عدم الانتباه إلى سياق الحبكة الشعرية بصدوعها وتعرجاتها. ويتطرق إسماعيل إلى كثرة الإحالات وتشعبها والتوائها، وتوزعها بين الأسطوري والديني والطبيعي والفلسفي والسيرذاتي... وتنعطف بعض الإحالات إلى الحاضر الراهن (حينذاك)، الذي ترفض الشاعرة قيمه وذائقته الشائعة، ويميل بعضها إلى الماضي البعيد الذي تبجل الشاعرة تساميه الرفيع.
واللافت في شعر ديكنسون هو خلو القصائد بمعظمها من العناوين، وحلول الأرقام محلها. وهذا الانسراح الشعري يضع القارئ (الذي هو أنا، مثلاً) في حال من الدهشة والافتتان والحيرة، فيشعر بأنه يقرأ شعراً ملحمياً، بينما هو يقرأ قصائد، مستقلة ومتواصلة في الحين عينه، يجمع بينها خيط غير ضئيل، خيط المعاني المتدفقة والإيقاعات والصور واللغة التي تحفر مجراها.
إميلي ديكنسون شاعرة سرية "عميقة الأغوار، متموجة المعاني، ومتلاطمة الصور"، لكنها تبدو في أحيان صامتة تكتم أكثر مما تفصح. شاعرة متأنية، محاذرة، غير تلقائية أو عفوية، بل هي "تعمل" على فنها الشعري، بحسب عبارة بول فاليري، لكنها تظل في منأى عن التكلف والتصنع. و"قصيدتها، كما يقول إسماعيل، محسوبة بدقة متناهية، ومصنوعة بأناة وصبر"، وهي "تشيد معماراً فكرياً محكماً، قوامه الانخطاف والإشراق والبرق". ويضيف: "قصيدتها رجراجة، ومتبدلة ومتحولة ككثيب رملي، تغير إيقاعاتها مع كل قراءة". وبما أن للمفردة الواحدة أكثر من دلالة، وبما أن السياق يهتز مع كل تأويل، يرى إسماعيل أن عليه كمترجم أن يعيد البحث والاكتشاف، ويعيد الترجمة، فالشاعرة "تدون ارتعاش الحقيقة أمام البصيرة، وأفول المعنى أمام البصر". ويلحظ إسماعيل أن طريقة ديكنسون الجديدة في تدوين صراعات الذات تتوارى خلف أكثر من حجاب، "على طريقة المتصوفة الكبار". فالأنا الشعرية هنا ذات طبقات وتطل على الدهاليز والممرات الخفية. إنها الأنا الكثيرة، المعتددة، المتناثرة، التي تنطوي على عوالم أكثر رهبة، كما تشير الشاعرة نفسها في إحدى القصائد: "ذواتنا، المتوارية، خلف ذواتنا هي التي تخيف أكثر". وقد عرفت ديكنسون الشعر الحقيقي بـ"الرعشة التي تسري في كافة أنحاء الجسد، وتجعل الكيان كله يهتز، والروح تتأرجح بين النفي والإثبات، الحقيقة والوهم، الصفاء والإبهام".
يروي عابد إسماعيل حكاية تعرفه إلى إميلي ديكنسون من طريق المصادفة الأكاديمية في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حين كان لا يزال طالباً يكمل دراسته الجامعية للشعر الأميركي الحديث في جامعة نيويورك، تحضيراً لشهادة الدكتوراه في الأدب. وشاءت الظروف أن تكون ديكنسون أول شاعرة يتكلم عنها باللغة الإنجليزية، أمام جمهور ناطق بالإنجليزية، بعد شهر من وصوله إلى الولايات المتحدة حين اعتلى المنبر في جامعة بنسلفانيا، التي درس على مقاعدها الشاعران العملاقان عزرا باوند وكارلوس وليامز، ووقف مشدوهاً أمام حشد من الطلبة الخريجين، القادمين مثله عبر منحة "فولبرايت" العالمية. وبدأ مداخلته بجملة اقتبسها من ناقد أميركي تقول: "ديكنسون ماتت طوال حياتها". اختار هذه العبارة، لأنها تنطبق على "هذه الشاعرة العبقرية التي عاشت طوال حياتها تحاور الموت، وتبوح له بأسرارها، وتصف أدق التفاصيل المرتبطة بفكرة الفناء". وبعد سنوات من تدريس قصائدها لطلابه في الجامعة، وجد نفسه يترجم أعمالها كاملة إلى العربية، "غير منقوصة، وغير مشوهة، وغير مختصرة". وبلغ عدد القصائد 1775، جاءت في معظمها مؤرخة، كما دونتها الشاعرة بخط يدها، وخبأتها في الإدراج، تحت أرقام متسلسلة، بعد أن تخلت عن العناوين.
لم تظهر غالبية هذه القصائد إلا بعد نصف قرن من وفاتها. فهي ظلت مجهولة ومخفية طوال حياة الشاعرة التراجيدية التي توفيت عن 55 سنة (1830-1886). وما خلا قصائد قليلة كانت أرسلتها بخفر، إلى ناقد أدبي شهير يدعى ثوماس وينتورث هيغنسون، كي يبدي رأيه فيها، ظلت الشاعرة تهرب من الشهرة، وتتحاشى النشر، متوارية في حديقة منزلها، لا تستقبل زواراً إلا نادراً. فهي كما يقول إسماعيل "كانت تعلم أنها فوق زمنها، أو سابقة له، وذائقتها تستشرف لا محالة مستقبل الحداثة الشعرية في الشعر الأميركي المعاصر، تماماً كما حدث لاحقاً، وتهافت النقد الحديث على شعرها، وكرسها أيقونة للشعر الأميركي الحديث، في النصف الثاني من القرن العشرين". كان يخامرها شعور بأن أسلوبها لن يستساغ في عصرها، ولن يفهم تمردها، أو تقبل ثورتها على الموروث الشعري والديني والاجتماعي. وعلى رغم هذا ظلت تكتب بالسر والصمت، غير آبهة للشهرة أو الرواج.
بعد 69 عاماً على رحيلها، عمد الناقد ثوماس جونسون (ترجم إسماعيل مقدمته المهمة ونشرها في الكتاب)، إلى نشر أعمالها الكاملة، من دون حذف أو تعديل، وظهرت في شكل كتاب ضخم عام 1955. وهي النسخة المحققة، والنهائية التي اعتمدها إسماعيل في ترجمته البديعة.
ويرى إسماعيل أن ديكنسون كانت تصقل لغتها، وتبتكر منظومتها الرمزية والمعرفية، وتقارب موضوعها من زاويا عدة. وكانت تعرف كيف تتوارى وتتخفى وتراوغ، تنحت وتبتكر وتؤلف، تبني وتهدم في آنٍ واحد، غير خاضعة لتقليد شعري أو نظم عروضي. وكانت تترك مخيلتها تقتحم الممنوع والمحرم، دينياً واجتماعياً، وحتى لغوياً. وكانت شغوفة بالقاموس، ففي كل قصيدة تقريباً تتسرب مفردات صعبة أو "حوشية"، منسية، فقدت رواجها لدى الخاصة والعامة، فكانت تحييها وتجددها، وتدرجها في سياق جديد. يقول عنها الناقد هارولد بلوم في كتابه الشهير "التقليد الأدبي الغربي": "ما عدا شكسبير، تتجلى ديكنسون أكثر أصالة معرفية من أي شاعر غربي آخر منذ دانتي. قد يكون أقرب ند لها هو بليك، الذي أعاد تعريف المفاهيم كلها لنفسه، لكن بليك كان صانعاً منهجياً للخرافات، ونظامه ساعد على تنظيم تأملاته. أما ديكنسون فأعادت وحدها التفكير في كل شيء، وكتبت تأملات غنائية وليس دراما مسرحية، أو ملاحم شعرية - أسطورية. واكتفت ديكنسون بالحرف الكبير لضمير الأنا، لتبدع فناً من الاختزال الفريد".
قصيدة اللغز
تأخذ قصيدة ديكنسون شكل اللغز وفحواه، حتى لتغدو القصيدة أحجية أو متاهة. ويقول إسماعيل: "قد نقلب القصيدة على وجوه كثيرة، وننظر إليها من زاويا مختلفة، ونستبدل إشارة بإشارة، ودلالة بدلالة، لكنها تظل نائية، وشاهقة، بعيداً من الأفكار أو الفلسفات أو الشروح الأكاديمية". في هذا الصدد يقول هارولد بلوم أيضاً عن قصيدتها: "صعبة جداً ووعرة بقدر ما هي متميزة، ولا تسلم نفسها إلا لقراءة عميقة بدئياً، وليس للأيديولوجيا أو الحماسة الجدلية، مهما كانت وديعة في بعدها الاجتماعي".
تستحق ديكنسون، بحسب إسماعيل، أن تسمى رائدة الشعر الحديث في اللغة الإنجليزية في أميركا وخارجها. فهي فتحت الأبواب أمام التجديد، وحرضت الأجيال التي جاءت من بعدها إلى الغوص أعمق في مناطق عذراء مجهولة. وفي هذا القبيل تدين لها بالتجديد معظم شاعرات القرن العشرين في أميركا، ومن أبرزهن سيلفيا بلاث وإليزابيث بيشوب وماريان مور وريتا دوف، وسواهن. ويرى أيضاً أن الشعراء الذكور لم ينجوا أيضاً من سطوتها الخلاقة فوقع تحت تأثيرها شعراء من أمثال عزرا باوند وت. س. إليوت وروبرت فروست وألن غينسبرغ ومارك ستراند وولاس ستيفنس وسواهم. ولا عجب أن تكون ديكنسون قد بدأت ثورة نسوية في الشعر، كما فعلت الإغريقية سافو، ربما من غير تعمد، فألهمت معظم الحركات النسوية الحديثة في أميركا. و"قد ألغت ديكنسون التصنيف الجاف بين الذكوري والأنثوي في الكتابة، وخرجت كلياً عن التنميط الجاهز للذات المبدعة. لقد راهنت على نص يكسر حدود الجنسانية والنمط".
لقبت ديكنسون بالشاعرة العذراء، والمتوحدة، والمتنسكة، فهي لم تغادر بلدتها الصغيرة أمهرست، في ولاية ماساتشوستس، ويقال إنها في سنواتها الأخيرة مكثت أسيرة غرفتها داخل البيت. وعزفت عن الزواج، وراسلت من أحبت. وورد في سيرة لها بالفرنسية أن شخصين حاولا الاقتراب منها، الأول هو بنجمان فرانكلين نيوتن الذي استطاع أن يدخل حياتها ثم تم إبعاده عنها لإصابته بالسل، والثاني يدعى شارل واسدورث، عازف بيانو وباستور معروف، كان متزوجا، لكنه ابتعد عنها لئلا يشاع عنه أنه وقع في تجربة الخطيئة، علماً أنها كانت معجبة به. واللافت أنها كتبت نحو 300 قصيدة حب مفعمة بالشغف، ولكنها غير موجهة إلى أحد. تقول: "أيها الحب/ محتجب أنت/ قلة قليلة/ تراك/ يبتسمون/ يتبدلون يثرثرون/ ويموتون/ السعادة/ نشاز/ لولاك/ لهذا نعتها الله/ بالأبدية".
سميت إميلي ديكنسون "شاعرة العزلة"، وربما أقصى العزلة، هي التي تقول "لولا العزلة لكنا، ربما/ أكثر عزلة"، لكنها عرفت كيف تملأ شقوق عزلتها بالتأمل والإصغاء والإبداع، فراحت تقرأ العالم وأسراره على طريقة المتصوفة الكبار، وتتصدى للقضايا الشائكة، الوجودية والكونية، كالموت والحب والخلود والله. وكانت تختبر علاقة الفرد بالخالق، وعلاقة السماء بالأرض، وعلاقة الدين بالطبيعة. ويرى إسماعيل أن "من هنا تحضر في شعرها استعارات شتى مأخوذة من الكتاب المقدس، لكنها لا تجد حرجاً في تطويعها وتليين محتواها الإلهي، كي يتناغم النسبي مع المطلق، ويقترب الأرضي من السماوي"، لكنها لا تخفي نزعتها الشخصية دينياً شكها العميق وتحررها من الطقوس التي تفرضها المؤسسة الدينية، ورفضها التزمت والطهرانية. فالدين لديها مرتبط بالإيمان الحر الذي يتخطى المؤسسات: "البعض يمضي الأحد ذاهباً إلى الكنيسة/ وأنا أمضيه جالسة في المنزل/ منشدي هو العندليب/ وقبتي البستان/ البعض يمضي السبت بثياب الكهنوت/ وأنا أكتفي بارتداء جناحي/ وعوضاً عن أن أقرع جرس الكنيسة/ بلبلنا الصغير/ يغني".
حياة العزلة
لم تكن سيرة إميلي ديكنسون صاخبة وحافلة بالوقائع، فهي جاءت إلى العالم كالشبح، وغابت كالشبح. ولدت في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 1830 في بلدة أمهرست، التابعة لولاية ماساتشوستس، وتلقت تعلميها في المدارس والكليات المحلية هناك. والدها هو إدوارد ديكنسون، المنخرط في عالم السياسة حتى النخاع، وقد انتخب عضواً في الكونغرس الأميركي لفترة برلمانية واحدة. شقيقها أوستن عمل في سلك المحاماة، وتزوج من صديقة إيميلي الأقرب إلى قلبها، سوزان جيلبرت. أما شقيقتها الصغرى، والوحيدة، لافينيا، فقد عاشت معها في المنزل نفسه، ولطالما كانت تلعب دور الناصح الأدبي لها، طوال حياتها، بل هي التي أنقذت شعر شقيقتها من الضياع أو الحرق، ولم تصغ إلى وصية أختها الكبرى بحرق قصائدها، فلم تحرق سوى بعض من قصاصاتها الثانوية، وحافظت على الإرث الكامل لقصائدها ورسائلها. وهذا ما يذكرنا بوصية كافكا إلى صديقه الوحيد بحرق كتبه. من جهة أخرى، لم يعد خافياً أن ديكنسون كانت متأثرة أيضاً بالمدرسة الميتافيزيقية الإنجليزية، التي تضم شعراء بارزين من القرن السابع عشر من أمثال جون دن وأندور مارفيل وسواهما، كما أنها كانت قارئة نهمة للكتاب المقدس. كانت معجبة أشد الإعجاب بشعر شكسبير وإليزابيث باريت براونينغ وجون كيتس، لكنها على نقيض هؤلاء، وعلى نقيض معاصرها الكبير ووالت ويتمان، اختارت الابتعاد عن وهج القصيدة الرومانطيقية المشبعة بالعاطفة المتفجرة، وكتبت القصيدة الهادئة، الموجزة، الزاخرة بالصمت.
وقد شكلت ديكنسون مع ويتمان، ثنائياً أدبياً مبدعاً ومرعباً، أطلق حركة الحداثة في الشعر الأميركي المعاصر، وترك أثره على الخطاب الأدبي الأميركي على مدى أجيال شعرية متتالية. وعلى رغم غزارة إنتاجها الأدبي، ووفرة قصائدها، التي اعتادت أن تحزمها في لفائف صغيرة وتخفيها عن الأنظار، ظلت مجهولة تقريباً خلال سني حياتها. وكما يقول المحرر الأدبي ثوماس جونسون في مقدمته لأعمالها الكاملة، كان على القراء الأميركيين والأنغلوساكسونيين أن ينتظروا حتى عام 1955 لتظهر أعمالها الكاملة للمرة الأولى، مرتبة ومبوبة ومؤرخة، كما تركتها الشاعرة، بعد سلسلة من الإصدارات لم ترق إلى مستوى عبقرية ديكنسون. وبعد وفاتها اكتشفت عائلتها كنزاً مؤلفاً من 1775 قصيدة، كانت قد أخفتها الشاعرة عبر السنوات، ورزمتها بخيطان وإبر، في شكل أضاميم ورقية، مؤلفة من خمس أو ست صفحات للرزمة الواحدة. هذه القصائد كتبت بخط اليد، مع استخدام معترضات كثيرة بين الجمل، وعلامات ترقيم نافرة في أماكن غير متوقعة.
رحلت إميلي ديكنسون بعدما عاشت الموت خلال حياتها، هي الناسكة، العاشقة بصمت، المتصوفة بملء شغفها، المصغية الى كلام يأتي من داخلها ومن فوق. كان شعرها هو مثواها الأول والاخير، مثوى الحياة ومثوى الموت. تقول: "أشعر بجنازة في دماغي/ والمعزون، ذهاباً وإياباً،/ يدوسون/ يدوسون/ حتى بدا/ أن ذاك المعنى يتفتت إرباً./ وحين أخذ الجميع مقاعدهم/ طقس كالطبل/ بدأ يقرع، يقرع/ حتى ظننت/أن عقلي أصيب بالخدر".
وتكتب عن مشهد الميت: "كان دافئاً/ في البدء/ مثلنا/ ثم اعترته برودة/ كمثل الصقيع على الزجاج/ إلى أن تلاشى المشهد./ الجبهة استنسخت الحجر/ الأصابع ازدادت برودة/ لأنها لن تشعر بالألم/ ومثل بحيرة من جليد/ العينان الحائرتان/ تجمدتا/ الجسد سجي/ هذا كل ما في الأمر/ كدس برداً على برد/ وضاعف اللامبالاة/ كالفخر وصل منتهاه. وحتى عندما أنزلوه بالحبال/ ككيس من الأثقال،/ لم تصدر عنه إشارة، لم يحتج،/ ووقع متصلباً كحجر".
تقول إميلي ديكنسون في تعريف الشعر كأجمل ما يمكن تعريفه به: "إذا قرأت ديواناً وشعرت بأن جسدي كله بارد تماماً حتى أن لا نار يمكنها تدفئته، أدرك أن هذا هو الشعر".