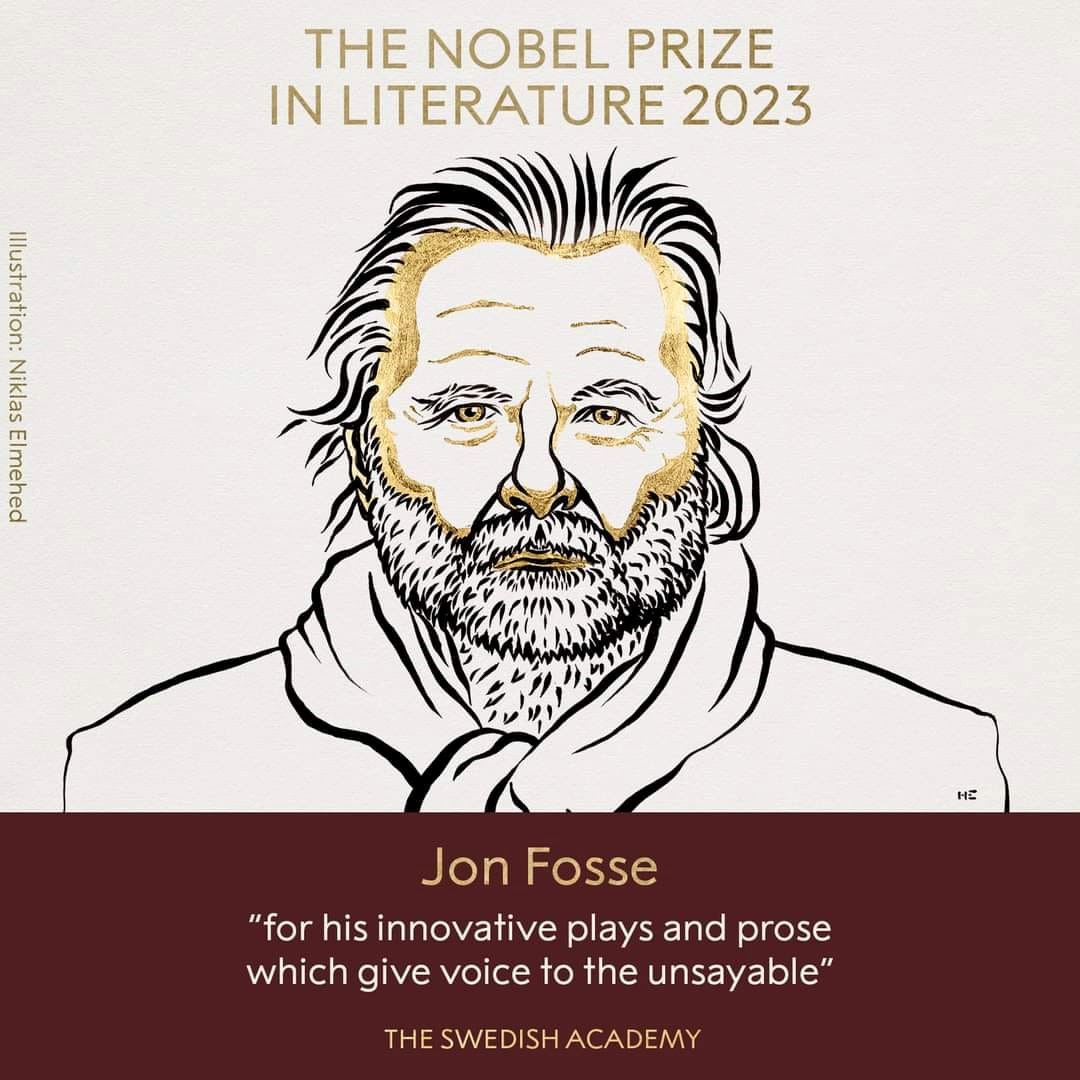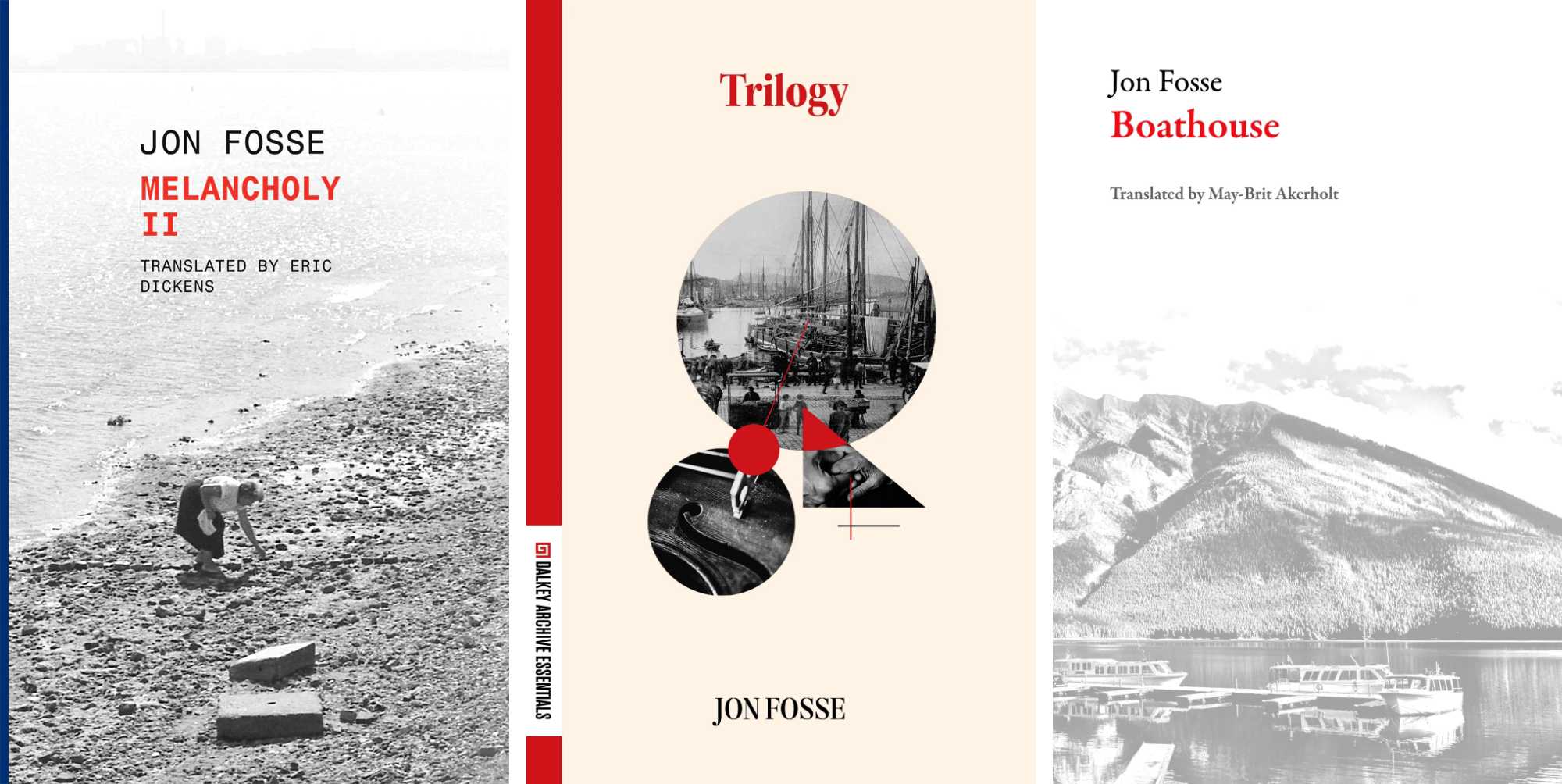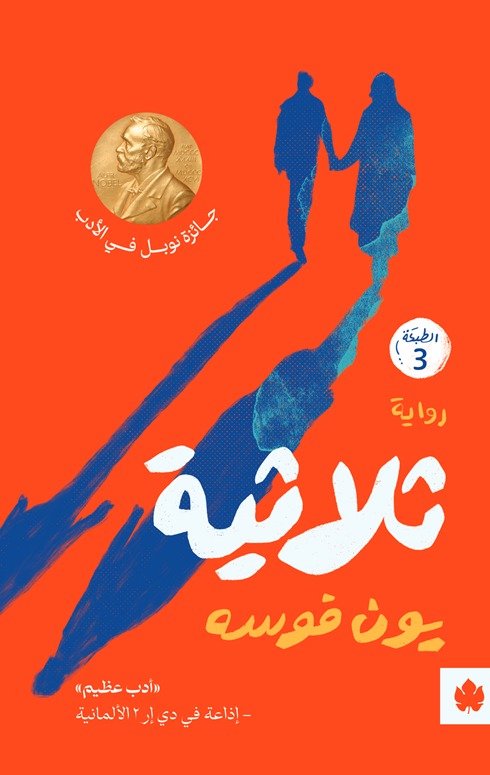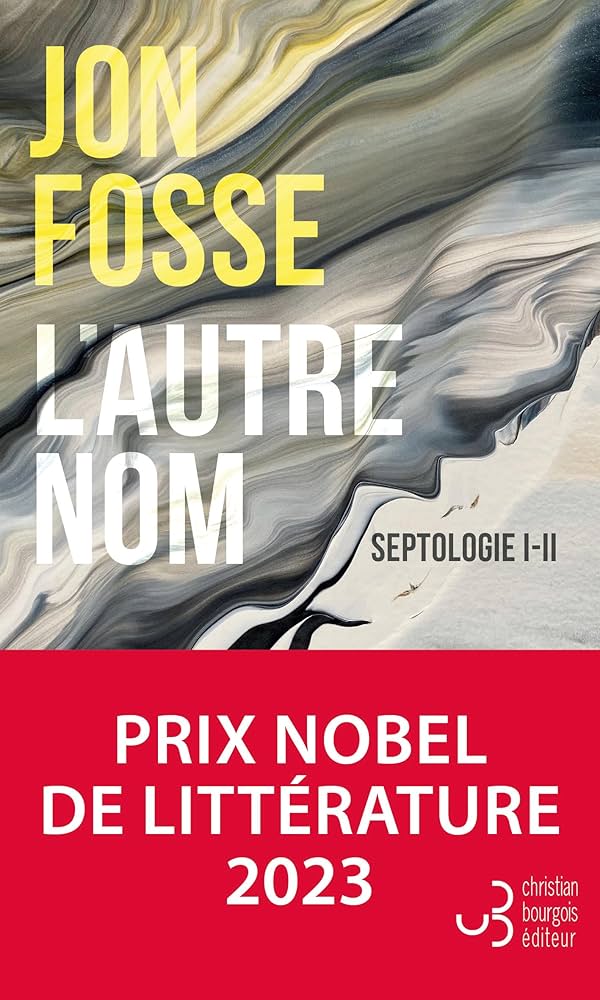ملخص
عندما فاز الروائي والكاتب المسرحي النرويجي يون فوس (1959) بجائزة نوبل للآداب عام 2023، اكتشتف الأوساط الأدبية العالمية علماً من أعلام الأدب الحديث وما بعد الحديث. لم يكن فوس يتمتع بشهرة كبيرة سابقاً، لكنه سرعان ما احتل الواجهات ونقلت كتبه الى لغت شتى.
يون فوسه كاتب نرويجي، ولد في مدينة هاوجيساند عام 1959 وكانت بداية تألقه ككاتب مسرحي سرعان ما حظيت أعماله بشهرة عالمية منقطعة النظير، وترجمت أعماله إلى أكثر من 40 لغة حية، إذ بلغ رصيده في المسرح أكثر من 20 مسرحية، وهي الأكثر تأدية في العالم، ومنها "لن نفترق أبداً" و"أنا والهواء" و"الأيام تمضي" و"هواء شديد" و"الولد" و"الابن" و"الليلة تغني" و"حلم خريف" و "نمْ يا ولدي" و"زيارات" و"جميل" و"تنويعات على الموت" وغيرها، وهي أعمال يُستشف منها أن "البشر تائهون ولا وجهة سديدة لحياتهم، مما يدفع بعضهم إلى تجارب عميقة تدنو من الإلهيات"، على ما يقول رئيس لجنة نوبل للآداب أندرز أولسون حين الاحتفال بتتويج مواطنه بالجائزة عن مجمل أعماله.
والحال هذه لا يمكن اقتصار أعمال يون فوسه على المسرح، وإنما تعدتها أيضاً إلى الرواية التي شكلت سباعيته، وهي كناية عن سبعة أجزاء، ذروة نتاجه القصصي، وقد جُمعت في ثلاثة مجلدات، الجزءان الأولان بعنوان "الاسم الآخر" الصادران عام 2021، والمجلد الثاني بعنوان "أنا هو آخر" الصادر عام 2024، ولئن بلغ الكاتب جون أولاف فوس الـ 64 من عمره فإنه أكثر الكتاب النرويجيين تداولاً في البلاد منذ إبسن (1828- 1906).
بورتريه أدبي
في سؤال طرحته الصحافية فلورانس نوافيل من جريدة "لوموند" الفرنسية (ملحق الكتب) على الكاتب بعد أن التقته في مقهى بروكل وسط مدينة هاينبورغ آن در دونو، وقريباً من المقاهي التي كان يرتادها الأدباء الألمان الكبار أمثال آرثر شنيتزل وروبير موزيل وتوماس بيرنهارد وغيرهم، كان عن تكريس بلدية "هاينبورغ آن در دونو" لوحة تذكارية باسمه نقش فيها أن الكاتب جون فوس ألّف سباعيته الشهيرة في المدينة النمسوية، وعن الداعي إلى جعل النمسا بلداً متبنى وملاذاً للكتابة، فأجاب الكاتب بأن زوجته نمسوية من براتيسلافا، ثم إن مدينة هاينبورغ حيث هو قريبة للغاية من الحدود السلوفاكية، وهي على بعد 15 دقيقة من الحدود عبر الباص وثلاثة أرباع الساعة من فيينا، وإذ سأل لماذا النمسا وليس سلوفاكيا؟ أجاب بأنه يتكلم الألمانية بيسر بل يتقنها ولا يتكلم اللغة السلافية، ومضى يشيد بمدينة هاينبورغ باعتبارها مكاناً رائعاً ويحبه كثيراً، ويخبر كيف أنه اقتنى كوخا للكتابة ضمن مجمع سكني لعمال مصنع للتبغ طُردوا منه بعد أن أقفل أبوابه إبان العهد السوفياتي.
ولما سئل عن الداعي إلى هذه العزلة واحتمال أن يكون ذلك تجنباً لما يُحصى من إغراءات متصلة بـ "نوبل"، وعلى نحو أيسر مما يحصل له في النرويج، أجاب بأنه يجد في هذه العزلة السلام اللازم للكتابة ويقابله بما لديه في النرويج، حيث يستحيل أن يكون ثمة هدوء للكتابة، ولئن أقر بأن مدينة أوسلو منحته الحق في أن يحيا بما سمي "المغارة"، وهي موضع بات مكرساً منذ عام 1920 لخلوة الشعراء الممنوحين جوائز المملكة النرويجية، فإنها تقع وسط المدينة الصاخب، وهذا من شأنه أن يعطل تركيز الكاتب ويحول دون كتابته.
وعلى هذا النحو أمكن يون فوسه أن يكتب السباعية بعد أن كان شرع فيها بفرنسا، ويروي الكاتب كيف أن فكرة القرين، وهي لولب العمل الروائي الضخم في السباعية، تفتقت عن ذهنه أثناء زيارة إلى فرنسا قام بها رفقة مترجمته اليابانية وابنتها المتزوجة من أحد أحفاد بول كلوديل، وشملت اطلاعهم على مدفن الأديب الفرنسي بقصره في برانغ (إيزير).
طغيان الفكرة
ولدى سؤاله عن كيفية تحول فكرة القرين موضوعاً طاغياً في أعماله، ولا سيما السباعية، يجيب بأن الفكرة انبثقت هكذا فجأة، وأورد اقتباساً من الفيلسوف هايدغر يقول فيه "إن الفن يحدثُ فجأة"، وتفرض نفسها على الكاتب حال انبثاقها، ومن ثم يعود الكاتب للحديث عن هاينبورغ جاعلاً منها عنصراً مؤسساً لكتابة السباعية.
ويتابع الكاتب سرده وكيف أنه كتب نصه الأول من سباعيته في 1500 صفحة، كأنما انسكبت من تلقاء نفسها، أو كما لو أنه كان يتبع جريان حلُم، أو كأنه ماض في سفر هني ومشوق للغاية حتى إنه استغرب كيف أنه تخطى كل حدود الكتابة التي اعتادها في مسرحياته، إذ لم تتجاوز أي منها الـ 100 صفحة، فيما تشبه متونها ما هو مختص بالشعر، وفي هذا تحقيق لمقولة الشاعر فيديريكو غارسيا لوركا التي أحبها كثيراً "المسرح إنما هو من الشعر الذي يلبث صامداً".
وتابع الكاتب تعليله حول انشغاله بفكرة القرين بالقول إنه كان سبق له أن استثمر الفكرة في كتابته مسرحية سابقة جعل فيها شخصية شابة تحاور نفسها، وقد صارت عجوزاً، كما أن له مسرحية جديدة صدرت للتو في أوسلو بعنوان "إيتكفان" (غير مترجمة) تقوم على الثيمة نفسها، ويقول الكاتب فوس مفصلاً في الكلام على مضمون المسرحية ما مفاده أن ثمة ثلاث شخصيات فيها، الأب والأم وابنهما، ويعاني كل منهم معاناة شديدة في التواصل مع الآخر، ذلك أن كلاً منهم هو قرين الآخر، ويحادثون بعضهم بعضاً على أنهم كذلك، ويقر الكاتب بأنه تأثر بمضمون المسرحية لما عاود قراءتها شديد التأثر، إذ وجد فيها شحنة وازنة من الوحدة.
الكتابة هي الإنصات
ولدى سؤال الكاتب عن الدافع الذي جعله يكتب "السباعية" من دون جهد، وكيف أن كتابتها انسابت بين يديه انسياباً؟ وإن كان الأمر طبيعياً؟ أجاب بأنه كان يصحو كل صباح في الثالثة أو الرابعة فجراً، وكان يعمل ما بين خمس وتسع ساعات متواصلة ومن دون أن يحضر القارئ في باله ولا المشاهد، ومن دون أي تحضير مسبق ولا أبحاث، إنما كان يجلس إلى طاولته وينصتُ ليس إلا. ويضيف الكاتب توضيحاً لفكرة الإصغاء وإبعاداً لشبهة الهلوسة بما مفاده أن الإصغاء يكون لصوت ينبع من ذاته وهو صوته الذي يعبر عنه في ما يكتب، وعليه فإن مصدر هذا الصوت كامن في داخله، ويردف قائلاً "ولكن لا تسلني من أين يأتي بالضبط فأنا لا أعرف شيئاً عنه، ولا أريد أن أعرف شيئاً، وهذا أمر غريب! وما أكتبه يكون مكتوباً في موضع ما وليس علي سوى طرحه على الورق، إذاً هذه ليست صوراً ترتسمُ لذاتي، وفي ما خصني فأعتبر الكتابة نشاطاً موسيقياً حتى إن ما أسمعه يحسن به أن يخلق نوعاً من التأليف الموسيقي لتواتره".
ولدى سؤاله عن مكانة الموسيقى في أعماله، ولا سيما في كتابه "أنا هو الآخر" حيث كان بطل الرواية موسيقياً في شبابه ولكنه انصرف عنها ليقينه بأنه لم يبرع فيها، أجاب بأن تلك الصورة هي نفسها التي تمثل صلته بالموسيقى، إذ كان في مراهقته عازفاً على الغيتار الكلاسيكي والكهربائي، وقد بلغ درجة الإتقان في العزف إلا أن الكتابة صرفته عن الموسيقى، من دون أن يهمل المشاعر المصاحبة للأداء الموسيقي في كتابته، ومحاولاً أن يعيد خلق التصاوير الإيقاعية المتناسبة مع المواضيع والتنويعات واللازمات، وهذا من شأنه أن يخلق انطباعاً بأنه يصنع من أدبه موسيقى خاصة.
عودات وإيقاعات
وعن تكرار العبارات وعودتها في أجزاء من الروايات مختلفة ومتنوعة التراكيب، ومن دون علامات وقف أحياناً كثيرة، سألته الصحافية فأجابها بأن تلك العودات وتكرار الصيغ الكلامية ليست من الموسيقى في شيء وإنما هي تؤدي وظيفتها باعتبارها ضربات أو نبضات موقعة داخل النص، وقال إن للوقفات ولمحطات الصمت في النص المسرحي النثري وظيفة أيضاً، وربما تكون فسحة للتأمل في ما سبق قوله أو كتابته.
وفي موضع آخر من المقابلة أجاب الكاتب عن سؤال الصحافية عن مكانة الرسم في أعماله الأدبية، ولا سيما في روايتيه "ميلانخوليا 1" و"ميلانخوليا 2"، إذ يكون بطل الروايتين رساماً، بأن تلك المكانة محفوظة حتماً للرسم، وبأن نظرته إلى الفن (الرسم) لم تعد ذاتها بعد تعرفه إلى الفنان الأميركي مارك روثكو (1903 - 1970) من خلال معرض أقيم له في فيينا لدى افتتاح "متحف اللقى التاريخية" عام 2019 فيها، وكان وقع ذلك اللقاء شديداً عليه، إذ قال إنه يخاطب روثكو بطريقة صامتة (طبعاً عبر رسومه المخططة بقسوة وشخصياته المدينية الضامرة وألوانه القاتمة)، ويقوم بما يقوم به في كتابته ذلك أن كل لوحة لديه تنطوي على عالم خاص، بيد أنها تتشكل من كل متكامل، ومع ذلك يبدو روثكو عاجزاً عن الكلام على فنه، أبداً مثل الكاتب الذي لا يني يعبر عن عجزه عن الكلام على أدبه، أو عالمه الأدبي.
بواكير الأدب
ولدى سؤال الكاتب عن بداياته الأدبية التي ألمح إليها في خطابه بستوكهولم خلال تسلمه جائزة نوبل للآداب عام 2023، وفيه إشارة إلى خوفه من التحدث على الملأ، أجاب بأن ذلك حصل فعلاً في المعهد إذ كان لا يزال تلميذاً، إذ طلب منه أستاذه أن يقرأ له بصوت عال، فتملكته للحال قدرة على الفهم مجنونة مصحوبة في الآن نفسه بعجز عن قول أي شيء، بل شعر كما لو أن الخوف حجبه تماماً عن الأنظار وحبس عنه الكلام، حتى ظن أنه ينبغي له استعادته من حيث هو.
وعلى هذا النحو مضى يون فوسه يكتب قصائد قصيرة ومسارد، وحينها أدرك أن الكتابة تهبه شعوراً بالأمان ما دام يكتب عن أمور تخصه وحده من دون سائر البشر، وتصدر من هذا المكان الداخلي الذي سبقت الإشارة إليه، وهنا يلح على الصحافية ألا تسأله عن هذا المكان أو مصدر المعرفة الذي تأتيه منه كلمات الكتابة، ويورد في هذا الشأن تعريفاً بالكتابة للشاعر النرويجي أولاف هوج (1908- 1994) يقول فيه "إن الكتابة أشبه بكوخ من وريقات الغابة، أوان الطفولة، نتسلل إلى داخله ونشعل شمعة فنشعر بالحماية"، ويضيف قائلاً "اليوم لا يزال ينتابني الشعور نفسه بعد انقضاء 50 عاماً، وها أنا أواصل الكتابة من داخل ذلك الكوخ".
ولما سألته الصحافية عن هذا الانطباع بالنعمة الكبرى والشعور بالحماية لكونه في ملاذ متوارياً عن الأنظار، وقد توجه في تأليفه "السباعية" فكانت أسعد أيام حياته كاتباً، أجاب بأن الكتابة الروائية تتيح له أن يُخرج أموراً جديدة كل حين، أمور لم يكن لها وجود، إذاً فهو يعتبر الكتابة الروائية مغامرة غير محسوبة تدخله في المجهول، أما في المسرح فيكون الشعور بالحماسة مختلفاً، وهي لحظات التواصل مع الجمهور ما يرضيه.
ثم يضيف في هذا الشأن عبارة للهنغاريين دالة على هذه اللحظات المكرسة الصغيرة، إذ يقولون "إن ملاكاً عبر المشهد"، وهذا غالباً ما يحدث في الأعمال الإخراجية الكبرى، حين يكون كل شيء مضبوطاً، وفي مكانه تماماً، وعندئذ يعم تفاهم عميق بين خشبة المسرح والصالة، تفاهم حول ماذا؟ مرة أخرى لا نجد من الكاتب تفسيراً لذلك.
من المسرح إلى الرواية
وقال الكاتب يون فوسه لما سئل عن ظروف انتقاله من الكتابة المسرحية إلى الرواية، إنه في ثمانينيات من القرن الماضي كتب شعراً وروايات، وفي التسعينيات كتب المسرحيات على مدى 15 عاماً متواصلة، والحال كان أن الملل قد أصابه بعد هذه المدة، وبات عليه أن يغير في حياته، وقال "كفاني سفراً وكفاني شرباً وشرباً بغزارة، وبات علي أن أغير حياتي فقمتُ بذلك وأردت العودة للنثر الذي باشرتُه، وأنا في الـ 23 من عمري حين أصدرتُ باكورتي الروائية 'أحمر أسود' غير المترجمة بعد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثم أشار إلى الطاسة حيث خليط القهوة والحليب، وقال إنه لمن المستحيل أن يكتب المرء 20 صفحة في المسرحية عن هذه الخلطة، في حين أن ذلك ممكن في الرواية، وهذا ما أراده، أن يعمل على كتابة بطيئة (نثر بطيء)، ولكنه ظل أعواماً طويلة لا يقوى على المغامرة بهذه الكتابة، ولم يكتب شيئاً وإنما اكتفى بالترجمة.
في مهب الهواء والبحر
وفي معرض سؤال الصحافية عن أجواء طفولة الكاتب، تقتبس من إحدى مقابلاته بمجلة لوموند عام 1999 قولاً له "إن الكتابة أشبه بأن يكون المرء على مركب وسط المياه، تؤرجحه الأمواج، ويقلبه إيقاعها، بينما لا يفصلك عن اللجة في المركب سوى هيكله الرقيق"، وتسأله عن حضور الهواء والمياه في أعماله حتى لو كانت غالبية هذه الأعمال قد خُطت في النمسا فيقول "كبرتُ قريباً من جبل الجليد المسمى هاردانجر، وكان لأبي قارب يأخذني معه إلى الصيد، ولطالما أحببتُ الأمواج والهواء والعتمة التي تجدينها، في الواقع في عدد من كتبي، لم تكن الطرق، في هذه المناطق مضاءة، في ذلك الزمن، وكنتِ ترين، من البحر ضوء المنزل، ثم ترين سواداً، ثم ضوءاً آخر، وفي أعمالي كان هذا خليقاً بأن يُحدث ما دعوته بالنرويجية الجو".
ولدى سؤال الصحافية الكاتب عما تعنيه عبارة لجنة نوبل للآداب في وصفها "نتاجك المسرحي ونثرك المجددين اللذين منحا صوتاً لما هو عصي على القول، حتى أنه لُقب بكاتب الصمت"، أجاب قائلاً "نعم صار هذا التوصيف متداولاً ومكرراً وبات شعاراً، ولكنني هكذا أرى الأمور، وبصورة خاصة في مسرحياتي حيث مضيتُ بعيداً في استخدامي الوقفات، من أجل أن أخلق ما يمكن تسميته باللغة الصامتة، إذا يقضي عملي بالبحث عن الصمت لجعله يتكلم، ولهذا أقبل بأن أسمى 'كاتب الصمت' ولا أطمح أبعد من ذلك، وقد يكفيني أني أتقن كتابتي، وبها أعلل سبيلي في قول الصمت، ذلك أن ما يهم في سلوك الصمت هو الصفحة البيضاء الذي يحسن استخدامه ليبلغ به صاحبه مقاماً من الروحانية عالياً، على حد تعبير كلود ريجي".
في النقطة الأخيرة من مقابلة الصحافية نوافيل والتي تتعلق بانتماء الكاتب إلى المذهب الكاثوليكي وأثره في رؤيته الأدبية، أجاب بأن في القداس الكاثوليكي التكرار والصمت، وأن فيه صيغاً ليتورجية متكررة ومتكررة إلى المنتهى، ذلك أن التكرار يتيح، بحسبه، للمؤمن التقرب من الله، أما بالنسبة إلى الصمت فيقول الكاتب إنه بات أقرب إلى مذهب الكواكر (مذهب نشأ في القرن الـ 17 على يد منشقين عن الأنغليكان ويدعو للعودة إلى عيش المسيحية الأولى القائمة على التقشف والصلاة والصمت)، وأنه يواصل الشعور بالأمور شأن الرهبان الكواكرز حين يجلسون في وضعية الدائرة، بصمت تام، ويحاولون التركيز على النور الداخلي، بمعنى على الجزء الإلهي الذي يحمله كل امرئ في ذاته.