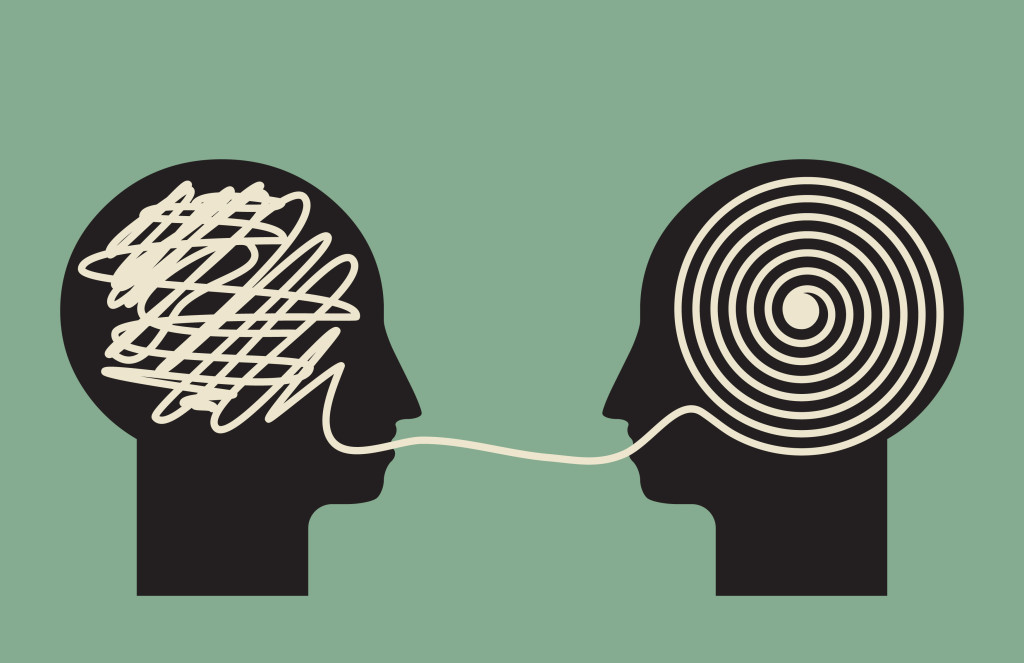الأرجح أنّ مسألة علاقة ترجمة العلوم إلى اللغة العربيّة، تمتلك أبعاداً متشابكة. لعل أبرزها هو توقّف العرب أنفسهم عن إنتاج العلم، منذ قرابة 5 قرون. ربما أكثر قليلاً، لأن كتابات إبن خلدون، وهو أخر التماعة في مصباح الإنتاج العلمي في الحضارة العربيّة- الإسلاميّة، إنما تناولت علم الاجتماع.
عندما توقّف العرب عن إنتاج العلم، بل حتى التفاعل المُجدي معه، كان الأُسطرلاب هو الآلة الأكثر تقدّماً التي أنتجوها. لم يكن التلسكوب والميكروسكوب والكهرباء والإلكترونيّات والطائرة والصاروخ والكومبيوتر والخليوي ونظريات النسبيّة والكموميّة والرياضيات الحديثة والنانوتكنولوجي و...و... و... قد ظهرت إلى الوجود. لم يُساهم العرب في هذا الركب العلمي. حتى في علم وصفي مثل تشريح الجسم البشري، ثمة صعوبة هائلة في الترجمة، وأما عن بقية علوم الطب، فحدّث ولا حرج. ربما كان التوقّف عن المساهمة في العلم، هو الجذر الأقوى في صعوبات الترجمة إلى العربيّة، لأن ذلك يعني أن الحاجة الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة (بل حتى السياسيّة) لتطوير اللغة وتطويعها، ليست موجودة. وربما كان هذا الأمر هو الخلفيّة التي تتحرك عليها الصعوبات التي يكثير الإشارة إليها في ترجمة العلوم إلى العربيّة، مثل مسائل الاشتقاقات والسوابق واللواحق، مع ملاحظة أنها مسائل فائقة الأهمية بحد ذاتها أيضاً. وبديهي القول بأن الاتّفاق على طرق صوغ الاشتقاقات والسوابق واللواحق في اللغة العربيّة (وهي ليست قصراً على العلوم)، ليست موحّدة أيضاً. ويستحضر هذا الكلام تجارب "مأساويّة"، مثل الجمود الذي تعانيه المُجمّعات اللغويّة العربيّة!
في مقابل ذلك الجمود، تسير اللغة "الحيّة" عربيّاً، أي اللهجات المحكيّة، في تطوّر ملفت. إذ يألف كثيرون من الشباب العربي استعمال أحد الطرق المهمة في الترجمة، وهي الاستخدام المصطلح الأجنبي في الطريقة التي ينطق بها عربيّاً ثم معاملته ككلمة عربيّة، مثل "تلويد" (ترجمة للإنزال المواد من الإنترنت Down Load)، و"تمسيج" (أي بث رسالة خليوي) و"إس إم إس" SMS و"لنك"Link و"نت" Net و"هاكر" Hacker. وبسهولة يشتق فعل "فَكِّس" من فاكس Fax، ويقول "غوغِلها" في الإشارة إلى البحث على محرك "غوغل"، و"بَلْوغت" في الإشارة إلى الكتابة على المُدوّنة الإلكترونية Blog وغيرها. هل يتوجب على اللغة العربيّة ان تتوسع في هذا الإتجاه؟ مجرد اقتراح!
اللغة كائن حي يحتاج إلى التطور والتغيير كي ينمو ويستمر
"صُبْح الأعشى" وزمن الأسطرلاب
في مؤتمر علمي عربي استضافته مدينة "فاس" المغربيّة في 2008، خُصّصت جلسات لنقاش اللغة العربيّة والعلوم. وتحدث أحد خبراء اللغة العربيّة، وهو أستاذ في جامعة الخرطوم، رافضاً أن يكتب العلماء العرب شيئاً بغير لغتهم، لأن ذلك الأمر خيانة، وفق رأيه. ورأى أنّ اللغة العربيّة قادرة على التعامل بسهولة مع العلوم الحديثة كافة، مستشهداً بالأبيات الشهيرة لحافظ إبراهيم التي تتحدث عن قدرة اللغة العربيّة على استيعاب التنزيل الإلهي، ما ينفي عجزها عن التعامل مع التقنيات الحديثة ومصطلحاتها. (وسعت كلام الله لفظاً وغاية/ وما ضِقتُ عن آيٍ به ومعان// فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة/ وتنسيق أسماءٍ لمخترعات).
وإذ ناقشه بعض الحضور في المشاكل الجمّة التي تواجه تلك اللغة في ترجمة العلوم، ردّ بأن عليهم الرجوع إلى فهرس "صبح الأعشى" لأبو العباس القلقشندي، كي يتزودوا منه بما يلزمهم!
في المقابل، سأتحدث عن مثالين بسيطين عشتهما. فأثناء ترجمة "أساطير وحكايات خرافية لشعب الباسك"، واجهتُ مشكلة عويصة. وتمثّلت في أنّ ذلك النص مترجَم عن الباسكيّة القديمة، التي اندثرت تقريباً، ومكتوب بلغة إنجليزية تعود إلى العام 1884. وعلى رغم قصر المسافة نسبيّاً التي تفصلنا عن زمن كتابة النص، إلا أنّ اللغة الإنجليزية تطوّرت خلال تلك الفترة البسيطة، فاكتسبت كلمات كثيرة معانٍ لم تكن لها في الأصل.
وبقول آخر، أدى تغيّر السياق الزمني إلى إعطاء تلك الكلمات معنى آخر. وصار لزاماً العودة إلى قواميس تشرح السياق التاريخي للكلمة، كي يُفهم ذلك النص. كيف تغيّرت لغة في أقل من 150 سنة، من دون أن تعاني ولا تفترض "خيانة" هويتها في هذا التغيير؟ ما علاقة ذلك بالانتشار الهائل لهذه اللغة عالمياً، وقبله سيولة علاقتها مع العلوم؟ أسئلة تحتاج إلى تعمّق.
في تجربة أخرى، ظهر أثناء ترجمتي لكتاب "نظرية الفوضى: علم اللامتوقع" مفردة مثير للتأمل: الـ"فراكتال" Fractal. وفي القواميس، تشتَق تلك الكلمة من "فراكشن" fraction، وهي كسر العدد، خصوصاً الكسر العشري. ولكنها تستعمل في نظرية الفوضى لوصف عملية حسابية معقّدة، تنطلق من كسر الرقم واحد، كي تشتق منها أرقاماً يؤدي رسمها بيانيّاً إلى ظهور أشكال شديدة التعقيد، لأنها تبتدأ من رسم بسيط ثم تُكَرّره، لكنها تتغيّر عند كل تكرار، فلا يعود التالي يشبه السابق تماماً، على رغم أنه تكرار لمواصفاته الأساسية. واستعملت نظرية الفوضى هذا المصطلح في محاولتها تفسير أشياء مثل أشكال الغيوم.
زرع في تربة اللغة
استطراداً، تستعمل كلمة الـ"فراكتال" في الكومبيوتر لصنع تلك الأشياء المتراقصة التي تتكرر على الشاشة ولكنها تتغيّر أيضاً باستمرار. ولذا، ترجمتُ "فراكتال" بمصطلح من كلمتين "التكرار المُتغيّر". ولا يوجد في قواميس اللغة العربيّة ترجمة للـ"فراكتال"، إلا باعتبارها كسراً. إنها ترجمة تعتمد على السياق، وليس ترجمة تفترض أن المعاني أُفْرِغَتْ من الألفاظ بحيث يستحيل على السياق (في اللغة أو الزمن) أن يغيّرها.
ولربما وُصِفَ ذلك التصرف بالترجمة استناداً إلى السياق، بأنه جرأة أو خيانة مفرطة. وفي المقابل، ثمة من يرى الترجمة زرعاً لكائن حيّ في أرض وبيئة مختلفة ومُغايرة عن الأصل، ما يفرض ضرورة التدخل الواسع لضمان استمراره في الحياة. وأما أن يُصبّ ذلك الكائن المُقتلع في قوالب جامدة ومُعطاة بصورة شبة أزليّة، فذلك ربما أقرب إلى السعي للقتل ما ذلك الكائن الحيّ.
إذاً، هل اللغة كائن حيّ فعلياً، بالمعنى الواسع لكلمة حياة، أم أنه بنيان أصم مصمت بحيث لا تكون الإضافة إليه إلا صبّاً للجديد وسبكاً له في قوالب ذلك البنيان، كي يأتي دوماً على شاكلته؟ يدور كثير من النقاش عن اللغة العربيّة والترجمة، إنطلاقاً من القول الثاني. ألا يبدو ذلك أقرب إلى إدارة الظهر للإمكانات الهائلة للغة العربيّة؟ هل منطقي الإصرار على استعمال قوالب جاهزة تصلح لكل مكان وزمان وحاجة وعلم، مهما تغيّرت تلك الأشياء وتبدّلت! في هذا المعنى، تبدو اللغة وكأنها نوع من "ديانة" مضمرة، وربما يجد القائلون بهذا الأمر سهولة في الانتقال من النقاش عن اللغة إلى الحديث عن الدين. ألا يستلزم ذلك بعض التروي والتفكير النقدي؟