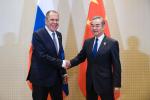بعد مرور 15 سنة على رحيله، يعود الممثّل المصري الكبير أحمد زكي إلى الواجهة، بعد انتشار خبر عن اعتزام جهة إنتاجية إنجاز مسلسل بعنوان "الأمبرطور" عن سيرته. رافق هذا الخبرَ جدل كبير بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها، خصوصاً أن ممثّلاً لم تعرف له موهبة استثنائية إلى الآن، هو محمد رمضان، سيتولى تجسيد دور عبقري التشخيص الذي رحل عن عمر 55 سنة، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، فتحوّل مع الوقت إلى أسطورة، والأمانة تقتضي تالياً أفلمة سيرته على نحو يحترم مكانته في السينما المصرية. انقسم محبوه بين مَن وجد مثل هذه الأفلمة مشروعة، في حين رأى آخرون أن الممثّل ما كان وافق عليها لو كان لا يزال على قيد الحياة. أياً يكن، هناك جيل كامل من العرب، لا يعرف أحمد زكي جيداً، ولم يشاهد أفلامه ولم يتعمّق في فكره، ولم يطّلع على تقنياته التمثيلية. لذا، قد يبدو الوقت مناسباً الآن، أكثر من أي وقت مضى، للعودة إلى هذه الأيقونة التي لم تشهد السينما العربية مثيلاً لها في تاريخها.
ثمة مَن يعتبر زكي نموذجاً ساطعاً للممثّل العربي، وبعضهم الآخر يرى فيه روبرت دنيرو الشرق. ولطالما دار نقاش لمعرفة إذا كان ممثّل "منهجية"، أي من أتباع الـ"أكتورز أستوديو"، أم أنه ينصت إلى غريزته والصوت الذي يأتيه من الداخل، لا إلى تقنية صارمة ملزم بها. على هذا التساؤل، يرد زكي أنه قرأ كتب ستانيسلافسكي الثلاثة، وخرج منها بخلاصة واحدة: "ما يخرج من قلب الممثّل يبلغ قلب المُشاهد". الأمر بهذه البساطة عنده، ولكن بلوغ تلك البساطة قد ينطوي على الكثير من التعقيدات. فهذا الذي يخرج من القلب لا يمكن أن يأتي وحده، بل يحتاج إلى الصدق والإحساس الشديدين. يقول في إحدى المقابلات: "عندما يتحدّث المرء في موضوع ما، أو يعبّر عن شخصية معينة، في الفنّ أو غيره، فإن الأمر يتعلق بمدى صدقه. قد يبلغك ذاك الكلام، لكنه لن يدخل قلبك. المهم هو الوجدان. أحبّ أن أحسّ بالأمور، أن أكون صادقاً فيها. أنا من أتباع مدرسة الإغراق في تجسيد الشيء، إتقانه. طالما اخترت مهنة معينة فعليّ إتقانها".
حياة وشخصيات
يروي زكي أن ثمّة أدواراً يحتاج إلى ان يتعرّف اليها، ذلك أن الحياة حافلة بالشخصيات، بالأمزجة المختلفة، بالوظائف والأحلام والإحباطات والانكسارات والطموحات، وكلّ يتعامل مع هذه الأمور على طريقته الخاصة. لطالما حاول، بحسب اعترافه، أن يلتقط هذا الشيء الذي في داخله، من إيمانه الشديد بأن الفنّان، خلافاً لغيره من البشر، قادر على التقاط هذا الشيء الفريد، وغالباً يحدث ذلك من دون أن يعيه. رأى في نفسه مخزوناً من المُشاهدات. في المقابل، لم يحيّد الصراع عن عملية الإبداع الفنّي، معترفاً أن أول شخص يصطدم به هو نفسه، ومن هذا الصدام يولّد أشياء كثيرة. علق قائلاً: "الممثّل كائن متحرك، تجيش في صدره أمور وتنتابه أمور. يتفرّج على نفسه في المقام الأول. يتفرّج على كذبه قبل صدقه، على ضعفه قبل قوّته، وعلى إحباطاته وسعاداته، على الإنسان فيه. لا يرى الإنسان إلا جانباً واحداً في شخصيته. على العكس، لو نظر إلى مشاعره المتناقضة فقد يمنعه ذلك من الكذب. لا ينظر البشر سوى إلى الجانب الإيجابي في شخصياتهم. أما الضعف والكذب والرغبات فإنه لا يسائل نفسه حولها ولا يحاورها كي يشرع في التعامل مع ضعفه أو كذبه. لو انطلق في التعامل الصادق مع نفسه لأبصر أموراً في الآخرين من الأبسط إلى الأعمق، ولألفى نفسه يلتقط أصغر التفاصيل".
طوال نحو 30 عاماً من الصعود والهبوط، من المجد والمعاناة، لعب زكي الكثير من الشخصيات المغايرة والمتناقضة، شخصيات مستوحاة من واقع المجتمع المصري. حيناً رأيناه ميكانيكياً، حيناً مصفف شعر، أو رجل أمن، ثم جسّد الرئيسين المصريين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وهما شخصيتان قدّمهما بأمانة عالية واطلاع واسع على التفاصيل. أداره كبار المخرجين في السينما المصرية، من يوسف شاهين إلى صلاح أبو سيف. ولكن، على الرغم من نجاحه وتفوّقه، لم يعرف طيلة حياته سوى القلق، عاش في داخله وعبره، ابتعد عن النجومية التقليدية والعابرة التي تصبح عبئاً على الفنّان مع مرور الوقت، اعتبرها مجداً زائلاً، ما جعله ينسحب من الحياة الاجتماعية إلى حيث كان يحلو له العيش. يُقال إنه لم يكن له وجود سوى على الشاشة، وعندما ينزل إلى الشارع فقط ليتفرّج على نفسه والآخرين.
مواطن مصري
وكان يعتبر نفسه مجرد مواطن مصري عربي من بين آلاف المواطنين، له حقوق وعليه واجبات، وكان يدرك جيداً أنه ينعكس عليه ما ينعكس على مواطن الشارع العادي. كان القدر قاسياً عليه، لم يمهله الكثير من الوقت، فبعد فترة غير طويلة على تجسيده دور عبد الحليم حافظ، خطفه الموت الذي كان منتظَراً منذ سنوات. مضى من دون أن يحقق كّل أحلامه ومن دون أن نكتشف كلّ احتمالاته كممثّل. عرف بسخائه، ظل معطاء حتى الرمق الأخير، لا تقود خطاه إلا غريزة الحياة والخلق.
عن مدى ارتباطه بالواقع كان يقول إن الفنّان الذي وهبه الله موهبة، يرصد الحياة والناس ليس من أجل الرصد فقط، بل من أجل التأمّل. كالممسك بالريشة ليرسم لوحة، أو الممسك بالعود ليضع لحناً. قال في مقابلة: "التأمل صفة خاصة بالإنسان. إني أحيا على الشاشة نفسياً وإنسانياً. أحب مهنتي كثيراً وأحب تجسيد الشخصيات (...) لكني اكتشفتُ أن ثمة مزجاً بين الإنسان والفنّان، بين الأستوديو الذي أعيش فيه ويأخذ مني معظم أوقاتي، والواقع. ألفيتُ نفسي أحيا على الشاشة. هنا الناس معروفون لي. إنه الواقع الذي اخترته، الشخصية التي اخترتها. أي ثمة اتفاق بين العاملين في الفيلم. أعرف الواقع هنا وأعرف الناس والشخصية. إنما في الخارج، أي في الواقع، فلا أعرف الأشخاص، إذ لا اتفاق بيني وبينهم. لا أعرف ما قد يقوله لي إنسان معين. قد يكذب عليّ، والمطلوب مني أن أصدقه، ويتبين لي أنه كاذب. بينما على الشاشة لا أحد يكذّب عليّ إذ أملك اتفاقاً مع مَن أواجهه".
أضحى زكي الممثّل الـ"فيتيش" عند جيل كامل من السينمائيين الذين أسسوا ما عُرف في تلك المرحلة بالواقعية الجديدة في السينما المصرية. سينمائيون أمثال علي بدرخان وشريف عرفة، محمد خان وداود عبد السيد، خيري بشارة وعاطف الطيب. كان زكي يرجع ذلك إلى حاجة هؤلاء السينمائيين إلى ممثل يعبّر على طريقته. "كلّ هذه الأسماء شكّلت صورة أحمد زكي. حققتُ أربعة أفلام، حداً أدنى، مع كلّ من هؤلاء، وستة أو سبعة أفلام، حدّاً أقصى. إنهم يمثّلون جزءاً كبيراً جداً من مسيرتي الفنية".
يبقى السؤال المطروح اليوم: هل هناك حقاً ممثّل في إمكانه أن يجسّد زكي على النحو الذي يليق به تاريخه، وعلى النحو الذي تستحقه عبقريته؟ فأحمد زكي حالة وجودية خاصة، لا مجرد ممثّل يطل على الشاشة. الفنّان الذي آمن بأنه يملك اتفاقاً مع المتفرج الذي ينتظر مشاهدة أي جديد له، كان عندما ينتهي من أداء شخصية يشعر فوراً بفقدانها. يشعر بالخسارة. التمثيل عشقه إلى حدّ الجنون وعاش أوجاعه.