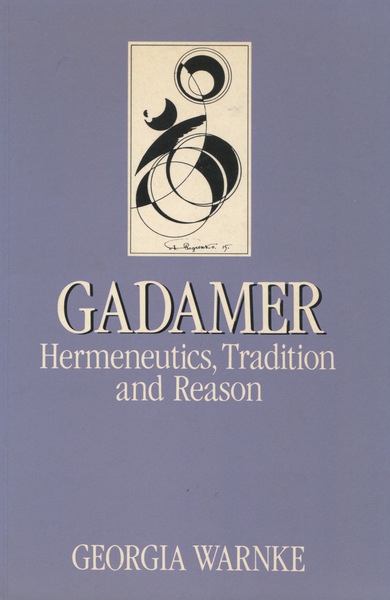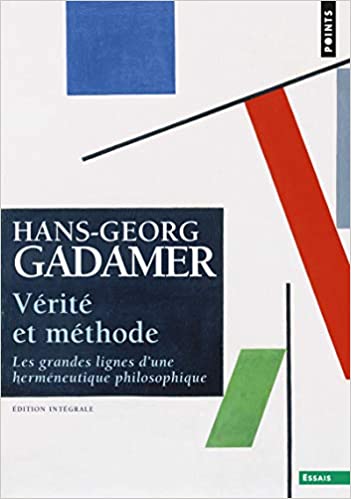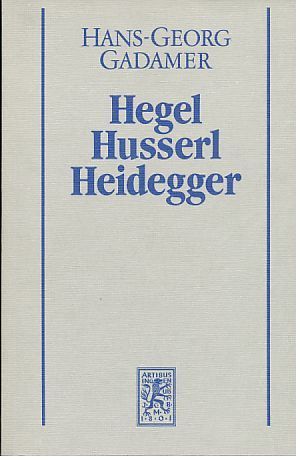لا ريب في أن علم أصول التفسير أو التأويلية أو الفِسارة (على وزن الصناعة) مبحثٌ فلسفي يرقى إلى أقدم العصور. غير أن الفيلسوف الألماني هانس غيورغ غادَمِر (1900-2002) وضعه في سياق فلسفي جديد، إذ أسند إليه وظيفة استجلاء عملية الفهم. لذلك تضحى الفِسارةُ في نظره فن الفهم الذي لا يقتصر على تأويل النصوص، بل يُعنى بتدبر اختبار الإنسان الأشمل في تناوله مسألة الانغراس الوجودي في العالم.
في الكتاب الشهير "الحقيقة والمنهج" (1960)، يعترف غادَمِر بأفضال هايدغر عليه وأثره في تبيان مقام الفهم في كل عملية تأويلية. فالإنسان لا يفسر الحياة في الفراغ المعنوي أو في الحياد الموضوعي، بل يفسرها استناداً إلى شخصيته وانتماءاته وإحساساته واقتناعاته ومبايعاته. ومن ثم، فالفهم يسبق التفسير عند هايدغر، خلافاً للحقيقة القائلة بأنه ينبغي للإنسان أن يفسر لكي يفهم.
استعاد غادَمِر الحدس الهايدغري اللماع هذا، واستثمره في بناء فِسارة فلسفية لا تعتبر المنهجيات التأويلية السبيل الوحيد الذي يُفضي إلى الفهم، بل تتناول الحقيقة بمعزل عن الطرائق التي يعتمدها المفسر. مشكلة المنهجيات التأويلية أنها تنصب بين الإنسان والنصوص حاجزاً مانعاً يعسر عملية الفهم، إذ إنها تتصور الإنسان ذاتاً فاهمة مستقلة، والنص موضوعاً خارجياً قائماً بذاته. والحال أن العلوم الإنسانية، على نحو ما أشار إليه فيلسوف الفِسارة الألماني ڤيلهِلم ديلتاي (1833-1911) في طور أزمته الفكرية الأخير، لا يمكنها أن تعزل نفسها عن مجرى الحياة، ولا يسعها أن تحول الإنسان موضوعاً علمياً جامداً. ليس المفسر شاهداً محايداً يعاين من على بُعد موضوعات تفسيره، بل كائنٌ حي منخرطٌ في لعبة الحياة، وملتزمٌ حركية الاشتباك الوجودي مع وقائع التاريخ.
الفهم التشاركي
وعليه، يفضل غادَمِر مقولة الفهم الانخراطي التشاركي الذي يعتبر المعرفة عاملاً فاعلاً في تنشئة وعي الإنسان، وتهذيب أحكامه، وصقل آرائه، وترقية تصوراته. وهذه كلها مقاصد المذهب الإنسي (humanisme) الذي يدفع بالإنسان إلى الاعتراف بمحدودية آفاقه، ويتيح له الانفتاح على الكونيات الجامعة من الحقائق الإنسانية. خلافاً للمعرفة الموضوعية التي تنتجها العلوم الطبيعية، ينبغي للعلوم الإنسانية أن تفوز بمعرفةٍ تنخرط فيها الذات انخراطاً سليماً يحمل إلى الحقيقة إسهامات الفرديات التي تؤول بحسب أحكام انتمائها. لا يرفض غادَمِر المعرفة المنهجية العملية، ولكنه يذكرنا بأن هناك معرفة ذاتية تأويلية تكتسبها العلوم الإنسانية وفقاً لمنطق انخراطها في اختبارات الإنسان الثقافية.
من أجل إيضاح النمط المعرفي التأويلي التشاركي هذا، يستعين غادَمِر بالاختبار الفني، فيعلن أن الصنيع الفني لا يمتعنا تمتيعاً جمالياً فحسب، بل يجعلنا نختبر حقيقة الأمور اختباراً فريداً لا تقوى عليه العلوم الوضعية التي ترضى بالتذوق الفني ضرباً من ضروب الاكتسابات الإحساسية الذاتية الاستنسابية غير الموثوق بها. لذلك يرفض غادَمِر الحكم الجائر هذا، ويبين لنا أن الجهد المبذول في فهم لوحة فنية، على سبيل المثال، يقتضي منا أن ندخل إلى فضائها، ونلتزم لعبتَها، ونراعي أحكامها. حين أتأمل هذه اللوحة، أشعر بأنها تأسرني وتفرض عليَّ تجليات مدلولاتها، فتدفعني إلى استطلاع حقيقة إنسانية عليا. في هذه اللعبة ليس من استنسابية معرفية ذاتية، بل اندفاعٌ في خضم الكشف المعرفي. فالذات المتأملة تحس أنها مضطرةٌ إلى الانفتاح على جمالية اللوحة التي تُلهمها حقيقةً رفيعةً من حقائق الوجود الإنساني. لا عجب، من ثم، أن تحمل إليَّ هذه اللوحة ضربَين من المعرفة: معرفة الموضوع ومعرفة الذات. ذلك بأنها تكشف لي فائضاً من المعنى في شأن موضوع اللوحة، وفي الوقت عينه تجعلني أدرك ذاتي إدراكاً جديداً مغنياً.
حين يقارن المرء بحثاً تاريخياً يتناول الحرب العالمية الأولى، فإنه يقع على معلومات دقيقة تساعده في فهم مجرى الأحداث نشأةً ومسرًى وخاتمةً. أما حين يتأمل في لوحة فنية ترسم مشهداً مؤثراً من أهوال هذه الحرب، فإنه يفوز بفائض كشفي من المعنى يؤهله لولوج الحدث المرعب ولوجاً أعمق وأغنى. هذا في شأن فائض المعنى المنبثق من المعرفة الجمالية. أما في شأن التحول النضجي في الذات، فإن الإنسان المتأمل في لوحة الحرب يكتسب كثافة وجودية تهزه هزاً، وتتيح له أن يغوص في أعماق ذاتيته يستنهضها لتستجيب لنداء الحقيقة المنبعث من اللوحة.
ما من عاقلٍ يستطيع أن يتعامى عن استنهاضات الحقيقة المنبثقة من الصنيع الفني الذي يواجهنا بوقائع وإشارات ودلالات تُغني الوجود وتبدل فينا تبديلاً حاسماً. انظروا حال الذين يخرجون من مسرحية مأسَاوية تعصف بأساسات كيانهم وثوابت وعيهم، تدركوا مقدار الأثر الذي تخلفه فيهم الحقيقة المتجلية في العمل الفني هذا. ومن ثم، فإن غادَمِر يفضل أن يعتمد مثل هذه المعرفة المكتسبة من ملاقاة الحقيقة الإنسانية في الصنيع الفني لكي يطبقها على العلوم الإنسانية، فيمنحها الضمانة المعرفية الضرورية التي يعتقد أهلُ العلوم الوضعية أنها تنقصها. ذلك بأن الحقيقة المنعقدة في العلوم الإنسانية تتصل اتصالاً وثيقاً بمقام الحدث الوجودي الذي يتملكنا ويأسرنا ويستحثنا على استجلاء معانيها في معترك اختباراتنا الحياتية.
منافع الأحكام السابقة في بناء الفهم الملائم
من نتائج التحول المعرفي هذا أن نحذر الحذر كله من نماذج عصر الأنوار الذي يحرضنا على طلب الموضوعية الصارمة واجتناب الأحكام السابقة. والحال أن الأحكام السابقة تُفصح عن مضامين انتساباتنا الثقافية، وانتماءاتنا المعرفية، وتذوقاتنا الاختبارية. ومن ثم، فإنه من المستحيل على المرء أن يعري نفسه من جميع المكتسبات اللصيقة بوعيه هذا، وحجته أنه يصون الموضوعية المطلقة في فهم حقائق الوجود. لا يعني هذا القول أنه يجب علينا أن نثق ثقة عمياء بتصوراتنا وأحكامنا. المطلوب رعاية عناصر الفهم السابق هذه، والاجتهاد التأويلي في إخضاعها لطبيعة الأمور حتى تستقيم العودة السليمة إلى الأشياء، بحسب دعوة هوسرل وهايدغر. لا غرابة، من ثم، أن يناهض غادَمِر عصر الأنوار الذي يبني المعرفة على مثال اليقين الموضوعي المجرد. لا شك في أن هذا المثال وهمٌ معرفي ينبغي التخلص منه بوصفه حكماً سابقاً يظن فلاسفة الأنوار أنهم حرروا العقل من وطأته.
من الواضح إذاً أن التقاليد والتراثات والبيئات والمرجعيات الثقافية في كل حضارة تختزن من الأحكام السابقة والتصورات الناضجة والآراء المختمرة ما يتيح استجلاء حقيقة الإنسان على وجوه شتى. ذلك بأن التراث المعرفي أشبهُ بمستودع من الاختبارات المعرفية الناضجة التي تحمل إلى الإنسان ضمةً من التصورات تحدد له آفاقاً جليلة من الانتظارات والتطلعات والاندفاعات لا يستطيع أن يتجرد منها خوفاً من العري الثقافي المستحيل أصلاً. فالعربي يحلم بمقتضى أصول الحلم العربي، والأوروبي يعشق بموجب أحكام العشق الأوروبي، والأفريقي يرجو وفقاً لتصورات الرجاء الأفريقي. وعلاوةً على ذلك، لا يستطيع المرء أن ينعتق من القرائن التاريخية التي ترسم له إطار انتمائه الاجتماعي والثقافي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فالإنسان كائنٌ تاريخي مجبولٌ بالتأثر الحدثي والانفعال الواقعي، لا يملك إلا أن يغترف من تاريخيته معاني وجوده، وأحكام فهمه، وقواعد تأويلاته. فلا انعتاق، والحال هذه، من الحمل الثقافي هذا. غير أنه من الممكن أن يستخدم المرء الكثافة التاريخية والمسافة الاختبارية التراكمية لكي يستصفي من تصوراته وأحكامه الأنسبَ والأضمنَ والأفضلَ والأرقى. وحدها المسافة الزمنية تغربل شتيت المعاني المتدافعة، فتستمسك بما ينطوي على قيمة إنسانية حضارية راسخة، وتهمل ما أثبتت الأيام عقمه وأذيته. إلا أن مصفاة التاريخ هذه لا يجوز استخدامها في تأويل الأعمال الفكرية والفنية الراهنة. لذلك نحتاج إلى معايير تأويلية أخرى أشار إليها الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (1929-....) في نقده فِسارة غادَمِر الوثوقية.
انصهار الآفاق في عملية الفهم
في جميع الأحوال، يصر غادَمِر على الخصوبة التأويلية التي يستثيرها تلاقي الآفاق، آفاق النص وآفاق القارئ المفسر. فالتأويل ليس جهدَ الذات المنعزلة المجردة من كل انتماء وارتباط، بل مسرًى من الانسلاك الفطن في تراثٍ ثقافي يستدعي تواجه الماضي والحاضر وتلاقحهما. يتخذ هذا التلاقي هيئة الانصهار الذي لا يكتفي بجمع الماضي والحاضر، بل يضم الكاتب والقارئ في وحدة القصد المعرفي الأنسب. فكما أنه يستحيل على القارئ المفسر أن يستعيد ماضي العمل الأدبي على حقيقته الأصلية من غير أن يُخضعه لخلفيات الفهم السائدة في الزمن الحاضر، كذلك يصعب عليه أن يستفرد بنص الكاتب ويعزله عن أفقه المعرفي المنخرط فيه. حين تنصهر آفاقُ الكاتب بآفاق القارئ المفسر، يستقيم التفسير الذي يُنصف الاثنَين معاً. وما الإنصاف التأويلي سوى ترجمة معاني النص في صيغةٍ حية يفهمها أهلُ الزمان الحالي بلغتهم الناطقة الراهنة.
ذلك بأن الترجمة فعلٌ ثقافي جليلٌ يجعل النص الغريب ينطق نطقاً مُلهِماً بلغة القريب. لا تستطيع المعاني الدخيلة أن تلهم القارئ المعنى المطلوب إلا إذا نُقلت نقلاً إبداعياً يراعي منطق التعبير المعتمد في الزمن اللغوي الراهن. كما أنه لا استبداد ولا تعسف في عملية الترجمة الإبداعية، كذلك لا استنساب ولا اعتباط في تأويل الصنيع الفني واستخراج معانيه الحقة.
اللغة عمادُ فهم الأشياء
خلاصة القول أن التفسير الصحيح يتطلب مراعاة الكائن التاريخي المتوارث الأسبق، عنيتُ به اللغة التي تشتمل على خلفيات المعرفة الثقافية، وتختزن تصورات المجتمع، وتحتفظ بمفاتيح الفهم الأساسية. لذلك يصر غادَمِر على القول إن عملية الفهم وموضوعه شأنان لغويان في جوهرهما. ينطوي هذا القول على حقيقتَين: تقول الأولى بأن الفهم لا يستقيم إلا بواسطة اللغة، إذ إن المعنى لا يبلغ الأذهان إلا بواسطة الكلمات، والفكر لغةٌ في أصل نشأته ومسرى فعله ومختتم أثره؛ أما الثانية، فترسم أن موضوع الفهم لغوي، إذ إن ما يفهمه المرء إنما هو الكلمات عينها، لا الأشياء التي لا قدرة له على بلوغ شيئيتها العصية وماديتها المعاندة بلوغاً مباشراً. ومن ثم، تغدو اللغة أساسَ كل تفسير وفهم، بحيث يصح فيها قولُ هايدغر الشهير "اللغة مسكنُ الكينونة".