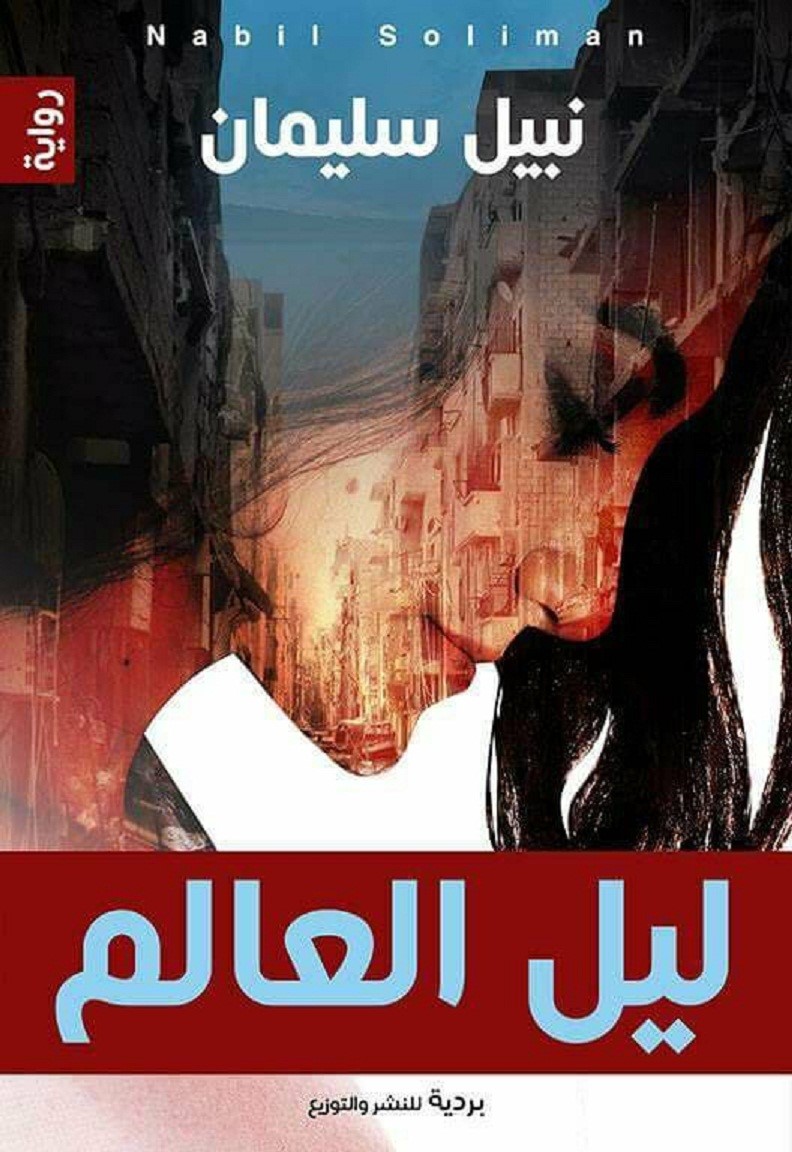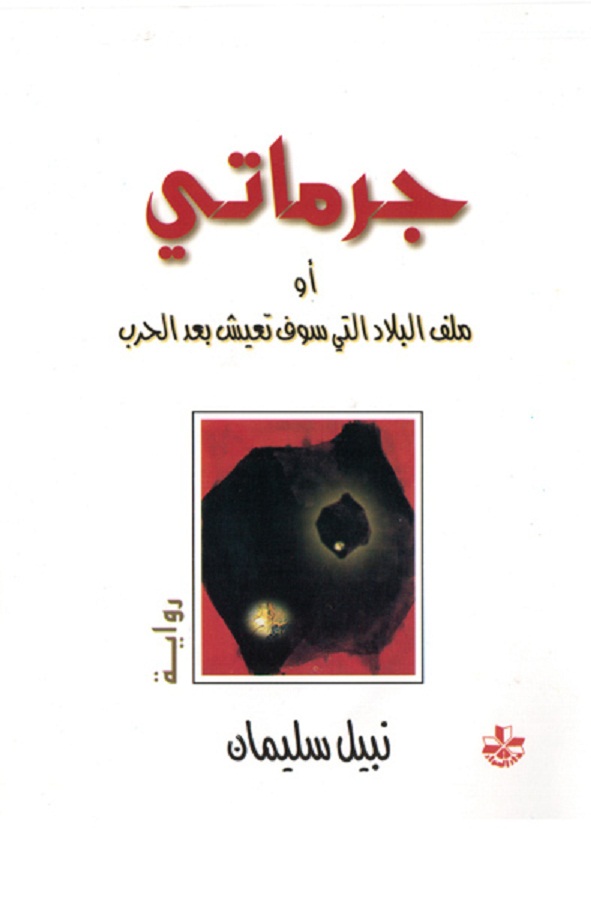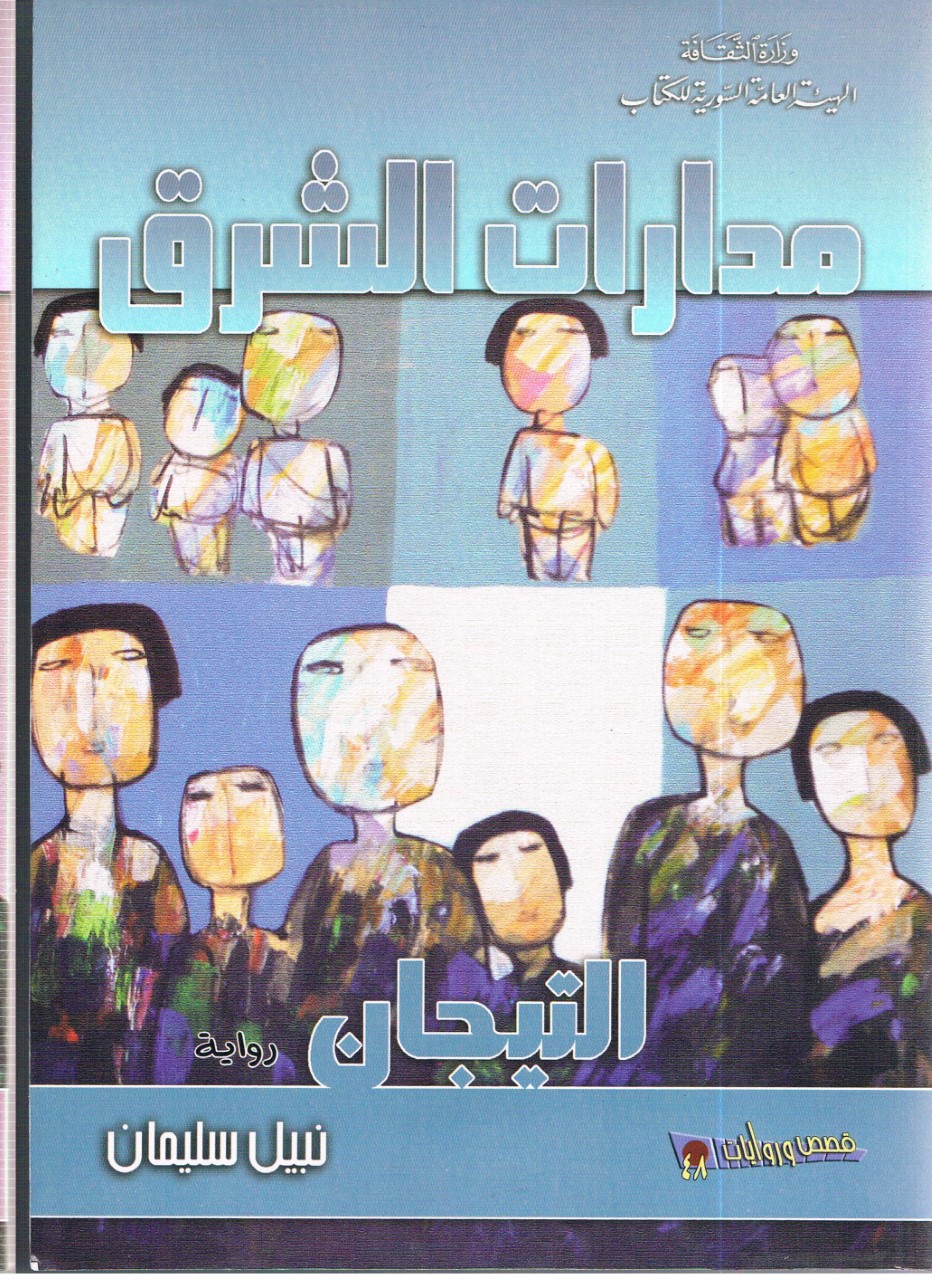يحضر اسم نبيل سليمان (صافيتا- 1945) بقوة منذ نصف قرن كروائي وناقد أدبي مرموق، استطاع أن ينتزع حضوره في النقد كما في كتابة الرواية، مؤسساً سردية مضادة للأدب الرسمي، ومُنقِّباً بمنهجية فكرية رفيعة المستوى بغية تفكيك التحالف الضمني بين الأدب والأيديولوجية، كاشفاً عن جماليات النص الأدبي، ومشتغلاً بدأب على نزع طبقات مجهولة من التاريخ عبر التخييل الروائي، ومميطاً اللثام عن تواريخ وبشر وأزمنة ضمّنها في مختبره الروائي، منافحاً عن استقلالية الكاتب والكتابة، وغير منصاع لعقلية الرقيب الاجتماعي والسياسي والقبلي. وكانت رباعيته الروائية "مدارات الشرق" سِفراً للتحولات الاجتماعية والسياسية في سوريا، وأتبعها بالعديد من الروايات التي ناكفت السلطات الطائفية والسياسية، ومنها "جرماتي" و"أطياف العرش" و"دلعون" و"سمر الليالي" وصولاً إلى "حجر السرائر" و"تاريخ العيون المطفأة" وسواها.
قبل أيام أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فوز سليمان بجائزتها لدورة 2020-2021 عن حقل الرواية والقصة والمسرحية، نسأله بدايةً عن رأيه ومشاعره بعد فوزه بجائزة العويس الثقافية لهذا العام، فيجيب "كانت لحظة سعيدة. بالأحرى كانت مفاجأة سعيدة على غير ميعاد، لأنني لم أنتظرها كما لم أنتظر غيرها يوماً. مثل هذه الجائزة تجعلك تشعر أنك لست وحيداً أو منسياً في ظلام هذا الليل العربي الطويل".
ظاهرة الجوائز
لكن هل ما زال للجوائز الأدبية ثقلها في تكريس الأدباء والنقاد في العالم العربي أم أن هذه الجوائز فقدت بريقها مع تكاثرها في الأوساط الثقافية، ومع فقدان بعضها المعايير؟ يعلق سليمان بالقول "في فضاء أقل سوءاً مما نحن فيه، ليس سلباً هذا التكاثر في الجوائز الأدبية وغير الأدبية. في حياة ثقافية شبه طبيعية وأقل سوءاً مما نحن فيه، سيكون قليلاً إن بلغت الجوائز المئات في العالم. أما في ما نحن فيه فليس ما توفره جائزة أو أخرى لرواج كتاب، بكافٍ لتكريس اسم صاحبه أو صاحبته. يحتاج الأمر إلى الزمن كيلا تكون الرواية (بيضة الديك)، وهذا من دون الحديث عما قد يرافق جائزة أو أخرى من لغط ومن ارتباك، وبالتالي من نقص في المصداقية".
يعتبر نبيل سليمان من الكتّاب الذين خاضوا معارك طاحنة مع الرقابة والرقيب منذ بداية طريقه، ففي عام 1970 أصدر روايته الأولى "ينداح الطوفان" فتعرض للأذى المباشر من الرقيب الاجتماعي، وفي عام 1972 رفضت الرقابة السورية نشر روايته "السجن"، ما جعله يدفع بها للنشر في بيروت. وبعدها، عام 1974، ظهر كتابه المشترك "الأدب والأيديولوجيا" مع المفكر الراحل بوعلي ياسين، ولقي هذا الكتاب وقتها هجوماً شرساً من كتّاب وشعراء وصحافيين. وتكرر المنع مع رواية "جرماتي" و"المسلة" وصولاً إلى "جداريات الشام" و"ليل العالم"، فهل تغيرت حال الرقابة اليوم في العالم العربي؟ وهل من الممكن الحديث عن حراس جدد للمحرمات الاجتماعية والسياسية؟ يبتسم ويرد بالقول "نعم، تغيرت الرقابة في بعض البلدان حتى بات المرء يترحم على رقيب أيام زمان. وتغيرت الرقابة في بعض البلدان الأخرى، فصار صدر الرقيب حقاً أكبر رحابة. ولكن أشكالاً أكثر مكراً وأشد أذى استوردتها واخترعتها وتفننت فيها رقاباتٌ رسمية عديدة ورقاباتٌ دينية أيضاً، وكلها مدرّعة بالأنوف الشمّامة وبمثقفين وبالسكاكين. وعلى ذكر كتاب (الأدب والأيديولوجيا في سوريا) كان بعض من أساءهم الكتاب أشرس من أشرس رقيب، حتى بلغ الأمر بكاتب كبير بحق، مبدع كبير بحق، لكنه نصح بترك الكتاب (يموت) في أرضه".
الإبداع والسياسة
جاء في كتابه "أخيولات روائية للقمع والطائفية" دراسات كان سليمان قد أنجزها في سنوات سابقة ما بين الإبداع والسياسة، وحول التخييل الروائي في سوريا بخاصة، وكذلك هو الأمر في كتاب "غابة السرد الروائي".. كناقد كيف تنظر اليوم إلى جدلية السرد والنقد في ظل الاهتزاز الذي تشهده الأرض العربية وما واكبه من اندفاعة روائية لا سيما في سوريا؟ يجيب "جاء كتاب (أخيولات روائية للقمع والطائفية) عام 2015 مهجوساً، كالروايات التي درسها، بما راجت تسميته بالربيع العربي وبالحراك والثورة، وسميته الزلزال الذي زلزل بخاصة سوريا واليمن وليبيا عام 2011، على غير ما كان في تونس، وملوّحاً لما كان في العراق منذ 2003. نعم. لقد أسرعت الرواية في التفاعل مع الزلزال، فسبقت الشعر وسواه، ولم يكن ذلك دوماً علامة صحة وعافية، بل غالباً ما كان فوراناً، أو تعويضاً عن فعل سياسي، أو انتقاماً من نظام، أو بياناً سياسياً، بأكثر بكثير مما كان عملاً فنياً مجبولاً بالدم والخراب والخسران. وإذا كان النقد قد بدا عاجزاً عن اللحاق بالموجة الهائجة، فمنه ما وقع في الفخ نفسه، فخ السياسة بالمعنى المباشر والفج والعصبي والزاعق".
في رباعيته الروائية "مدارات الشرق" قدّم سليمان حفريات روائية في النصف الأول من القرن العشرين، في سوريا الراهنة أولاً، وفي سوريا الطبيعية - بلاد الشام ثانياً، وفي الكثير من الفضاءات الأخرى عربياً وأوروبياً وأميركياً؛ على عكس روايته "جداريات الشام" التي جاءت كأداة سردية للحفر في التاريخ الحاضر أو الراهن الدموي. كيف ينظر الناقد السوري اليوم إلى تجربته الروائية بين شطرين من الزمن؟ وأين تقف هذه التجربة إزاء رواية الأدب الرسمي وما يدور في فلكها من محاولة احتلال للمخيلة الجماعية من قبل الموروث الديني والفكري والسياسي؟ يجيب "ما دمتُ قادراً على الكتابة فتجربتي قيد التشكّل، موّارة -كما أحاول أن تكون- ومنفتحة وأحلامها تكبر وتتجدد، ولعلها تكون أقدر فأقدر على أن تتعلم وتجرب وتجدد. من ناحية أخرى، أظن أن هذه التجربة كانت منذ الرواية الأولى (ينداح الطوفان) عام 1970 حتى غدٍ لناظره قريب، مارقة على الأدب الرسمي، وعلى كل ما هو رسمي في الثقافة والسياسة. تجربة لُحمتها هي النقدي وسداتها هي النقدي. وليت الأمر كان فقط احتلال الموروث الديني والفكري والسياسي للمخيلة الجماعية والفردية. ذلك أن الرسمي جعلنا نترحم على كل الموروث، وأبدع من أفانين التزييف والنفاق والعنف والتبكيت والكذب والتعذيب ما قلّ نظيره عبر التاريخ أو في العالم المعاصر".
الرواية والنقد
يعتبر نبيل سليمان من الروائيين الذين مارسوا النقد شأنه شأن العديد من الروائيين العرب، من أمثال محمد برادة وواسيني الأعرج ورضوى عاشور وسواهم. ولكن هل يمكن الحديث اليوم عن قطيعة مع جيل هؤلاء الكتّاب- النقاد، وأن من يأتي اليوم إلى الرواية يبدو متلهفاً للشهرة والانتشار والجوائز أكثر منه مهموماً ومشغولاً بزاده النظري والأدبي؟ بمعنى آخر هل غاب هذا النوع من الروائيين الذين يحاورون نصهم، أو يقرؤون تجربتهم وينتقدونها في الآن ذاته؟ أم أن الأمر يتوقف اليوم على تلك الاندفاعة الروائية التي لم تأخذ وقتها للتخمر والنضج وأمست تلهث خلف ما يسمى اليوم بالرواية الإعلامية؟ ويجيب "من جهة أولى، بات ظاهرة مؤسية هذا التهافت على الجوائز من بعض الأسماء الجديدة، حيث تبرق الشهرة وكذلك يبرق المال. والتهافت لا يفسح للاهتمام بزادٍ نظري أو معرفي، بل يؤثر القشور وما هو أهون وأسرع، ملفوفاً بلفافات عصر السرعة والإنترنت وما أدراك. لكن ذلك -من جهة ثانية- ليس كل شيء، إذ لا زال من كتّاب وكاتبات الرواية من هو مشغول(ة) بالزاد النظري والمعرفي، وبالقراءة النقدية للذات، وبالكتابة النقدية أيضاً، وبخاصة في الجامعات، وهنا تتألق أسماء مثل شكري المبخوت، وشهلا العجيلي، وزهور كرّام، ورشيد الضعيف".
ولكن كيف يقرأ سليمان أثر الشهادة الروائية على الراهن الفجائعي الذي تعيشه اليوم سوريا؟ هل تصير الشهادة الروائية وثيقة تاريخية فقط بحكم التقدم في الزمن؟ ويجيب "لن يتبدد أثر الرواية التي شهدت على الراهن، ولكن بما هي رواية أولاً وأخيراً وما بينهما. مثل هذه الرواية هو ما يبقى. أما الرواية التي تقدم الشهادة على نفسها، فلن يتأخر نسيانها وتبددها. وبما أننا في مناخ فاسد كيفما أدرتَ وجهكَ، فقد يكون لرواية تتقوى بالشهادة حضور ورهج وندوات وعراضات فيسبوكية ونقدية وتلفزيونية، وقد يكون لها جوائز وأطروحات جامعية، لكن الزبد يذهب جفاء. وقد علّمنا تاريخ الرواية وتاريخ الإبداع بعامة على مثل ذلك".
فتنة الكتابة
يشير نبيل سليمان في كتابه "فتنة السرد والنقد" (1994) أن ثلاثية نجيب محفوظ كانت بمثابة التأسيس الكلاسيكي الأول للرواية العربية، وبعدها يؤكد أن خماسية "مدن الملح" كانت بمثابة التأسيس الثاني... ولكن ماذا بعد؟ وهل يمكن الحديث عن تأسيس ثالث وفق هذا السياق؟ ويعلق سليمان فيقول "عبّرتُ غير مرة على أن زمن الرواية العربية الكلاسيكية بدأ يودع، وبالتالي، ما من تأسيس ثالث يبدو في الأفق، ولكن كل شيء ممكن في عالم الإبداع، وبخاصة الروائي منه. ما لا ينبغي أن نغفل عنه هو أن كلاسيكية نجيب محفوظ، وذروتها في ثلاثيته، سرعان ما أخذت تضيق بقميصها، وبدأ نجيب محفوظ يزرقها بمصل حداثي، كما بدا في "أولاد حارتنا" عقب الثلاثية مباشرة، وكما بدا بخاصة في رواية (ميرامار). وإذا كانت كلاسيكية عبد الرحمن منيف جاءت (نقية) بمعنى ما في خماسية (مدن الملح) أو في رواية (الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى) ثم في رواية (أرض السواد)، فقد كانت الحداثة تنفخ من روحها في تلك الكلاسيكية منذ البداية في (سباق المسافات الطويلة)، وبدرجة أكبر مما كان لكلاسيكية محفوظ، وهذا ما عنيته بالتأسيس الثاني للكلاسيكية، ومنه ما زامن روايات منيف، ومنه ما تلاه، كما في روايات حسن صقر وفواز حداد وبعض روايات سميحة خريس. لكن سيل الحداثة الروائية طغى، وكان ما كان بعجره وبجره بعدما أهلّ هلال الألفية الثانية".
يقول سليمان إنه بدأ يتشكل في سوريا نصّ منفي أو مهاجر. وهذا النص هو الراجح من الإنتاج الروائي السوري خلال سنوات الزلزال. فهل ثمة تقنيات جديدة في الكتابة الروائية السورية يمكن الحديث عنها عند الكتّاب الجدد خارج رواية المعتقلات والسجون وأقبية الاستخبارات؟ نسأل ويجيب "مهما يكن فالرواية في سوريا لم تكن يوماً رواية الاستخبارات بأي معنى من المعاني. هذا لا يعني أنه ليس من روايات في زمن المعارضة والموالاة تنفخ في المحصلة في البوق الرسمي الذي منه الاستخبارات أو اتحاد الكتاب، مثلاً". ويضيف "عبر تاريخ الرواية في سوريا كان الصوت المميز فيها صوتاً نقدياً لكل ما يشوّه الإنسان فرداً أو جماعة، وهذا ما تؤكده السلسلة الذهبية من مطاع صفدي وعبد السلام العجيلي وصدقي إسماعيل إلى حيدر حيدر ووليد إخلاصي وهاني الراهب، إلى من تتالوا منذ سبعينيات القرن الماضي. وبالمقابل ثمة قلة قليلة من الروايات الرديئة أو النافخة في بوق سلطان: من يذكر روايات الإسلامي العنفي عبد الودود يوسف؟". ويعقب "لقد دفعت الزلزلة السورية 2011 بكثيرين من الكتّاب والكاتبات إلى المنافي. وفي زمن الزلزلة الذي طال وُلد جيل جديد من الكتّاب والكاتبات. وقد أشرت في جواب سابق إلى بعض سمات النص الروائي في هذه السنوات العجاف. وخلاصة القول إن الحديث عن تقنيات جديدة لا يستقيم، وإنْ هو إلا عزف على أوتار أو أدوات سبق أن عزف عليها آخرون".
شكّلت الرواية السورية المجال الإبداعي الأكثر غوصاً في تفاصيل الحرب وتجلياتها لكونها تبحث باستفاضة في حيثيات الحرب، وتقصي أسبابها ومصائر البشر وتحولاتهم بعمق، ربما أكثر من الفنون والأشكال الأدبية الأخرى، فهل أربكت هذه الاندفاعة الروائية -حسب ما تسمونها- اليقين الرائج في حاجة الرواية إلى سنوات التخمر قبل أن تغامر بكتابة الزلزال الذي يعيشه الكاتب؟ يجيب "ما أكثر ما ذكّرتُ بالروايات الكبرى التي كُتبت في أزمنة الحروب والثورات، في أزمنة الزلازل السياسية والاجتماعية والفكرية والطبيعية -أليس الوباء زلزالاً؟- حيث لم تنتظر الرواية سنوات التخمر التي لا يمكن للقائل بها أن يحدد عددها ولا طبيعتها". ويضيف "ها نحن أولاء في هذه العشرية السورية السوداء نرى روايات باهرة، لم تنتظر سنوات التخمر، وغامرت في كتابة الزلزلة السورية فأبدعت، مثلما نرى روايات رديئة وغوغائية. وإذا كانت الغزارة لافتة ولا يخفى خطرها، فربما كان الاستسهال سبباً لها، لكنه ليس السبب الوحيد، كما أن القول نحن في زمن الرواية، ليس كافياً، والظاهرة تحتاج إلى تحليل النقاد والمفكرين عندما يحين الحين".