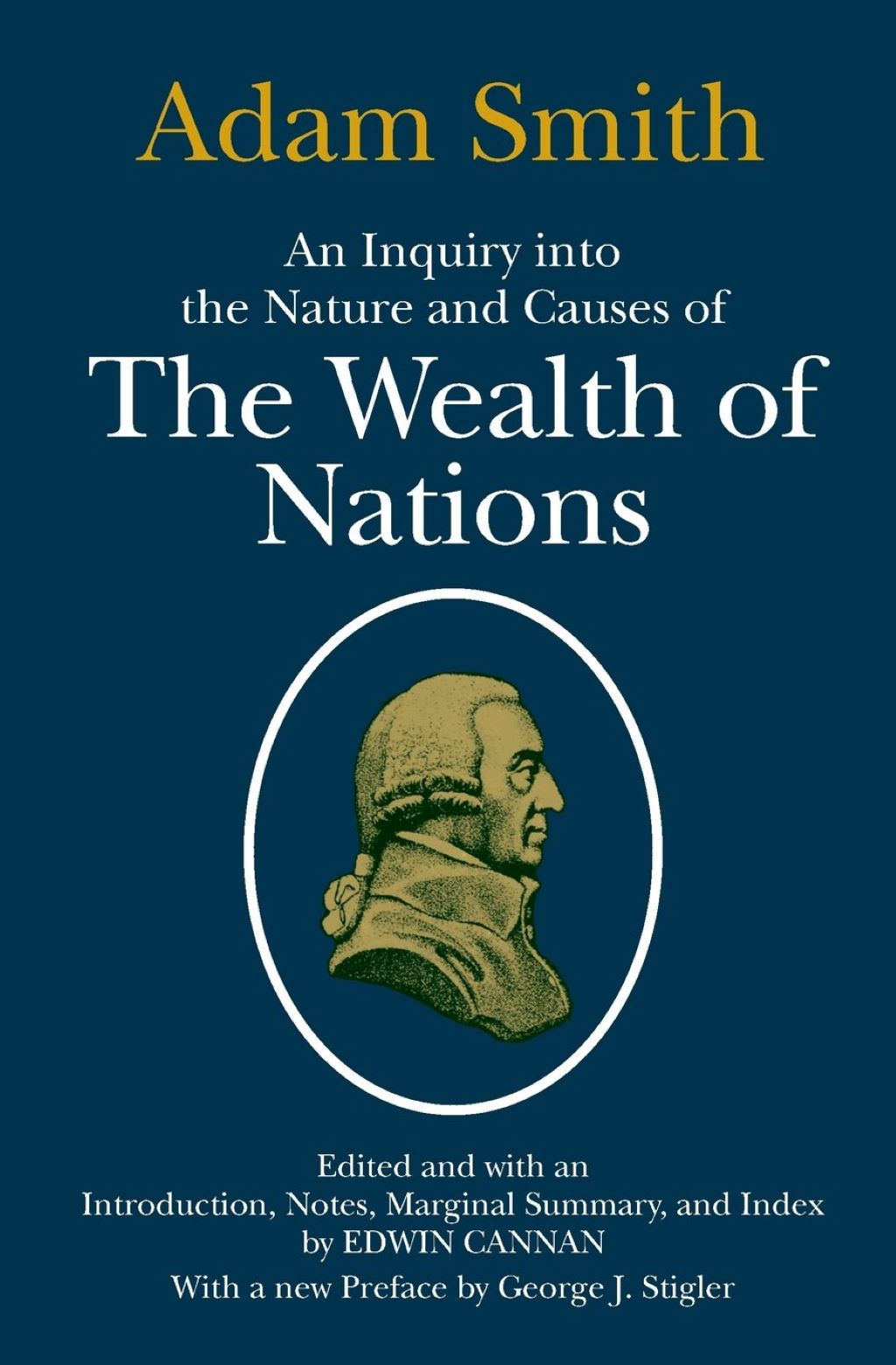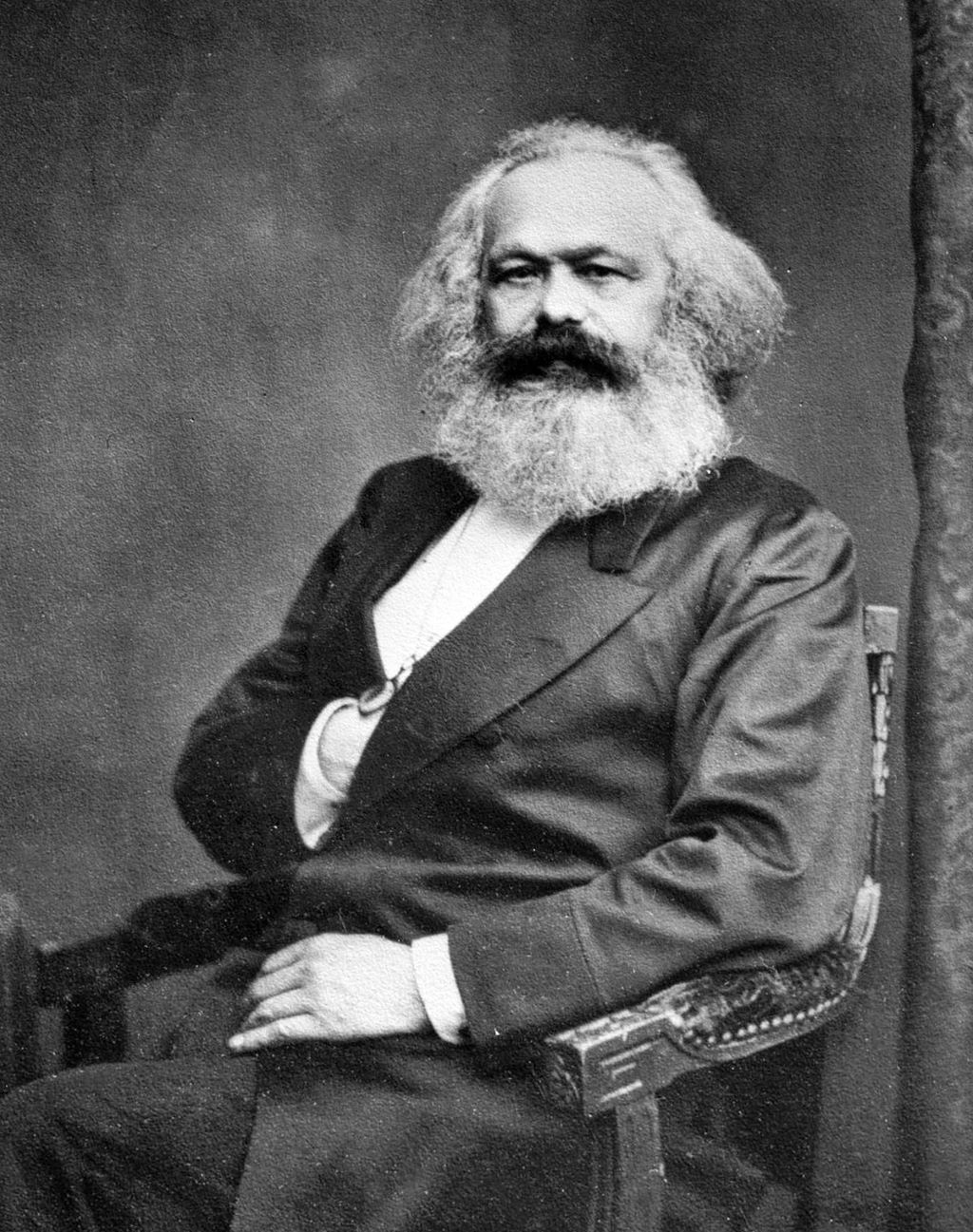ملخص
في كتابه "ثروة الأمم" #آدم_سميث وضع مفهوم الانتقال من #تعاملات_الذهب والفضة إلى التبادلات التجارية... فهل استطاع توفير حبل النجاة للدول من #الأزمات_الاقتصادية أم فتح الأبواب أمامها؟
من بين أهم الأسماء التي لم تأخذ حقها في التغطيات العلمية والدراسات الأكاديمية في حاضرات أيامنا، يأتي اسم آدم سميث، (1723-1790)، الفيلسوف والاقتصادي الإسكتلندي المشهور بكتابه "بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" (1776)، وهو من أكثر الكتب تأثيراً في تاريخ الكتابة، إذ حول سميث به اتجاه تفكيرنا في مبادئ الحياة الاقتصادية من الشكل القديم إلى شكل حديث ومميز، وذلك استناداً إلى فهم جديد تماماً للكيفية التي يعمل بها المجتمع البشري.
يحدثنا البروفيسور إيمون باتلر الذي شغل منصب مدير معهد آدم سميث، وهو بيت خبرة ذو تأثير يضع سياسات تشجع على الاختيار والتنافس في مجال توفير الخدمات الأساسية في كتابه المميز عن هذا الاقتصادي الفذ بالقول إن سميث غير أفكارنا أيما تغيير، حتى أصبح من الصعب وصف المنظومة الاقتصادية التي كانت سائدة أيامه، وهذه المنظومة هي المركنتيلية (نزعة التجارة من غير اهتمام بأي اتجاه آخر)، بحسب ما تحتويه خزائن الدولة من ذهب وفضة.
أوضح سميث أن هذا التوجه المركنتيلي الهائل بني على خطأ، ولذا أتى بنتيجة عكسية، ورأى أنه في ظل التبادل الحر يصبح الطرفان أكثر ثراء. وببساطة، ما من أحد يمكنه اللحاق بركب التبادل إذا كان يتوقع تحقيق الخسائر، فالمشتري يحقق الأرباح كما يحقق البائع الأرباح، وتعد قيمة الواردات في نظرنا مماثلة لقيمة الصادرات في نظر الآخرين، وليست هناك حاجة إلى إفقار الآخرين في سبيل إثراء أنفسنا، ففي الواقع يتسع الطريق لمزيد من الأرباح إذا كان المستهلك ثرياً.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار الحقيقة الراسخة بأن التبادل الحر ينفع الطرفين، فلقد أكد سميث أن التجارة والتبادل يؤديان إلى زيادة الازدهار على نحو مشابه بكل تأكيد لما ينتج من الزراعة أو الصناعة. إن ثروة الأمة ليست مقدار ما تحتويه خزائنها من ذهب وفضة وإنما هي إجمال الإنتاج والتجارة، أي ما ندعوه في أيامنا هذه إجمالي الناتج المحلي.
كانت هذه الفكرة جديدة على الأذهان، لكنها كانت قوية وأدت إلى إحداث اختراق فكري كبير في الجدران التجارية التي أقيمت حول المدن الأوروبية منذ القرن الـ16، كما كانت لهذه الفكرة نتائج عملية أيضاً، إذ كان كتاب "ثروة الأمم"، بما فيه من نمط مباشر ومؤثر يتصف بالتحدي والحذاقة التهكمية ووفرة الأمثلة، في متناول الأشخاص العمليين القادرين على ترجمة أفكاره إلى فعل.
من هو آدم سميث أول الأمر؟
في الخامس من يونيو (حزيران) من عام 1723، وفي مدينة صغيرة تسمى كيركالدي، ولد سميث لأسرة ميسورة الحال، غير أنه من سوء طالعه أن توفي والده قبل شهرين من مولده، فكرست أمه مارغريت دوغلاس حياتها لتربيته وأسمته باسم والده.
في مدرسة مدينته تلقى سميث تعليمه الأولي وما قبل الجامعي، وعرف بين أساتذته وزملاء دراسته بذاكرته القوية وولعه بعلوم الرياضيات، وكذلك انشغاله بالكتب أكثر من اللعب.
في الـ14 من عمره، انتقل سميث إلى مدينة غلاسكو لمواصلة دراسته في جامعتها المرموقة ودرس فيها ثلاثة أعوام، ثم توجه في أعقابها إلى جامعة أكسفورد، بعد أن حصل على منحة من مؤسسة "سنيل غلاسكو"، ليدرس في كلية بالبول التابعة للجامعة في الفترة ما بين 1740-1746.
لم يتوقف سميث عند دراسة الاقتصاد برؤاه الجامدة والمتكلسة، بل حظي بفرص كبيرة وواسعة لدراسة الدين والأخلاق والسياسة على يد أستاذه فرانسيس هاتشيسون، فيلسوف الأخلاق المعروف بقدرته على الإقناع وأسلوبه المؤثر في تلاميذه وحبهم له.
وفرت هذه الدراسات لسميث أجواء فكرية وفلسفية جعلته يتخرج مولعاً بالعلوم الأخلاقية والسياسية ومقتنعاً بأهمية الاستعانة بما توفره الفلسفة من معارف إلى جانب اعتماد المنهج العلمي في البحث، إضافة إلى تفتق ذهنه ووعيه بأهمية الحرية للإنسان والمجتمع.
كان من حسن طالع سميث أنه وجد في زمن أوروبا التي تعيش أزهى عصور التنوير ومفكريه، وأسهمت قراءة هؤلاء ولقاؤه بآخرين قابلهم خلال تجواله في جنيف وباريس، عطفاً على مصاحبته لـديفيد هيوم الفيلسوف والاقتصادي الإسكتلندي، في تبنيه القيم والفلسفة الليبرالية، إلى جانب تأثره بالاقتصاديين الفرنسيين مثل فرانسوا كيني وتروغو أثناء وجوده في باريس، كما أدت مناقشاته المستمرة معهم إلى إثارة اهتمامه بالشأن الاقتصادي ودفعه ذلك إلى التحول إلى البحث والدراسة والتأليف في هذا المجال.
سميث وكتب غيرت مسار التاريخ
لم يكن سميث يتوقع أن يكون لكتابه "ثروة الأمم" كل هذا التأثير، لكن الثقة المتنامية بالحرية الشخصية والتجارية، إنما نشأت بشكل مباشر من فهمه الجديد الجذري لكيفية عمل المجتمعات البشرية واقعياً.
لاحظ سميث أن التناغم الاجتماعي من شأنه أن ينشأ بشكل طبيعي من كفاح البشر لإيجاد طرق للعيش والعمل بعضهم مع بعض. إن الحرية والمصلحة الشخصية لا تقودان إلى الفوضى بالضرورة، وإنما تؤديان إلى النظام والانسجام، وكأن "يداً خفية" ترشد خطاهما.
لم يكن كتاب "ثروة الأمم" مجرد دراسة لعلم الاقتصاد بحسب مفهومه المعاصر، وإنما كان بحثاً ابتكارياً في علم النفس الاجتماعي والإنساني يتطرق إلى الحياة ورفاهيتها والمؤسسات السياسية والقانون والأخلاق.
جاء سميث في عصر كان من الممكن فيه على المفكر المتعلم أن يحيط بكل شيء علماً، بالعلوم والفنون وبالآداب والفلسفة والنصوص الكلاسيكية، فكان منه أن أحاط بكل ذلك، وجمع مكتبة ضخمة وخطط لكتابة تاريخ الفنون العقلية وألف كتاباً حول القانون والحكومة.
لم يكن "ثروة الأمم" أول كتاب يصنع سمعة لسميث في عالم الكتابة، وإنما صنعها أولاً كتابه في الأخلاق "نظرية المشاعر الأخلاقية"، وهو كتاب لا يحظى بالشهرة ذاتها، لكنه حظي في أيامه بمثل ما لـ"ثروة الأمم" من تأثير في القارئ وأهمية لدى مؤلفه.
حاول كتاب "نظرية المشاعر الأخلاقية" أن يحدد الأساس الذي تقوم عليه عملية صياغة تقييماتنا الأخلاقية. وفي هذه المرة أيضاً، كان سميث ينظر إلى الموضوع على أنه قضية نفسية عميقة، فالإنسان يشعر بـ"تعاطف" طبيعي، ما ندعوه اليوم بالمشاركة الوجدانية مع الآخرين على نحو يتيح له فهم كيفية تهدئة سلوكه والمحافظة على التناغم، وهذا الأمر يشكل أساس التقييمات الأخلاقية حول السلوك ويمثل منبع الفضيلة البشرية.
اقتصادي بدرجة فيلسوف أخلاقي
والمقطوع به أن من أهم ما يميز رؤى آدم سميث قدرته على المزج والتوفيق بين المصلحة الشخصية التي توجه منظومته الاقتصادية وبين التعاطف الذي يوجه أخلاقياته، وعنده أنه "مهما بلغت الأنانية بالإنسان، فلا شك في أن هناك بعض المبادئ في طبيعته تجعله يهتم بثراء الآخرين، وتجعل سعادتهم ضرورية له، دون أن يكون هناك ما يستمده منها سوى متعة مشاهدتها".
بعبارة أخرى إن طبيعة الإنسان معقدة، فالخباز لا يزودنا بالخبز بسبب حبه لعمل الخير، والمصلحة الشخصية ليست هي ما يدفع شخصاً ما إلى إلقاء نفسه في النهر لإنقاذ شخص غريب من الغرق.
من هنا يمكن القول إن كتب سميث هي محاولة متكاملة لتحديد كيف أن أصحاب المصلحة الشخصية يمكنهم، وهذا ما يفعلونه، العيش معاً بسلام في "النطاق الأخلاقي" وعلى نحو مثمر "في النطاق الاقتصادي".
لكن من دون شك لا يعني ذلك أبداً أن "ثروة الأمم" يدافع عن رأسمالية البقاء للأقوى، كما يصفه بعضهم بسخرية. فالمصلحة الشخصية ربما توجه الاقتصاد، لكن إذا كان هناك تنافس منفتح أصيل، إضافة إلى غياب الإجبار، فتلك قوة تعمل لمصلحة الخير، ومهما يكن من أمر، فإنسانية سميث وحبه للخير واضحان في كل صفحة من صفحات الكتاب، فهو يعلي من شأن رفاهية الأمة، لا سيما الفقراء، فوق المصالح الخاصة للتجار والفئات القوية، غير أنه ينتقد المصنعين الذين يحاولون عرقلة التنافس الحر ويدين الحكومات التي تساعدهم.
هل يمكننا أن نسمي سميث فيلسوف الطبيعة الإنسانية والعودة لـ"متوشالح" (شخصية ميثولوجية من قبل الطوفان)، على حد تعبير جورج برنارد شو؟
يمكن ذلك بكل تأكيد وتحديد، ولمزيد من التفصيل نقول إن مفكري القرن الـ18 كانوا يؤمنون بأنه يجب أن يكون هناك أساس أكثر صلابة للمجتمع من العقيدة التي يمررها رجال الدين أو الأوامر التي تصدر عن السلطات السياسية، وعمل بعضهم جاهداً لإيجاد منظومات "عقلانية" للقانون والأخلاق، أما سميث، فرأى أن المجتمع الإنساني، بما فيه من علم ولغة وفنون وتجارة، متأصل في الطبيعة الإنسانية، وبيّن كيف أن غرائزنا الطبيعية تقدم دليلاً أفضل من متعجرف، فإذا أقدمنا على مجرد إزالة "منظومات التفضيل أو التقييد كافة" والاستناد إلى"الحرية الطبيعية"، فعندها سنجد أنفسنا مستقرين عن غير عمد لكن بكل ثقة في ظل نظام اجتماعي متناغم وسلمي وفاعل.
رأس المال... سميث يسبق كارل ماركس
يعرف كثيرون أن كارل ماركس، صاحب الكتاب الشهير عن "رأس المال"، هو أول من تناول فكرة مضاعفة الثروة من خلال رؤوس الأموال، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الـ19، غير أن البحث المعمق في كتاب "ثروة الأمم" لآدم سميث يكشف لنا كيف أن سميث سبقه في هذا السياق. ففي المجلد الثاني من عمله المركزي يشدد سميث على أن تراكم رأس المال شرط ضروري للتقدم الاقتصادي، فخلق الفوائض يتيح إمكانية التبادل والتخصص، وهذا التخصص يساعد في خلق فوائض أكبر، وهي بدورها يمكن استثمارها مجدداً في تجهيزات جديدة متخصصة وموفرة للعمل ولذا تتسم هذه الدورة الاقتصادية بأنها حميدة، فبسبب هذا النمو في رأس المال يصبح الازدهار كعكة متنامية الحجم ولا حاجة معها إلى إفقار أي شخص أو أمة من أجل تمتع الآخرين بالثراء الأكبر، وإنما العكس بالعكس، فتصبح الأمة بأكملها أكثر ثراء مع توسع الثروة.
كيف نظر سميث إلى المال وهل كان يمثل قيمة في حد ذاته، أم أنه اعتبره أداة ضمن أدوات علم الاقتصاد؟
رأى سميث قبل ثلاثة قرون تقريباً أن المال لا يمتلك أي قيمة جوهرية، فهو ليس إلا أداة للتبادل، والثروة الحقيقية تكمن في ما يشتريه المال، لا في تلك الأوراق والقطع المعدنية.
وعنده كذلك أن القوة الشرائية للذهب والفضة تتقلب على أي حال، والشخص الذي يستلم اليوم جنيهاً من الدخل، ربما ينفق الجنيه نفسه غداً، وبذلك يوفر دخل شخص آخر، وهذا الشخص ربما ينفق الجنيه نفسه بعد غد، وبذلك يوفر دخل شخص ثالث، ولهذا من الواضح أن كمية المال المتداول لا تتطابق مع إجمالي دخل الأمة، ويخطئ أتباع المذهب المركنتيلي عندما يخلطون بين الاثنين.
ومع ذلك فإن للمال تأثيراته، فعندما يهمل ولا يتداول، يصبح أداة لا فائدة منها أو مخزوناً كاسداً، لكن العمل المصرفي الفاعل يستطيع أن يجعله يعمل بجد واجتهاد أكبر.
التعليم والازدهار الاقتصادي للأمم
من بين القضايا المهمة التي تخفى على كثيرين، ربط سميث للتعليم بازدهار الشعوب والأمم، وقليلون هم الذين تكلموا عن هذا الأمر، وهو ما يتوقف عنده البروفيسور ريمون باتلر في كتابه الشهير عن سميث.
يرى سميث في تعزيز التعليم الأساسي أمراً مشابهاً للبنية التحتية، أي أنه أمر نحتاج إليه لإتاحة فرص الازدهار أمام التجارة.
رأى سميث أن هناك دوراً للحكومة في تعزيز تعليم الكبار والتعليم الديني، فرجل الدين يصبح كسولاً عندما يحصل على راتبه من العُشر، لكن إغراءات المدن المتنامية تعني أن التعليم الديني والأخلاقي لم يكن أبداً على هذه المرتبة من الأهمية، ولذلك فإنه يؤيد في الأقل دور الحكومة في تشجيع دراسة العلوم والفلسفة والفنون.
وفي كل الأحوال، فإنه يمكننا القول إن العالم الذي عاش فيه سميث كان شديد الاختلاف عن عالمنا، وذلك قبل أن تؤدي الثروة الصناعية إلى تغيير كل شيء، فقد كان ينظر بعين الشك إلى شركات المحاصة التي تعتبر الدعامة الأساسية للرأسمالية المعاصرة، قائلاً إن "العدد الهائل من أصحاب الأملاك" لا يتيح لهذه الشركات قط أن تظل محافظة على تركيزها.
هنا يقطع البروفيسور باتلر بأن سميث ربما كان محقاً في ذلك، غير أنه لم يتنبأ بصعود السلطة النقابية ومشكلات التلوث الصناعي وتضخم المال المجاز في التعامل وكثير من المشكلات التي تزعج الاقتصاديين في عصرنا هذا.
وبغض النظر عن هذه الملاحظات، فإن "ثروة الأمم" بما فيه من تبيان لكيفية ما تؤدي إليه حرية العمل والشعور بالأمن فيه والتجارة والادخار والاستثمار من تعزيز للازدهار، من دون أي حاجة إلى سلطة توجيه، يزودنا بنطاق فاعل من الحلول لأسوأ المشكلات الاقتصادية التي يمكن أن نبتلى بها.
من هنا يمكن التأكيد على أن الاقتصاد الحر هو منظومة مرنة قابلة للتكيف يمكنها مقاومة صدمات المستجدات والتغلب على كل ما يحمله المستقبل من تحديات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في شخصية سميث المثيرة للجدل
لم يجد المؤرخون لشخص آدم سميث كثيراً من المعلومات عن شخصه، والقليل الذي نعرفه عنه يقول إنه فضل أن يعيش راهباً في محراب العلم والفكر، وليس محراب الأديرة والرهبانيات التي كانت أوروبا تغص بها في تلك الأيام.
لهذا لم يرصد أنه تزوج أو قام بتكوين أسرة وإن كانت بعض كتاباته تشي بأنه كان على علاقة ما في وقت مبكر بشابة على قدر كبير من الجمال واللباقة.
كما لا نعرف إذا كان له أخوة أو أخوات ويصفه بعض معاصريه بأنه كان غريب الأطوار، فكثيراً ما كان يفقد صلته بالواقع ويسرح في الأرجاء غير واع إلى أن يعود لصوابه، كما كان شديد الكرم والإحسان.
أوصى سميث بأن تحرق معظم أبحاثه غير المنشورة عند وفاته، وهو طلب طبيعي تماماً في عصره، لأن الكتاب كانوا يرغبون في أن يتم تقييمهم على أساس أعمالهم التامة، وليس على أساس ملاحظاتهم الأولية، ولذلك لم يصلنا إلا القليل من كتاباته التي تخرج عن نطاق ما سطره في "ثروة الأمم" و"نظرية المشاعر الأخلاقية".
لكن هذا القليل يبين لنا مدى الاتساع الهائل لدائرة تعلم سميث واهتماماته، ومن ذلك نقده لقاموس صامويل جونسون ومقالات حول الاتجاهات الفكرية في أوروبا وأصل اللغات والفنون من رسم ودراما وموسيقى ورقص، وملاحظات حول الشعر الإنجليزي والشعر الإيطالي ودراسات حول تاريخ الفيزياء والفلسفة في العصور القديمة وأطروحة من 70 صفحة عن "تاريخ علم الفلك".
ومن حسن الحظ أن لدينا أيضاً ملحوظات كتبها طلبته على المحاضرات التي ألقاها تحت عنوان "محاضرات في البلاغة والأدب الإبداعي" و"محاضرات في فقه القانون".
وعلى رغم أن هذه الملاحظات لم تكن بقلم سميث، فإنها تقدم لنا رؤى ثمينة حول تطوره الفكري في غلاسكو، كما أن كثيراً من الفقرات تعاود الظهور في كتابه "ثروة الأمم" أيضاً.
وفي كل الأحوال، فإن ما تقدم ليس سوى غيض من فيض لرجل لا يزال يدهش العالم بكتاباته بعد قرون من وفاته.