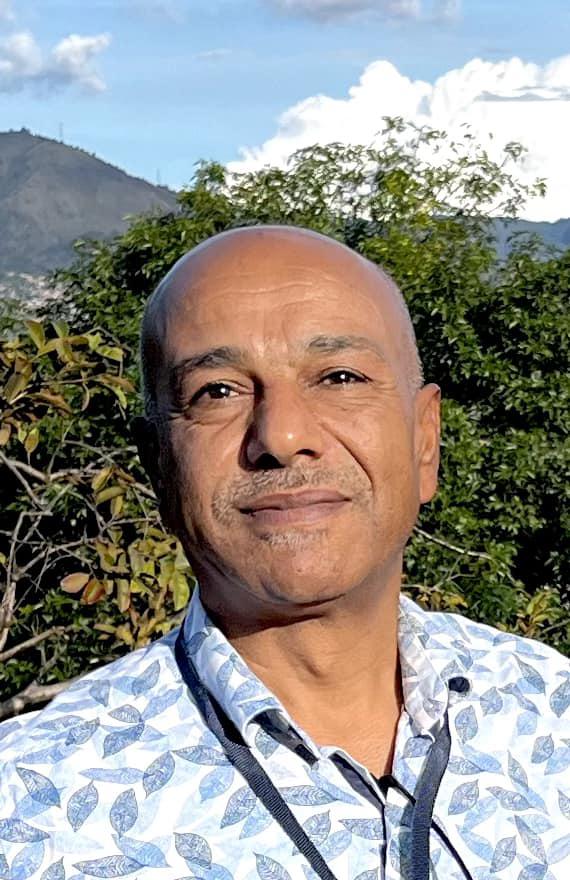لعلها مصادفة فريدة حقاً، أن يُصدر الشاعر الفلسطيني علي العامري قصيدة طويلة في كتاب سماه "فلسطينياذا" (الدار الأهلية، 2023) في اللحظة المأساوية التي تحياها غزة وفلسطين معاً، والتي تعيد إلى الذاكرة مشاهد التراجيديا التاريخية المتوالية منذ النكبة عام 1948. كتب العامري هذه القصيدة الملحمية قبل عام أو عامين وربما أكثر، من اندلاع حرب غزة، لكن صدورها اليوم بدا أشبه بالاستجابة الحدسية التي تجعل القصيدة ابنة اللحظة الراهنة هذه، التي يعاد خلالها تأريخ فلسطين وفق ما حصل دوماً، بالدم والرماد والخراب وصيحات الأطفال أو صمتهم، وبكاء "راحيل" الفلسطينية على أبنائها.
كم أصاب علي العامري في تسمية قصيدته "فلسطينياذا"، ففلسطين تستحق هذا الاسم الذي طالما خالج شعر محمود درويش على سبيل المثل، مثلما تستحق هذه القصيدة المفاجئة أن تكون بحق إلياذة أخرى، على غرار إلياذات الشعوب المقهورة والأراضي المحروقة والبلدان المدمرة. فالقصيدة فيها من بطولات الشعب الفلسطيني وتضحياته، ما فيها من مآسيه وفجائعه، عطفاً على انصهار الجغرافيا والتاريخ في تلافيفها، والطبيعة الساحرة والناس، الحكايات والرواة... قصيدة النفس الملحمي والاستعارة الملحمية والخريطة المكانية - الروحية التي لا بد منها كي يتسع فضاء الوقائع والمرويات والصور والألوان وحركة الايقاع صعوداً وهبوطاً في ما يشبه جبال فلسطين ووديانها. ولا يكفي أن يستعير الشاعر رمز حصان طروادة أو صورة بينلوب وأوليس كي يترسخ النفس الإلياذي والأوديسي اللذين يكمل واحدهما الآخر. فالشعر والقصيدة المدورة بتفاعيلها وقوافيها الباطنة غالباً والظاهرة في أحيان، واللغة والغناء والرثاء ورجع الأصوات والسرد، كلها تلتحم هنا لتصنع معالم هذه القصيدة، التي هي قصيدة الجماعة وقصيدة الفرد المتعدد، وقصيدة الأرض مقدار ما هي قصيدة الذات العميقة.
المدى الإيقاغي
يستهل العامري قصيدته الملحمية المدورة عبر تفاعيل الخبب أو المستدرك وجوازاتهما، ثم يمعن في اللعبة الإيقاعية غير المغلقة، مانحاً إياها مدى إيقاعياً تحضر فيه القوافي التي تتباعد ثم تغيب من غير أن تغيب الأوزان، مستفيداً تمام الاستفادة من فضاء قصيدة النثر ورحابتها ومن إيقاعاتها الداخلية وأنفاسها، مما يمنح قصيدته القدرة على الانفتاح على ما يسمى نثر الحياة أو العالم، وعلى فعل التأريخ واستحضار المكان الذي يتشظى أمكنة هي أمكنة فلسطين، مدنها وقراها وجبالها ووديانها وغاباتها... وكذلك على رسم بورتريهات لأشخاص قريبين أو بعيدين، وسرد الحكايات الخاطفة والتحاور مع أشخاص أو أطياف، كأنهم على مسرح حاضر وغائب في آن واحد. فـ"هنا كما يقول، فلسطين التي في دفتر التاريخ والجغرافيا"، فلسطين الواقع والخرائط، ، فلسطين الحاضر في "بريد الماضي"، فلسطين الطفولة "التي تأتي غداً". وقد تبدو القصيدة كأنها أشبه بـ"أطلس" أو بطاقة بريد كبيرة، يرسم الشاعر عليها فلسطين، خوف أن تضيع، بمدنها وقراها وأحيائها وطبيعتها، بأزمنتها وأمكنتها، ولكن رسماً شعرياً غنائياً، روحياً ووجودياً، يجعل الجغرافيا تشع وكأنها مرآة تحت الشمس.
ولعل تسمية الأمكنة في ما يشبه "الجردة" الخرائطية، لا يقع البتة في النثر الذي يكتبه الرحالة أو المؤرخون، فأسماء هذه القرى والمدن تتهادى كما يتهادى ماء نهر الأردن، وتخضع لإيقاع شعري في سياق القصيدة، وكأنّ الأسماء هذه جزء أساس من بنيتها. وأخال أن في الأمر إصراراً على ترسيخ الأسماء الفلسطيينة بعدما عمدت الآلة الإسرائيلية الجهنمية منذ سنوات، وتعمد إلى أسرلة أسماء كثيرة، ماحية جذورها الفلسطينية، العربية والكنعانية. ولا يسع المجال هنا لإيراد الأسماء المكانية الجميلة والمحفورة في ذاكرة التاريخ القديم. وهنا بضع منها على سبيل المثل: "هذي البروق تمتد في أسمائنا، في القدس، في حيفا ويافا، عسقلان وعيلبون وبير زيت، خان يونس، بيت جالا، والخصاص...". ويضيف: "هذي البروق سلالة المعنى التي تمتد في طمون، في حوسان، في قالونيا، عكا، وجب الذيب، في جبول، في بيسان، في جلبون، يعبد، عين مصباح، وفي العوجا، وجحر الديك، في وادي حنين..."، إلى ما يتواصل من أسماء قرى ومدن ومناطق لا يعرفها إلا من يلم بالجغرافيا الفلسطينية.
وهذه الأسماء تتوالى في مقاطع أخرى من القصيدة بإيقاعاتها الوزنية، وكأنها أشبه بما يسمى "لايتموتيف" في البناء الموسيقي الاستعادي. ولا تغيب عن القصيدة أسماء الأزهار والنباتات والأشجار في أرض فلسطين ومنها مجهول أو شبه مجهول: الينبوت، العبهر، الحلفاء، الحصلبان، العلت...، عطفاً على: القريص والدوم والمريمية والليمون والتين والدالية واللوز والزيتون والسنابل والبلوط والنخيل والدفلى وسواها. ناهيك بأسماء الطيور مثل القطا الذي "يطير فوق الجبال".
البلاغة الخضراء
ولا يغيب عن هذه الخريطة المكانية الروحية نهر الأردن الذي "يدوّن في الأرض بلاغته الخضراء" والذي "كمرآة سائلة/ ينساب/ ويروي الأشجار"، سارداً ماضيه وحكايات الجنود المجهولين، ماضياً "في مشيته الخضراء/ إلى أن يحيي البحر الميت". ولا ينسى الشاعر الذي يدون تاريخ الأرض وجغرافيتها، حكاياتها، التي تمتزج بعضاً ببعض، حكايات "حجر ينبض فيه الضوء الأثري"، حكايات ترويها الجدات، "عيون الماء وزهر الليمون"، وقنطرة البيت والمنجل وطواحين القمح ومفتاح الباب، القبب الذهبية والأجراس والأنهار وجرار الزيت، حكايات "يرويها شهداء وأسرى وفدائيون"، حكايات "تنقلها تلميذات في مدرسة تابعة لوكالة أونروا" وأطفال الحجارة. حكايات "تحكيها الطرقات، أغاني الدلعونة وأطباق القش". حكايات لا تحصى لأنها من عمر الأرض وشعبها.
ولا تغيب صورة العائلة عندما كانت هناك في "جنتها" الأرضية: الجد بعباءته البنية، الجد الذي يعد فلسطين "الجنة بين الماءين" والتي تنهض "نخلتها العالية في القدس"، وهناك بنظره "لا معنى دون الأقصى" ولا معنى "من غير كنيسة مريم" و"جبل الزيتون". هو الجد الذي "رفع الراية سوداء على سطح الدار" عندما مات عبد الناصر، الجد الذي مات وفي ساقه تستقر رصاصة، الجد الذي هو "الجبل". ثم الأب و"في يده برق وسنابل"، ثم الأم التي "تطرز ثوباً تحت العريشة" بالقرب من الهباش وحبات الهال والمحماسة وفناجين القهوة. إنها الأم الفسطينية التي يختتم العامري قصيدته بصوتها في ما يشبه المونولوغ، فتسأل: "كيف تعود حياتي لطبيعتها/ ودم ابني لم ينشف بين ركام الدار ولم ينشف دمعي". إنها الأم بالأمس واليوم، ظلها "مشحرة" وصمتها "حقل حداد". الأم التي صارت "وحيدة ظلها"، تكبر مع أشجارها الثلاث، التي حلت محل أبنائها الثلاثة الذين "قصفتهم طائرة عمياء"، الأم التي أصبحت "أماً لأشجار البيت".
لا تغيب عن المشهدية الفلسطينية هذه صورة، بنيلوب الفلسطينية، وهنا يسميها الشاعر ترميزاً بـ"العروس" التي "تجلس تحت شجيرة لوز قدام الدار"، تطرز "ثوباً لم تكمله على مر السنوات". لكنها بينلوب الوحيدة والحزينة، "تنتظر الغائب" أو "العريس" أو "أوليس" الذي سحبه "جنود العتمة/ في يوم العرس/ مرفوع الرأس"، فلم يتسن له أن يقاتل كما قاتل أوليس تحت رعاية الآلهة. إنها تطرز قدام الباب "عودته بالإبرة والخيط"، كيلا تنسى "ليل السنوات". وفي سياق البعد الهوميروسي، لا بد من التوقف عند استخدام الشاعر رمز حصان طروادة ولكن في صيغته الفلسطينية، وتحديداً على لسان الأم ووفق حكايتها. لكنّ الحصان هنا هو من صنع بريطانيا وقد اختبأ فيه رجال عصابات إشترن وإرغون وبلماخ وهاغانا، "خرجوا بقلوب مظلمة كالقطران وعاثوا قتلاً فينا، بقروا بطن الحامل وانقضوا فوق بيوت الأجداد وداسوا فوق قبور الموتى...".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحضر ثيمة الطريق في القصيدة حضوراً وجودياً، مثلما حضرت في بعض قصائد محمود درويش، وهو طريق الرحيل هنا لا العودة، الطريق الذي يقود من الهنا إلى الهناك، الطريق الذي ينتهي في المنافي، كما يقول الشاعر، الطريق الذي هو أيضاً "طريق الموت يأخذنا خطوة خطوة". ويبلغ مجاز الطريق ذروته الفجيعية عندما يقول: "لم يعد غيرنا/ في الطريق إلينا/ هنا وغداً"، ثم ذروته العبثية عندما يضيف: "تعب الطريق/ وما تعبنا في الطريق". طريق المنفى بل المنافي، الذي يترك وراءه الظلال "على يتمها" والبيوت والتلال والبشر، الذي يترك الأبواب مفتوحة "على الأسماء والأشجار" والمفاتيح التي تنام بلا أبواب، و"تبقى معلقة في جدار الزمان".
يحضر طيف الشاعر محمود درويش في القصيدة بل إن العامري نفسه هو من يسميه أكثر من مرة، ويتوقف عند قصيدته الملحمية الطويلة "جدارية"، ساعياً إلى محاورة درويش من خلالها، ومعارضته شعرياً على الطريقة العربية. ومما يقول: "في جدارية درويش/ رأيت الموت يعلو/ في بياض العتمة العليا..."، ويقول: "في جدارية درويش سماء/ تلتقي في قبة الصخرة في القدس وفي برج القيامة..."، ويقول: "في الجدارية شمس ترتقي في بحر يافا فوق بيسان وحطين وعكا..."، و" في الجدارية تنمو شتلة البرق..."، و: "في الجدارية تعلو نجمة في قبة الأرواح..."... ولعل ثمة تلاقياً بين الشاعرين واللغتين على مستوى المجازات والاستعارات والايقاع والتقفية الداخلية التي اعتمدها درويش كثيراً، يشير إلى حال من التناص الشعري، خصوصاً في النفس الملحمي الذي عرف به درويش ووسمت به قصائده الطويلة.
وهذا شأن غير مستغرب ما دام العامري يكتب "إلياذة" فلسطين أو "فلسطينياذا"، وقد يكون مجحفاً بحق فلسطين إن هو تجاهل محمود درويش، شاعر الأرض والجماعة والذات والكينونة والموت والأمل والطريق والمنفى، في التراجيديا الفلسطينية. وفي سياق لعبة النفي والإثبات التي كان أجادها درويش في بضع قصائد أو مقاطع، قائلاً فيها على سبيل المثل: "أنا لست لي..."، "هذا البحر لي/ هذا الهواء الرطب لي... وهذا الاسم لي"، يعارضه العامري مشرعاً هذه اللعبة، لعبة المداورة، بل هذه الجدلية، على أفق رحب، في عناصره كما في الأسماء والأمكنة والرموز. يقول العامري في مقطع طويل من القصيدة مفتتحاً إياه: "لا الأرض أرضك..."، و"ولا البحر بحرك..."، "لا الكرمل الممتد نحو البحر لك/ لا القدس لك...". وترد هنا أمكنة فلسطين ومدنها وقراها ونباتاتها وألوانها، وحتى أيام الأسبوع التي يسوقها في مساق شعري بديع، مكرراً أسماءها تكراراً إيقاعياً ذا بعد دلالي بيّن: "لا الجمعة، الاثنين، لا السبت، الثلثاء، الخميس، الأربعاء، لك". ثم ينتقل من صيغة النفي الوجودي إلى صيغة الإثبات الوجودي، فيقلب السلب إيجاباً في حال من الجدلية العميقة التي تتحد فيها الأضداد: "لي في بلادي سوسن ينمو على جلبوع، لي أثر هنا... لي سماء فوق بيت الطين في بيسان... لي خزف الخليل... ولي حجل الجليل...". ثم لا يفتأ ينقلب إلى النفي قائلاً: "لا جد لأمك في أرض فلسطين/ لا جد لجدك...". ثم تتسع خريطة النفي حتى لتشمل عناصر الطبيعة والمكان والزمان وحتى الأسماء، فيقول: "لست وريث السوسن والوديان... ولست وريث المخطوطات/ ولا كتب التاريخ/ ولست وريث قصائد درويش/ لست وريث رسومات الحبر بريشة ناجي... وتكتمل اللائحة، فإذا هو أيضاً ليس وريث طوقان وكنفاني ولا سميح القاسم...
ما كان أحوج القارئ الفلسطيني والعربي الى مثل هذه القصيدة اليوم، في هذه اللحظة التاريخية المأساوية التي تحياها غزة وفلسطين، بل ما كان أحوج الذاكرة الجماعية والفردية إلى قصيدة بمثل هذا النفس الملحمي الذي يستجيب للأحوال التراجيدية التي يواجهها الشعب الفلسطيني والعربي. ولعل هذه القصيدة تمثل "ألياذة" بل و"أوديسية" العصر الفلسطيني والشعر الفلسطيني عموما، فهي حملت بحق خلاصات المعاناة والألم والموت مثلما حملت خلاصات الأمل والحلم والحياة، وخلاصات التجربة العميقة التي اختبرها الشعراء الفلسطينيون منذ النكبة العام 1948.