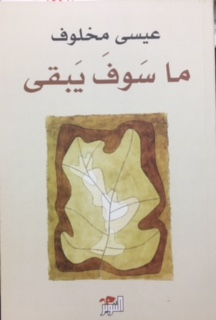منذ أن قارَب اللسانيون الشعر، بعامة، وقصيدة النثر بصورة خاصة، لم يكفّ النقد عن التبلور وتجاوز الصيغ والتوصيفات والخلاصات والمعايير، في طبيعة هذا النوع الجديد - نسبياً، أي وليد أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين – وفي مساءلة لغته الشعرية وتكوينها ودلالاتها.
يقول فردينان دوسوسور:"كلّ شيء يتنادى في الأبيات، بصورة أو بأخرى". وأنا لا يسعني سوى محاولة قراءة الشعر بصيغه وأبياته وكلماته ورموزه التي انتهى إليها الشاعر اللبناني عيسى مخلوف المقيم في باريس بعد تجربة قاربت الأربعين عاماً، منذ كتابه الأول "نجمة أمام الموت أبطأت"(1981) وحتى كتابه الأخير "ما سوف يبقى" الصادر عن دار التنوير (2019).
بين النصوص الشعرية النثرية ذات الأبعاد الغنائية والتأمّلية المكثّفة في الطبيعة والحرب والانوجاد والتقاط اللحظة قيد الهروب، في كتابه الأول (نجمة أمام الموت أبطأت)، وبين قصائد النثر المفردة والأناشيد المقتصدة ذات الإيحاءات الفكرية والصوفية المكثّفة بكتابه الأخير يتأرجح الشاعر عيسى مخلوف، ويستأنف صوغ لغة شعرية ما برحت تكويناتها ودلالاتها تتنادى في تأنّي الرسّام والمهندس المقلّ والضنين بتوشيحات اللوحة وخشب إطارها بمقدار ضنّه برسمتها النهائية ومشهدها الجديد حكماً.
"جميلةٌ هي الأرضُ. جميلة هي السّحابة المتهادية وحدها في سماء زرقاء، كطائر ضيّع سربَه وشرطَ طيرانه ...") (نجمة أمام الموت أبطأت)... "لم يكن ثمّة ما يشيرُ إلى أننا غرباء / كنّا نسيرُ معَ غيرِنا في الشارع / ومع ذلك عرفونا...") (ما سوف يبقى). إذاً، ينصرف الشاعر عيسى مخلوف، في ما يكشفه للقرّاء كتابُه الأخير، إلى بلورة لغة شعرية قادرة على تدوين (أو تأوين) فعل الذات الشاعرة والملتزمة في الوجود، بحسب هايدغر، بتعرية المآسي الكبرى التي يحياها البشر، وهو واحد منهم، من مثل مأساة التهجير والترهيب والقتل والاندفاع إلى الهروب الجماعي نحو بلدان اللجوء بحراً والغرق في اللجج، جماعات وأزواجاً وأطفالاً، ولا من ينجو أو يلتحق بنسيب أو قريب. كلّ ذلك، من دون أن ينسى الشاعر مخلوف تدبير لغة قصائده، وغربلة معجمها، والعناية بهندستها الدقيقة وحسبان البياض فيها ومقدار التأويل الذي يحسن به تركه للقارىء النّبه، والشّعر الخالص، بمنظور الشاعر، واجدٌ حيّزاً لغير المؤلّف أن يستكمل به عالم الشعر الموازي وتراكيبه وصيغه ودلالاته الرمزية الكامنة.
إيقاعات وصور
وأياً يكن مقدار الوجدانية المصفّاة في كتابة الشاعر الأولى، فإنّ مآل هذه الكتابة، في الكتاب الأخير يدلّ على نضج بيّن في هندسة التجربة الشعرية وبنيان عمارة قصيدة النثر وفق جمالية محسوبة، وإيقاعات داخلية تتجاوب مع الصور الشعرية الفريدة والمشاهد المختارة بعناية بالغة، مختلطة بسردية ذات أفق إنساني صارخ. "ألم تقولي لي، في بداية الرحلة، وانتِ تنظرين / إلى ذلك الخاتم: "إن هلَكتُ أنا فهو لن يَهلكَ / وإنْ غرِقَ فلا يموت؟" (ص:16، أحلام الغرقى).
يتبنّى الشاعر مخلوف، إذاً، قضية المهاجرين المهجّرين من بلادهم، والهاربين عبر البراري والمحيطات صوب بلاد الأمان، كما أسلفنا، تبنّياً كاملاً، تصير معه المأساة الموصوفة جزءاً لا يتجزّأ من مأساة كيانه الشخصي، وعنصراً لا ينفصم عن تجربته الوجودية الناظرة إلى الآخر على أنه صنوٌ لذاته، على حدّ ما يقول ريكور. ولكن من دون أن يستدعي هذا التواشج إعلاء للنبرة أو تظهيراً للغنائية الوجدانية التي لم يعد هذا زمنها، على ما بدا لي. "اللاجئون جروح مفتوحة تسيل من حدود إلى حدود / لا يتذكّرون من الماضي سوى أيديهم / التي لم يلمسها أحد"(ص:18، بين القارّات).
وترى الشاعر عيسى مخلوف، في قصائد أخرى، يواصل نسج متواليته الشعرية عن المهاجرين أولئك فيصف "نومهم في العراء" وامّحاء ذواتهم وانتفاء كرامتهم الإنسانية إذ يعبرون بلداناً غريبة ومضيافة على مضض. "في العراء ينامون / يتحسّسون عظامهم تحتَ المطر / يتلمّسونَ مرّة أخيرة أوهامهم".(ص:14). أو: "لا يحتاج الموتى إلى هواء وماء / يتخفّفون من الأشكال المرئيّة ويذهبون مع الموسيقى / التي لم يُعثرْ عليها" (ص:15).
في الباب الأول من المجموعة الشعرية "نظرات الدّمى" (ص :9-20) يستجلي الشاعر مأساة المهاجرين المنفيين التي سلف الكلام عليها، ومن ثمّ يخصّ الباب الثاني، وهو بعنوان "نهاية الكرنفال" (ص:21-33) بعدد من المشاهد والمناظر التي يُستدلّ منها على حالة من العنف المضمر والعدوانية الكامنة تحت غلاف الهويات المتحفّزة للصراع القاتل ."تحت سماء وديعة / تستلقي حمامة على ناصية الشّارع / وقربها نقطة من دمها". (ص:23). أو: "من يُصلح هذا العطب الأصليّ / هذا التصدّع الذي يبدأ الكون؟"(ص:24). أو: "من يعيد التوازن إلى الماء الممهور بالصّاعقة / إلى العشبة اليتيمة بعد منتصف الليل؟"(ص:27). أو: "المتحاربون يجمعون الأيام / في صناديق كبيرة / مع جثث القتلى ..." (ص:31)
وفي الباب الثالث المعنون "عبور" يعمد الشاعر إلى تحويل كل العلامات الرومنسية المأثورة لديه إلى نذر شؤم ويأس وسلبية مطلقة في نظر الكائن، ولا يلبث أن يفصح عن السبب في ذلك التحوّل؛ وهو أن العلوم تؤدّي دوراً معادياً للحضارة الإنسانية، وتهدّد بفناء البشرية: "السلاح الفتّاك يُلهب المخيّلة / ويخترق الرّوح / ينزع الأفق من مكانه./ أكملي زحفَك أيتها العلوم!" (ص:38)
وبين هذه الفكرة المتواترة في قصائد الباب، ونقيضها ("الجمال حتماً" ص:58) المتمثّل بجمال "الجبال كلّها، من حملايا إلى الأرز"، تتراوح الأفكار فيها لتشكّل رؤية إنسانية لا يهاب الشاعر من تحميلها شعره المخضّب برومنطيقية مجهضة، وشذرات غنائية مشعّة من تحت ركام الوجود المتعب، والوجدانية التي تأبى إلاّ أن تتصالح فيها الذاتية الفردية الخالصة مع ذاتية الطبيعة والبشر في أعلى درجات معاناتهم واستلابهم. وعلى هذا، فإنّ أميز ما في هذه الذاتية، لدى الشاعر عيسى مخلوف، في مجموعته الشعرية الأخيرة، أنها مصفّاة على نار الألم الإنساني والوجوديّ الأعمّ، مجبولاً بنسغ العصب الغنائي الأصيل. وذلك هو شأن الشاعر في معالجة ثيمات شديدة التنوّع، في الأبواب الثلاثة الباقية، عنيتُ بها على التوالي: وصية المهرّج، وطائرة ورق الطفولة، وموسيقى مرئية، حيث يعاود الشاعر النظر إلى آونات حياته الماضية، ومناظره الطبيعية الأثيرة، وكائناته الحاملة رموزاً (عصفور الهواء)، وتوشيحاته اللونية (ألوان) وموسيقاه، وغيرها باعتبارها مفردات عالمه الشعري الفريد والمتميّز، من منظار أثرها الباقي، أي ذلك الجوهر الذي يستحيل محوه بفعل الزمن، ولربما هذا ما قصد إليه الشاعر في عنوان كتابه "ما سوف يبقى".
مظاهر أسلوبية
وفي ما عدا هذا التماهي بين اللغة الشعرية، في مكوّناتها، مع لغة التشكيل الفنّي (اللون، المنظر، المقاسات، الفضاء، الموسيقى...)، لدى الشاعر عيسى مخلوف، ثمة العديد من المظاهر الأسلوبية اللافتة أعرض لها على التوالي.
أولاً- في المستوى المعجمي: اللافت فيه أنّ الشاعر شديد الانتقائية في حقوله المعجمية، حتى ليمكن تعدادها على مدار المجموعة (الطبيعة، الجسد، الحياة/الموت، الزمن/ الخريف، الحواس/ ما وراءها، الليل، الذكريات.)، من دون أن يعني أنه يستخدمها بدلالاتها الأولية أو الخام، وإنما دأبه إسقاط إيحاءات كلماته الأوّلية من خلال ربطها بسياقات غريبة أو غير مسبوقة - أقلّه- فتحوز هذه المفردات بفضلها سمة التجاوز والفرادة والتسامي المقصود."الأشجار الواقفة بعيداً، الخافية موتها عنَّا، لا تقتربُ منها العصافير..." (ص:28).
وبهذا المعنى، تشكّل الصورة الشعرية المشغولة بعناية الفكر والتجربة وانتقائية الإيجاز البليغ جسراً لعبور الكلمة، لدى الشاعر، من دلالتها الأوّلية إلى مجازها الشعري الحيّ ودلالاتها المشعّة والإسهام في بنيان لوحة المشهد الشعري أو الرؤية الشعرية.
ثانياً- في المستوى البياني: لا أراني مبالغاً إن قلت إنّ الصّور الشعرية، في كتابة عيسى مخلوف الشعرية الماثلة في كتابه الأخير (ما سوف يبقى) تحوز المقام المهمّ في أسلوب الشاعر، وتلك حقيقة تكاد تكون بديهية في الكلام على أية لغة شعرية. ولئن كان استخلاص مكانة الصور البيانية في الكتاب يحتاج إلى المزيد من الوصف والتصنيف - مما لا تقوى العجالة عليه ههنا- فإنّ القارىء شأني تتسنّى له ملاحظة العدد الوفير من الاستعارات المكنية والتشبيهات التمثيلية والرموز المستفادة من التراث الأسطوري التوراتي واليوناني القديم، لا لشيء إلاّ لحمل رؤيته الشعرية وخطابه الإنسانوي على محمل مجازيّ يليق بسموّه وديمومته عبر الزمن. "تلك قصّة قمر مفكّك / يتراقص على نصْل السّيف..." (ص:13)، "وحدها أجنحة النّسر النّحاسيّ تنبسط في الفضاء"(ص:27)، "اللوحة زمان آخر. هنا، لا تنمو شجرة الزيتون في تربة الوحل والدم".(ص:28)، "نلتقط الصّوَر كصائدي الفراشات. نحنّط اللحظة كما حنّط الفراعنة موتاهم" (ص:75)، "نقطف الضحك من أشجار البساتين المحيطة بالنّهر" (78).
ثالثاً- في المستوى التركيبي والهندسي: ونعني بالمستوى الأول عناية الشاعر مخلوف بالإيجاز والتكثيف والاقتصاد في العبارة، مما استحسنته سوزان برنار في تكوين قصيدة النثر، وما انحاز إليه شاعرنا أيما انحياز؛ ذلك أنّ الإشعاع الدلالي بل الإيحائي، برأيي، لا يتحقق في وعي قارىء النصّ الشعري إلاّ إذا كان الأخير مصوغاً بتراكيب شديدة التركيز، وبسيطة التكوين، وبليغة في الآن نفسه، وذات دلالات كثيرة تستدعي منه (القارىء) المزيد من التأمل والتبصّر والاستخلاص.
أما المستوى الهندسي الذي شئت الإلماح إليه، في الكتاب، فأوجزه بملاحظة وحيدة، وهي أنّ الشاعر أنزل قصائده في ثلاث بنى:
- القصيدة المفردة، وهي التي تقوم في بنيان واحد (مقطع واحد، أو صفحة واحدة) وهي الغالبة في الكتاب.
- القصيدة- النشيد، وهي التي تتكوّن من مقاطع عديدة، ذات ترقيم يوناني، وهي أقل حضوراً من الأولى.
- القصيدة - الحكاية: وهي التي صيغت من أجل أن تنقل حدثاً أو حكاية أو انطباعاً سريعاً (الهمس الأول) وهي الصيغة الأندر، بل الوحيدة في الكتاب.