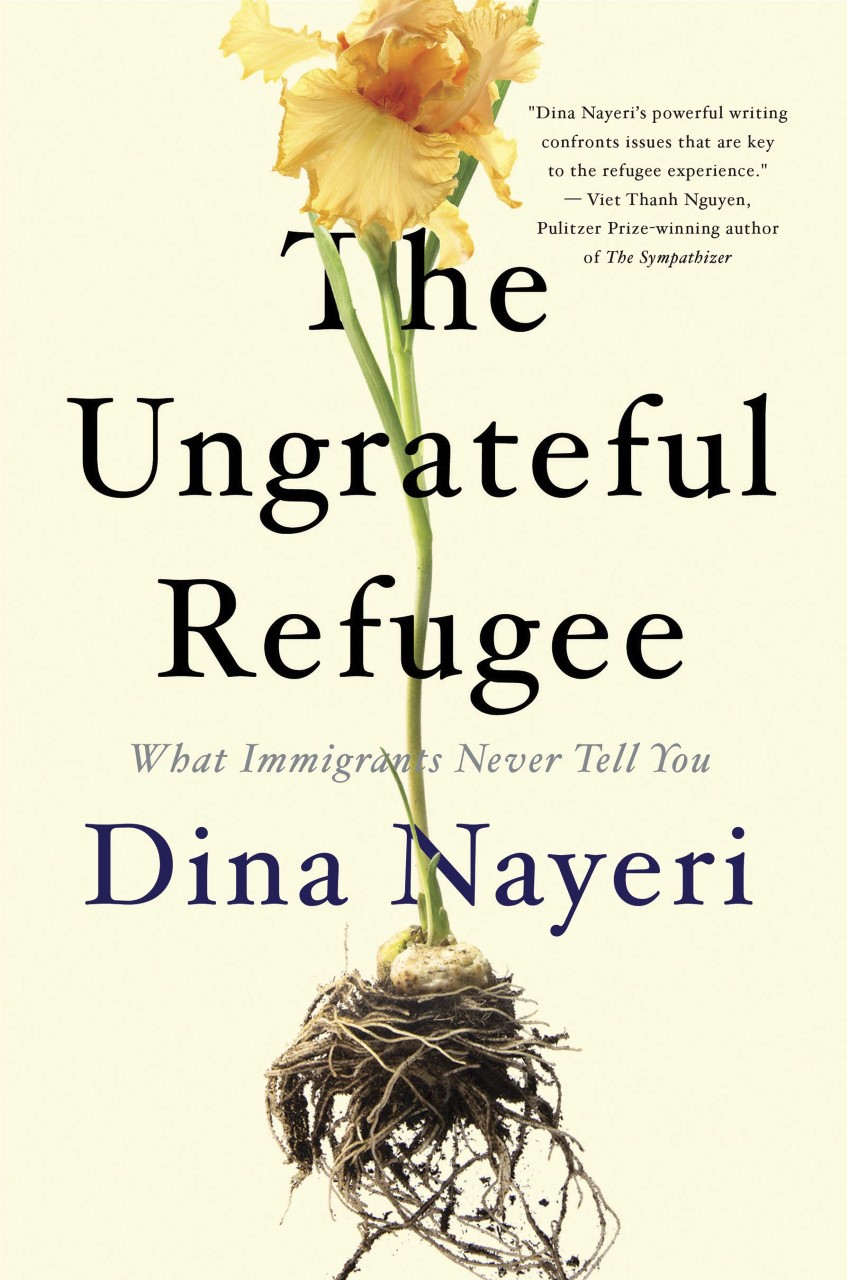ما هو الشعور الذي يتملّك البشر حين يكونون لاجئين في بلدٍ أجنبي؟ سؤال نادراً ما يتوقف المرء مليّاً عنده، على الرغم من وجود أكثر من 25 مليون لاجئ اليوم في مختلف أنحاء العالم. وهذا من دون شك ما دفع الروائية الإيرانية دينا نياري إلى محاولة الإجابة عن هذا السؤال في كتابها الجديد، "اللاجئ الجاحد"، الذي صدر حديثاً في نيويورك عن دار "كاتابولت"، ويستمد قوّته وقيمته من ارتكازها فيه على تجربتها الخاصة كلاجئة لكتابته.
وتجدر الإشارة بداية إلى أن نياري سبق وقاربت هذا الموضوع في روايتها "لجوء" (2017). وحول سبب عودتها إليه اليوم، في نصّ تأمّلي وحميمي، تقول الكاتبة: "... لأن العالم يتراجع. حين أتتبّع الأخبار في وسائل الإعلام، يتبيّن لي كم أنه من الضروري كشف حال اللاجئين اليوم وسرد قصصهم بالكامل وبطريقة غالباً ما يتجنّبونها مع أبناء البلدان التي استقرّوا فيها، بعيداً من شعور الامتنان الذي يبقى في غير محلّه. هدفي ليس إظهار إسهامهم في المجتمعات التي تحتضنهم، بل كيف تتحوّل هذه المجتمعات إلى فخّ لهم، كيف يعيشون فيها ومدى معاناتهم داخلها. أريد أيضاً أن أبيّن كيف أن خطوة الفرار إلى مكان آخر قادرة على قولبة كل ما يليها، وكيف يمكن لصفة "لاجئ" في الغرب أن تثير هاجس الهوية وإشكالياتها. وأكثر من أيّ شيء آخر، أريد أن أمنح العالم سردية كاملة لعملية استقرار اللاجئ في وطنه الجديد التي لا تعرف غالباً نهاية سعيدة، على الرغم من فرحة الحصول على حقّ اللجوء الأولى".
ولبلوغ كل هذه الأهداف، تستعين نياري بقصّتها الخاصة كنموذج تقابله بقصص لاجئين أو طالبي لجوء آخرين خلال السنوات الأخيرة، مدخلة القارئ إلى حياتهم اليومية ومتوقّفة به عند مختلف مراحل سفرهم، منذ فرارهم من وطنهم وحتى استقرارهم في بلد آخر، مروراً بكل العقبات والمطبّات وإجراءات طلب اللجوء المضنية. هكذا نعرف أن الكاتبة فرّت من إيران إلى ولاية أوكلاهوما في أميركا في سنّ الثامنة، بصحبة أمّها وشقيقها، للإفلات من تعسّف نظام الملالي وعنفه. فرار مأساوي دام 16 شهراً وتخلله انتظار طويل في دبيّ، ثم في فندق بائس في إيطاليا. ونقول "مأساوي" لأن حياتها في مدينة أصفهان، كما تصفها، كانت أشبه بحكاية خرافية جميلة، على الرغم من أهوال حرب الخليج الأولى: "كنا نعيش في منزل تزنّره حديقة وردٍ أصفر ويتضمن بركة سباحة. منزل يتوسّط صالونه غرفة زجاجية ضخمة، في داخلها شجرة".
مضايقات واضهاد
لكن اعتناق أمّها الديانة المسيحية، على غرار جدّتها، قلب حياة عائلتها رأساً على عقب. فخلال عهد الخميني، اعتُبر المسيحيون كفّاراً وتعرّضوا للاضطهاد، وبين ليلة وضحاها، أصبحت نياري عرضة لمضايقات في مدرستها على يد أساتذة متزمّتين، بينما تعرّضت أمّها للاعتقال ثلاث مرات، ما جعلها تقتنع بضرورة الفرار مع ولديها إلى الخارج. فرار ترصد الكاتبة له صفحات غزيرة داخل كتابها لوصف، بصوت مجروح وغاضب، الصدمات المتتالية التي تلقّتها أثناءه: "على مدى عقدين، حدّد فرارنا ماهيّتي وهويتي"، تقول نياري في مطلع نصّها، وتضيف: "قولب (هذا الفرار) شخصيتي ووقف خلف جميع قراراتي". ولا عجب في ذلك، فحياتها في إيران كانت نعيماً مقارنة بما كان ينتظرها في أوكلاهوما حيث اضطرت إلى العيش طويلاً مع أمها وشقيقها في مجمّع سكني مرصود للبؤساء، واختبرت التمييز العنصري على يد أطفال حيّها ومدرستها الذين كانوا يسمّونها تارة "آكلة القطط"، وتارة "الإرهابية"، وتارة "زنجية الصحراء".
ولا تختلف تجربتها عن تجربة معظم النازحين الذين تروي قصّصهم في كتابها. ومن بين هؤلاء، الإيراني داريوس الذي تعرّض مراراً لعنف ميليشيات الحرس الثوري بسبب علاقته العاطفية بامرأة خارج إطار الزواج، ومواطناه كاوه وقمبيز اللذان فرّا من إيران بسبب انتمائهما إلى مجموعة سياسية كردية تطالب بالديمقراطية. فرار غالباً ما يؤدّي إلى توقّف حياة مَن يُقدِم عليه وقبوعه داخل دائرة ذلك الانتظار الذي لا ينتهي، كما حصل مع قمبيز الذي أحرق نفسه في ساحة "دام" في أمستردام، عام 2011، بعدما انتظر عشر سنوات ــ عبثاً ــ للحصول على حقّ اللجوء.
لكن القصص التي نقرأها في كتاب نياري ليست كلها حزينة، إذ هنالك قصة الزوجين اللذين وقع كل منهما في حبّ الآخر على الهاتف، وقصة تلك النساء اللواتي يجتمعن بانتظام في منفاهنّ لتحضير أطباق تذكّرهن بحياتهنّ السابقة في وطنهنّ، وقصة ذلك المثلي في السرّ الذي دافع بشكل مؤثّر عن قضيته أثناء طلبه اللجوء، من دون أن ننسى قصّة ذلك المترجم النبيل الذي يكرّس وقته لمساعدة النازحين على إيصال سردية حياتهم إلى موظّفي دائرة اللجوء.
ولنقل هذه القصص الى القارئ، تشحذ نياري نثراً حيوياً فعّالاً، متجنّبة أي حكم أخلاقي على "أبطالها"، ولا تتردد أحياناً في حبك خيوط هذه القصص بخيوط قصّتها الخاصة، حين تتطلّب مرافعتها ذلك. نأسف فقط لأن بعض هذه الخيوط رفيع وقصير جداً أو مقطوع بطريقة تتركنا على عطشنا أو تجعل أسماء بعض النازحين المستحضَرين تلتبس علينا حين تتكرر أكثر من مرّة. وما يسهم في هذا الالتباس هو عدم اتّباع الكاتبة في نصّها أي ترتيب زمني، بل موضوعي.
ومع ذلك، يبقى "اللاجئ الجاحد" كتاباً مهماً لا تعود قيمته إلى قيمة الشهادات التي يتضمّنها فحسب، بل أيضاً إلى ذلك المزيج الحاذق من الرقّة والبصيرة المستثمَر في كتابته والذي يجعل من قراءته تجربة فريدة ومؤثِّرة تسهم حتماً في تبديد تلك اللامبالاة التي ما زالت تلفّ بشكل واسع موضوعه.