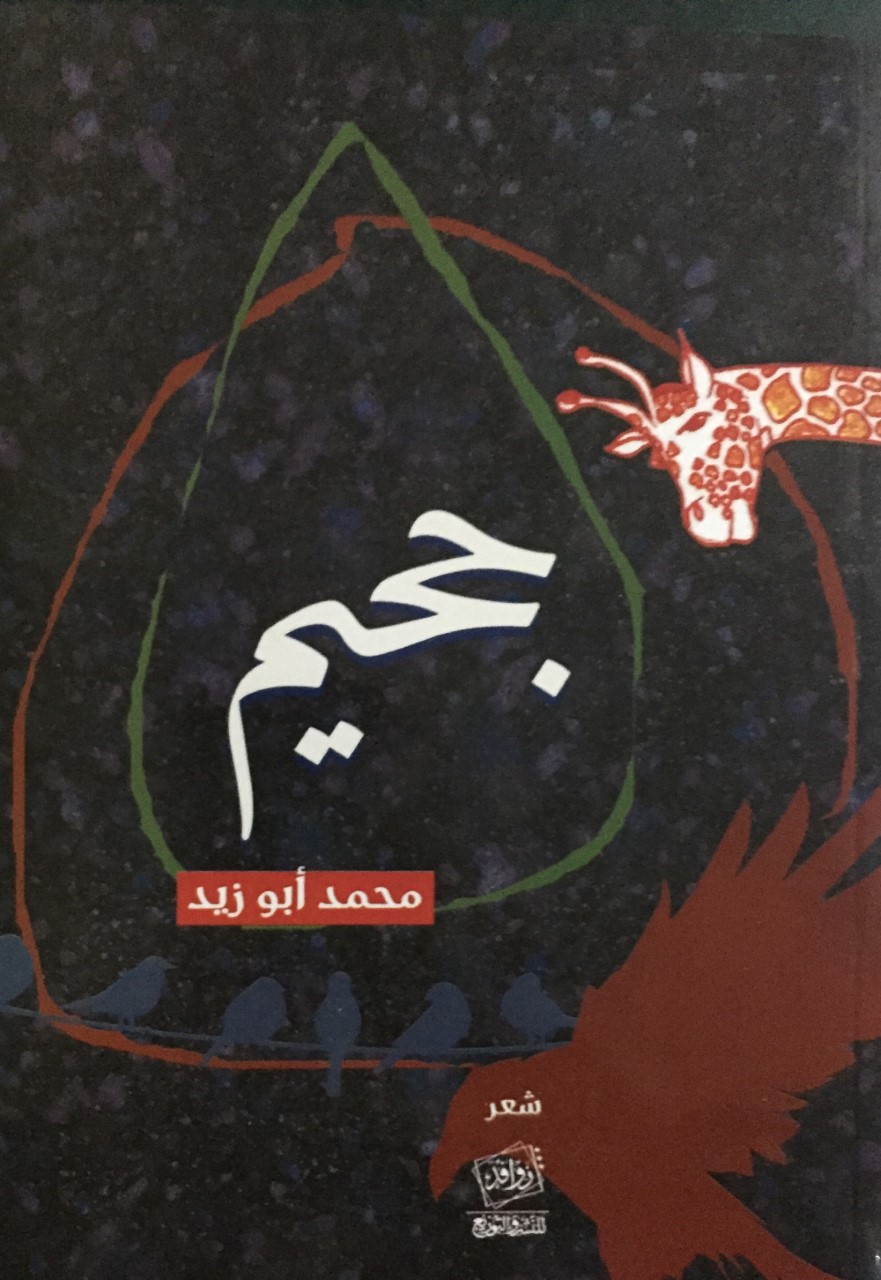في ديوانه الثامن "جحيم" (دار روافد، القاهرة)، الفائز حديثاً بجائزة الدولة التشجيعية في الشعر، كأول ديوان قصيدة نثر ينال هذا الاستحقاق، يسلك الشاعر محمد أبو زيد دروباً مُغايرة لم يتقصدها على هذا النحو في دواوينه السابقة، وهي مسارات ممهدة بدت أكثر بساطة واختزالاً وسهولة وتلقائية في بلوغ الهدف، لكنها أقسى وأفدح في تعرية الأجواء المحيطة وفضحها بشكل فجائي صادم، "هناك دماء على النافذة منذ الصباح/ لن أمسحها/ حتى لا أعطي مبرراً للتاريخ أن يعيد نفسه".
في عمله الجديد، يمضي صاحب "ثقب في الهواء بطول قامتي"، و"قوم جلوس حولهم ماء" و"مديح الغابة" و"مقدمة في الغياب" و"سوداء وجميلة" وغيرها من الدواوين المتحققة في المشهد الشعري المعاصر، صوب توسعة تلك الفجوة التي أراد إحداثها في الهواء الرديء، وإن بقيت دائماً أضيق من عذاباته، وأصغر من ظله الأسود، ولكنه يعبرها بهدوء من غير فقدان لحمولته من الألم، صوب منطقة برزخية مناسبة لما ينشده من خلخلة، ومواتية لما يرجوه من تفتيش عن رحيق الدم الهارب من العروق، ورائحة الخميرة الآدمية المتسربة من الضمير.
تعريف خاص للشعر
يطمح أبو زيد في ديوانه إلى إنجاز أحد عناوين قصائده "تعريف جديد للشعر"، وهو في "توجساته الشعرية" لا يريد أن يبدو متعمداً، فيصدّر القصيدة كمرآة لنظرته العفوية إلى كل ما هو شاخص حوله. ومن ثم فإن الشعرية تأتي سابقة لما يُسمى بالتأليف، وما يتعلق به من إمساك بالقلم وتدوين للعبارات، فهي شعرية التصور والاختيار وإيجاد معان مختلفة لكادرات تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنه يُكسبها أبعاداً ثرية، كالنص الذي يرسم فيه غراباً يفشل في إلقاء قصيدة نمطية لقبح صوته واتساخ ردائه، لكن الطائر في النهاية يرفرف سعيداً ويكتشف أنه بحد ذاته قصيدة مكتملة، كونه يطير ويعرف الطريق.
يعول الشاعر في تجلياته البريئة على هذه الصور الفانتازية والسرديات العجائبية، وقد يطورها إلى مشاهد ذات طابع سحري وطقوس سوريالية، أملاً في تجاوز السكون وكسر الملل والرتابة في دقات القلب وفي نبضات الشعر في آن، فالكتاب الحيوي التفاعلي الذي يحلم به هو ذلك الكتاب الذي "يقضم أصابع اليد التي تمتد إليه لكي تُمسك به".
من هذه التصويرات القصصية الممتدة ما أورده في قصيدته "حروب عائلية"، "لم يعد من الحرب إلا رأسي، وضعته العائلة في النيش، أمام طاولة الغداء بالضبط... مع الوقت، لم يعد يهتم بي أحد، واحد علق في أذني صنارة، واحدة خبأت في فمي قرطاً مسروقاً/ استعمَلوا رأسي في أشياء أكثر نفعاً، مرة علقه أحدهم في النجفة، وتعلم على وجنتيّ اللكم/ حين تهدم المنزل، تركوني هناك، وحيداً على البلاط، مثل كرة قديمة مفقوءة، عيناي مفتوحتان، منهما تنطلق الرصاصات، وترتد إلي".
وإلى جانب رثائه لذكرياته القديمة بسخرية ومرارة، وتشييعه للقلم الناقص من علبة ألوان الطفولة، فإنه يقيم في قصائده عشرات الاحتفاليات التأبينية الباكية والجنائز الحارة في وداع الأحباء، أولئك الذين "خرجوا صباح العيد، ولم يعودوا"، حيث كانت الأيام الخالية كلها أعياداً.
وآخر ما يرثيه، هو العقل، الذي بعده صار يخاطب الموجودات كمجنون، ولا يجد في الخرائط غير الخرائب، حتى بعدما تنفتح أمامه بوابات الأسطورة، ويداعبه الأمل اللحظي في الماوراء، "افتح يا سمسم، لا كنوز هنا، لا شيء سوى فيروسات متجولة، تتنقل من قدمي إلى صدري، لا شيء سوى سعالي يضيء المكان، وحائط أسود أخاطبه كمجنون، ولا أعرف ماذا يحدث وراءه".
المتلقي الشبح
لا يثق محمد أبو زيد في الغد، الذي سيتغير فيه شكل الكتب "ستكون على هيئة كوب عصير، كتاب بطعم المانغو، آخر كالبرقوق، واحد ينتهي من شفطة واحدة، وثان يدفعك للتقيؤ". كذلك ستنتشر "ماكينات بيع عصائر الكتب" في القطارات والمدارس ومحطات المترو، لكن لا أحد سيشتري. ولا يكترث الشاعر بالقارئ وفق النظرية القائلة، إن التلقي ضرورة لاستكمال الكتابة، ذلك أنه يكتب لكي يكتب، ويسكب أرصدته النفسية والذهنية والعاطفية لآخر رمق، ولا يرى في القصيدة غايات عليا وقيماً فوقية محفزة على تغيير الخطايا واعتدال الميزان.
على الرغم من ذلك، يتحسس محمد أبو زيد متلقيه في الظلام بالمصداقية في نزع أوراق التوت عن عورات الذات والعالم معاً، وبالاستمتاع بالحفر الجمالي وتشذيب الطبقات الشعورية العميقة كغاية، حتى في مستنقعات القبح وغابات التشوه وباحات التلوث والأدخنة والغبار والنفايات. وفي قصيدته "وداعاً أيها القارئ"، لا يكف عن شق طريق إلى النور، من منظور فني لا وظيفي، حتى في آخر لحظة قبل حلول العدم، "بيت مختبئ خلف الأشجار، لا يراه أحد من الخارج/ أنا فقط أعرف الممر الضيق، أملك المفتاح الصدئ/ أصعد السلم الصغير، أفتح النافذة/ أنتظر وعدك لي يا إلهي، بنهاية العالم".
نثارات وشظايا
وفي التربة البعيدة المخاتلة، الصالحة لدفن الخلايا الميتة والأثواب الموروثة البالية بقدر صلاحيتها لزراعة بقايا الأمكنة والأزمنة المحبوسة في العظام والجماجم، يستنهض الشاعر القوى الخفية في قدميه، لتمشيا حافيتين بغير بوصلة دالة ولا خريطة هادية. ويُخطر ذراعيه وجناحيه بأنْ لا مجال هنا للانتماء إلى جاذبية الأرض ولا إلى قوانين الفَلَك. فالمهاجر المنفي بقراره من جحيم الواقع الآلي الكابوسي، عليه أن يحفظ اتزان ذاته بذاته في رحلة هندسة الحياة الجديدة، أو اصطيادها من سراب بصنارة صغيرة، كي لا يكون البديلُ المنشودُ هرباً فارغاً، أو سقوطاً في جحيم أخرى أبدية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في هذه التجربة، يتراءى أن الفعل الشعري من أجل محاولة توليد قصيدة النثر بنكهة ذاتية، هو ترجمة للعمل الإنساني الفردي من أجل محاولة تخليق الوجود وابتداع الأنا بتجميع نثاراتها وشظاياها وانخراطاتها في ثنايا الحدث المعيش البائس، المُنهِك للحواس والمشاعر بقسوته وبرودته. هو سعي حثيث إلى أن يكون العالم الفني هو نفسه العالم البشري، وكلاهما مشغول بملفات الحاضر والمستقبل التي لم تعد سرية، والتي لا تحمل نهايات سعيدة، كالتي تحدثت عنها الكتب الكلاسيكية والبلاغات المحنطة.
وأمام جبل من العطب يكبر يوماً بعد يوم، "حتى أنني لا أرى نهايته"، مثلما يقول أبو زيد في قصيدته "قمة إفريست"، يتخلى المنهزمون في اللعبة عن مبادرتهم وإقدامهم، فالسيارة البترولية هي التي تقود راكبها إلى البيت الحزين، وهي التي لا تكف عن النواح لأنها تدرك الطريق/المصير جيداً، وتستشرف المسكوت عنه.
التخلص من الأيام
وفي حين ينخر سوس التقدم الزائف والتقنية المخادعة أصول الحضارة وجذور الظواهر وجوهر المعاني والعلاقات الروحية والوجدانية، فإن التلف الذي طال كل شيء يستثني الحروب الدائرة ماكيناتها بانتظام، موسماً بعد موسم، وحصاداً بعد حصاد، "نفتح الأبواب، فنجد الجثث على السرائر، رماد المصطافين على الشاطئ، بقايا النادل في المقهى، مقابر الأطفال في ملعب الكرة".
وفي سبيلها إلى توسُّل الخلاص من مجتمع مأزوم يتحدث أبجدية الجحيم، تتحصن الذات الشاعرة بالتجريب على أكثر من مستوى، في الخطو المباشر على الأرض، وفي الاجتهاد لإيجاد الرؤية والتعاطي مع الملموس والاستشعار الداخلي الحدسي، وفي اقتراح الصور الخيالية واستعمالات اللغة كوعاء لتوصيل الحالة "كما هي"، دون تنميقها وإثقالها بالتزيين والحلي والمجازات، إضافة إلى التخلي عن الأقنعة والتأويلات الملتوية، وانتهاج البساطة بحذر على مقربة من حدود التسطيح، وفتح القصيدة على أنماط إبداعية وآليات فنية موازية، خصوصاً السرد والتشكيل والمسرحة واللقطة السينمائية.
وبغير هذه الرغبة في تسمية المصابيح والأشياء جميعاً بأسمائها أو إكسابها كُنيات تطابق شحناتها وطبيعتها المفقودة، فإن السأم هو الوباء الذي يغتال كل ما في حركة الحياة الممكننة، وهو ما يشير إليه في قصيدته "وبالباقي علكة"، حيث يتخلص البشر من أيامهم، ليأسهم من بلوغ لحظة صدق، "ذات يوم، سنشتري الأيام من الصيدليات والحوانيت على الطرق السريعة، في عبوات صغيرة سهلة الفتح/ أسبوع، أسبوعان، شهر على الأكثر (للحجم العائلي)، لأوقات صاخبة، وحزينة، ومريعة/ لا يوجد إقبال كبير، كما قد تتوقعون/ سيكون الناس قد ملوا الحياة، وفضلوا الذهاب إلى الأسواق السوداء وعيادات الإجهاض، للتخلص من أيامهم الباقية، أو مقايضتها جميعاً، بعود كبريت، أو لحظة واحدة حقيقية".