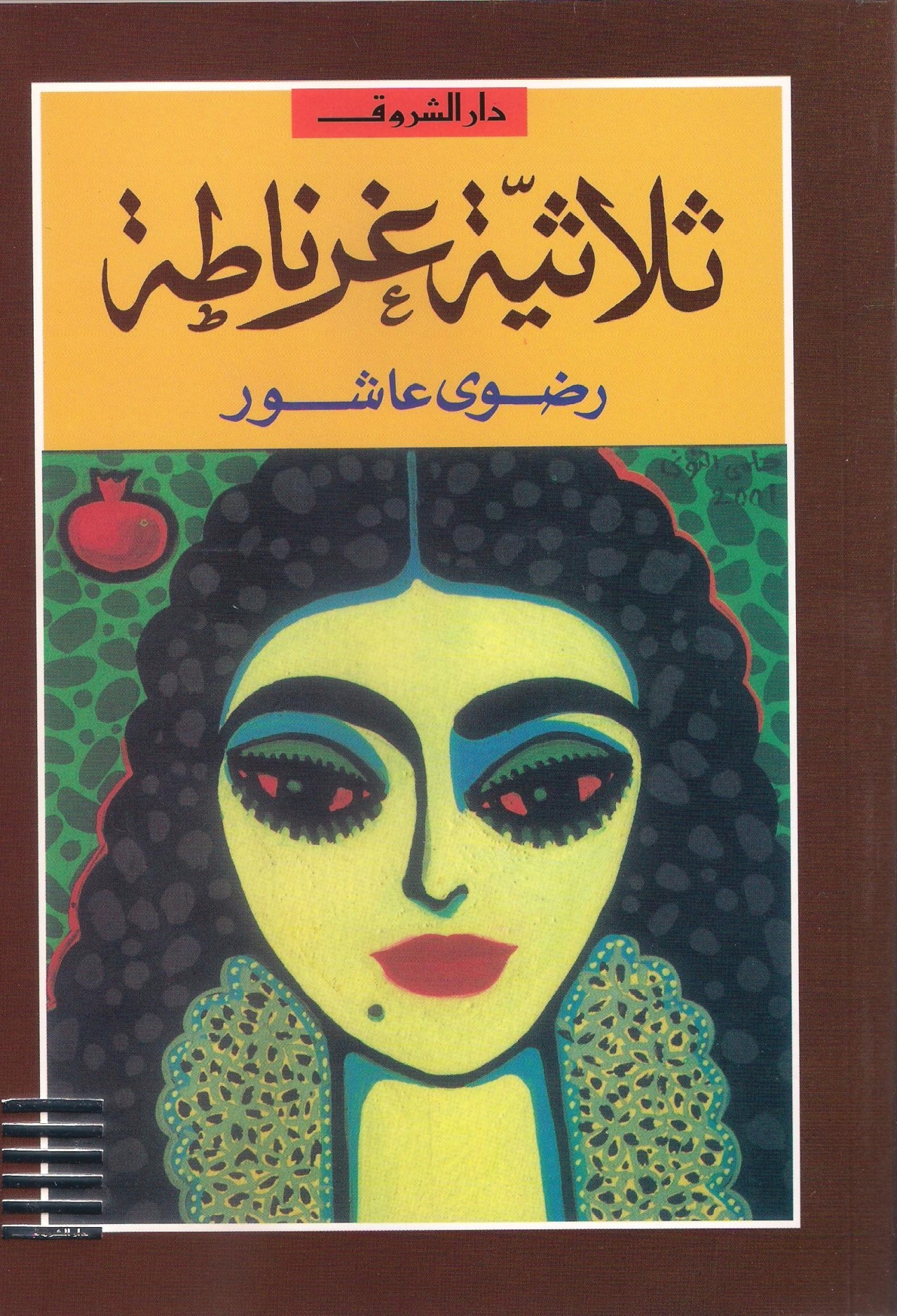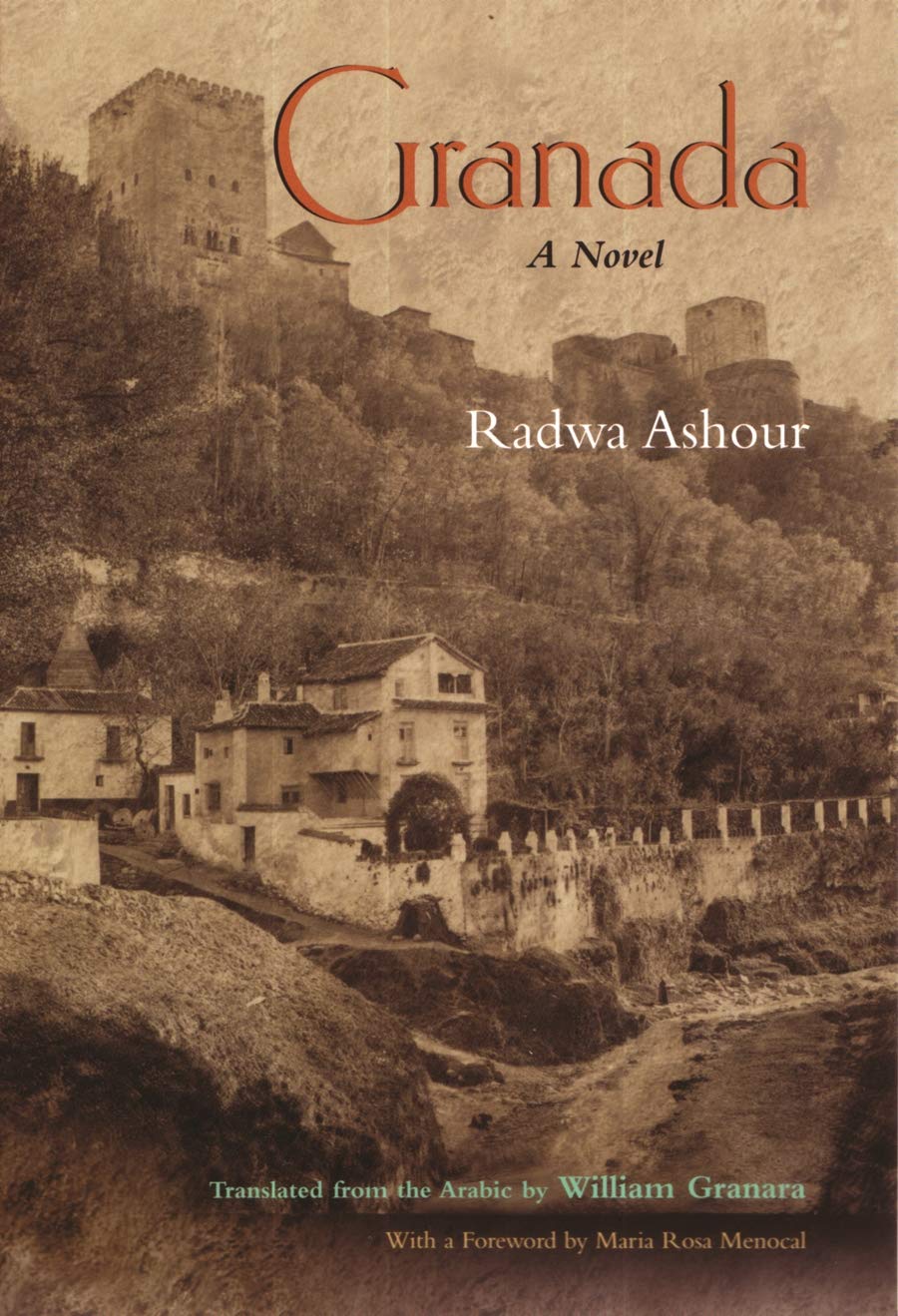لن يكون من المستغرب بالتأكيد بالنسبة إلى القارئ العربي لـ"ثلاثية غرناطة" للكاتبة المصرية رضوى عاشور (1946 – 2014) أن تكون الفكرة الأولى التي ستخطر في باله ما إن ينتهي من قراءة الصفحة الأخيرة من بين مئات الصفحات التي تتألف منها الطبعة العربية الأصلية، تتعلق بالعبارة الشهيرة التي تحدث بها يوماً عن العرب ذاك المغامر الأفّاق الذي عُرف بـ"لورانس العرب" وجعلها المحور الأساس في كتابه العمدة "أعمدة الحكمة السبعة": "إن العرب هم أهل البدايات الجيدة والنهايات السيئة". ولئن كان ما يذكّر قارئ رواية رضوى عاشور بقول لورانس هذا، هو المصير المظلم الذي يصور به قلم الكاتبة المصرية الكبيرة الراحلة، نهاية تلك الحضارة التي بناها العرب في تلك المنطقة من العالم ولا يزالون يحنّون إليها إلى اليوم ويعتبرونها "فردوسهم المفقود"، فكانت ذات بدايات مدهشة لتنتهي نهاية في غاية السوء. فإن الأجدر بالقول هنا هو أن الرواية يكاد ينطبق عليها القول ذاته، ما يضع القارئ أمام حيرة إزاء عمل كان في إمكانه أن يكون معلماً كبيراً في تاريخ الرواية العربية ومجدداً في الرواية التاريخية كما كان يُعدّ في الجزء الأول، فإذا به وفي تطبيق حرفي لمقولة لورانس، يتقلص جمالياً وفكرياً وحتى حجماً بالتأكيد من بعد نهاية الجزء الأول المعنون "غرناطة"، تقلصاً يشي بأن الكاتبة بعد انطلاقتها الأولى على مدى نحو نصف صفحات الثلاثية راحت تبدو وكأنها فقدت سيطرتها على العمل أو أضجرها، فتركت إبداعها وهندسة العلاقات والمناخات والحوارات، ناهيك عن التطور التاريخي للشخصيات الذي من الواضح أنها أرادته أن يتواصل سنين طويلة ليحتضن الأعوام الأخيرة من تاريخ الأندلس، فعجز عن ذلك.
نوع أدبي جديد
ومن هنا، بقي النصف الأول من الثلاثية عملاً شامخاً مكتملاً ينتظر نهايته المنطقية التي لم تأتِ أبداً. وفي يقيننا أن العيب الأساس الذي حال دون ذلك هو الأيديولوجيا. وقد يستغرب القارئ هنا حكماً نطلقه بهذه السرعة على عمل إبداعي نال إجماعاً من القراء وكبار النقاد حتى الآن ولا يزال متدوالاً بينهم منذ ما لا يقل عن ربع قرن مضى على صدور الثلاثية متكاملة، وعلى عمل يُعتبر منعطفاً في الأدب العربي وبوّأ صاحبته قبل رحيلها المبكر والمفجع مكانة أساسية في هذا الأدب، بل حتى خلق معادلاً عربي اللغة وربما عربي الهوى أيضاً للرواية التاريخية التي سبقتها، متناولة جانباً من التاريخ ذاته، إنما بلغة فرنسية لكاتب عربي هو أمين معلوف، ونعني بها طبعاً "ليون الأفريقي" التي منذ صدورها قبل أعوام من صدور "ثلاثية غرناطة"، فتحت شهية كثر من كتّاب عرب وغير عرب لخوض هذا النوع من الأدب التاريخي البديع، فوُفّق كثر وأخفق آخرون، لكن الأمر تمخّض عن ولادة جديدة لنوع أدبي، بات ذا شعبية هائلة. ولا شك بالنسبة إلينا في أن رضوى عاشور كانت من بين الأكثر اجتهاداً في خوض مغامرة من هذا النوع، وكادت ثلاثيتها هذه أن تبلغ من المستوى ما بلغته "ليون الأفريقي" ولكن مع فارق أساسي لا يمكن عزوه إلى البعد الجمالي أو الأدبي، بل إلى البعد الأيديولوجي الذي تعبّر "ثلاثية غرناطة" عن كونه مرضاً يتغلغل عميقاً في التفكير العربي والإسلامي لعل من أولى علاماته والتي تتملك الرواية بسرعة وتسيطر عليها، تلك التقسيمة بين الأندلسيين ورثة الحضارة العربية – الإسلامية في الجزيرة الإيبيرية من ناحية، و"المحتلين الجدد" المحاولين استعادة تلك المنطقة من العالم من ناحية أخرى. الشر كل الشر لدى هؤلاء الأخيرين الذين قد تشبّههم الرواية بالبيض الذين احتلوا القارة الأميركية في الأزمنة ذاتها التي تتناولها الرواية، مبيدين سكانها الأصليين من "الهنود الحمر" ليحلّوا مكانهم.
كتابات منصفة
حدثياً، قد يكون هذا منطقياً بيد أن المرء سيحتاج إلى أن تكون ذاكرته قصيرة حتى يتنبّه إلى أن من تطاولوا على الحضارة العربية – الإسلامية في الأندلس وسعوا، ثم نجحوا في، "تحرير" شبه الجزيرة منهم، إنما هم سكان البلاد الأصليين من الذين كان يدفعهم أصلاً كون الآخرين، أي العرب والمسلمين هم المحتلون لبلاد لم تكُن بلادهم. صحيح أنهم أقامو فيها واحدة من أعظم الحضارات وجعلوها بؤرة للتسامح واللقاء بين الشعوب والأديان، لكن هذا لا يبدّل من الواقع شيئاً. أما رواية رضوى عاشور، مثل كل الكتابات العربية عن الأندلس، بما في ذلك مؤلفات منصفة كثيرة كتبها مستشرقون وتزايدت وتيرة صدورها خلال الحقبة الأخيرة مع ازدياد الكشف عن أهمية المنعطف الأندلسي في تاريخ الحضارة الأوروبية، لا يمكنها أن تنظر إلى الأمور مثل هذه النظرة التاريخية، تحديداً بفعل الضباب الأيديولوجي الذي لا يزال يغلّف الحكاية كلها.
شخصيات من لحم ودم
من هنا، قد يبدو لنا واضحاً عجز الرواية عن الدنو من أية نظرة موضوعية إلى القرون الأخيرة التي شهدت انتهاء الوجود العربي – الإسلامي في الأندلس، وبذلك قسمت الجميع إلى قسمين، قسم أسود شرير قد تخرقه بعض العلامات المضيئة التي سرعان ما تختفي، وقسم أبيض خيّر تتكاثر فيه علامات السواد ولكنها إما أن تكون هنا للتسبب بسقوط عالم بأسره عن خطأ أو غدر أو مصالح شخصية وفئوية، وإما أن تكون من صنيعة العدو ومتواطئة معه. والحقيقة أن هذا التقسيم، الذي يبدو قاتلاً للسياق المتواصل للفعل الروائي بعينه، لن يكون واضحاً في الجزء الأول، والأروع طبعاً في هذا العمل الكبير إلى حد مدهش، حتى ولا على الصعيد الأدبي الخالص حين تقدّم لنا الكاتبة لوحة فسيفسائية لأعوام بداية النهاية في مملكة غرناطة حين يشتدّ ساعد قوى قشتالة وآرغون مع بدء تراخي الوجود العربي الإسلامي، وذلك من خلال حكاية يتضافر فيها البعد العائلي مع البعد التاريخي ولكن من دون أن تكون الشخصيات، كما الحال مع مثل هذه الروايات عادة، رموزاً وكنايات، إنما أشخاص من لحم ودم وأحلام وعواطف يتعايش معهم القارئ، بل يتماهى حتى غير راغب بأن يتركهم ولو للحظة، لا في بيوتهم ولا في الأسواق ولا في الحمام ولا في الأفراح ولا المآسي الجماعية. هي حيوات متشابكة متلاحمة تتحرك على مساحة رقع جغرافية، تتسع وتضيق على هوى الأحداث التاريخية الكبيرة وتتفاعل معها عبر زيجات وتكوين عائلات وظهور بعضها من اللامكان لتشغل مساحة أساسية لم تكُن متوقعة من الرواية، فتصبح قطب الحركة والفعل فيها متفردة أو متجمعة، كما يليق بشخصيات أكبر الروايات العالمية أن تفعل. ومن هنا، نعيش مع أبي جعفر الوراق أو نعيم وصديقه سعد ونشاركهما صداقتهما. وننتقل منهما إلى أبي منصور وحمامه وزبائنه، ثم نجدنا مع الأحفاد والزوجات في عالم ندر أن وُصف من داخله على مثل هذه الشاكلة وندر أن تمكّن من تصوير ارتباطه الداخلي بالمجرى الكبير للتاريخ في دينامياته المتغيرة. ومن الواضح أن هذا المناخ الذي أبدعت رضوى عاشور في رسمه وبتفاصيله الصغيرة في الجزء الأول، سرعان ما سوف ينهار منذ بدايات الجزء الثاني، "مريمة".
أمام حتمية الرحيل
ففي هذا الجزء الذي يتقلّص عدد صفحاته إلى ما يقل عن نصف عدد صفحات الجزء الأول، سرعان ما تتحوّل الشخصيات إلى كنايات، يشعر القارئ أنها تؤدي أمامه دوراً محدداً، هو أن تحكي لنا التاريخ وكيف حدث ما حدث فيه. فهنا، وهو أمر يتواصل في الجزء الثالث، "الرحيل"، الذي سيدور كما هو متوقع من حول النهاية السياسية المؤدلجة تماماً للأندلس، ستواصل الشخصيات حياتها المرسومة منذ الجزء الأول. فهي في معظمها من بين أبناء وبنات الجيلين الثالث والرابع من العائلات ذاتها التي سبق أن تعرفنا إليها وتفاعلنا في الجزء الأول، لكنها بالتأكيد فقدت كثيراً من نسغها وباتت تتحرك من دون مفاجآت ومن دون قلبات روائية لمجرّد أن تصل إلى تلك النهاية التاريخية التي نعرفها جميعاً، حتى لو تركت الكاتبة للشخصية المحورية في الجزء الأخير، حرية أن يبقى في الأندلس بعد كل شيء، رافضاً تلك النهاية التي ستبدو هنا كالقدر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من ينسف حكم لورانس؟
والحقيقة أننا لن نزعم أن هذا الاختيار النهائي غير منطقي ولا أنه يشعرنا بخيبة ما، لكنه يأتي في سياق يؤكد، للأسف البعد الأيديولجي لفكر راح يتحكم بالنص منذ الصفحات الأخيرة للجزء الأول من رواية، فراحت تفقد نكهتها وجمالها، مكتسبة من التعاطف القومي، ما راحت تفقده من الإبداع الفني والإنساني. ومن المؤسف أن رضوى عاشور، الناقدة والكاتبة والشاعرة الكبيرة قد رحلت قبل أن نعرف ما إذا كان سيمكنها في عمل كبير تالٍ لها أن تستعيد جانب الإبداع، وتتخلى عن الجانب الأيديولوجي، متخلّية في طريقها عن الالتصاق بذلك الحكم الذي أطلقه لورانس يوماً ولا يزال في حاجة إلى من ينسفه، على صعيد الإبداع التاريخي على الأقل.