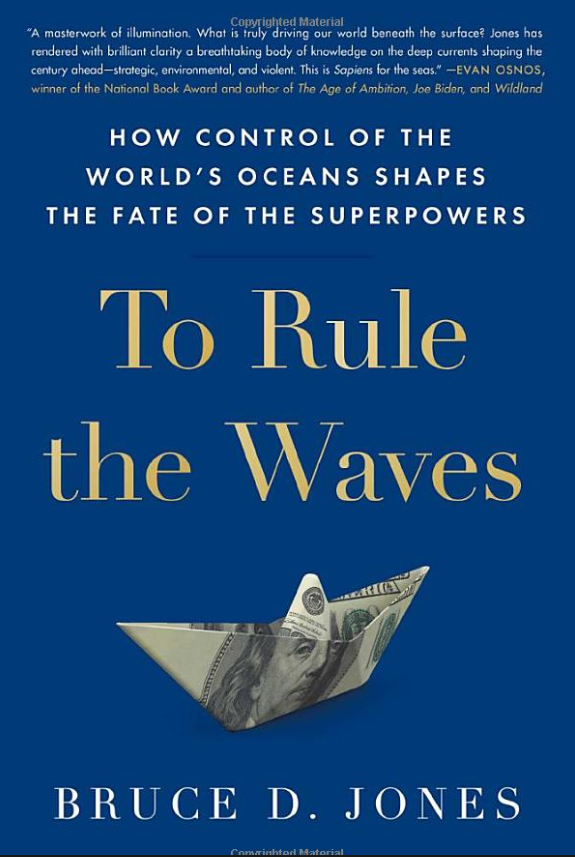في عام 1897، ضغط البرلمان البريطاني على جورج غوشين، اللورد الأول للأميرالية، بشأن التهديد البحري المحتمل الذي يشكله تعزيز التعاون بين قوى البر الأوروبي. وعندما سئل عما ستفعله المملكة المتحدة إذا واجهت عدة أساطيل بحرية أوروبية في البحر، أجاب غوشين بالقول "ستسلم الأمر إلى العناية الإلهية وأدميرال جيد"- أي أن المملكة المتحدة لا تملك مواجهة أي تحدٍّ بهذا الحجم على نحو ناجع.
يمكن قول الشيء نفسه عن الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتهديد الذي يشكله الصعود السريع للصين. لقد تشبثت الولايات المتحدة لسنوات باعتقاد شبه راسخ أن الصين ستصبح أكثر ديمقراطية وليبرالية من الناحية السياسية مع تنامي ازدهارها. والآن، بعد أن دحض النظام الاستبدادي في بكين هذه النظرية، يبدو أن الجمهور الأميركي ليس أمامه سوى الثقة في قادة جيدين بالبحرية الأميركية للتعامل مع التهديد الذي يلوح في الأفق والمتمثل في عدوانية الصين المتنامية، حتى في ظل تزايد اعتماد الاقتصاد الأميركي أكثر فأكثر على الخصم نفسه. ويرجع ذلك إلى أن العديد من المراقبين لا يقدرون إلى حد ما إمكانية تحول المنافسة بين بكين وواشنطن على نحو متزايد إلى صراع على القوة البحرية.
الجمهور الأميركي ليس أمامه سوى الثقة في قادة جيدين بالبحرية الأميركية للتعامل مع التهديد الذي يلوح في الأفق
يمزح المحللون في الشؤون البحرية بالقول إن على الجيش الأميركي، إذا دخل في حرب مع الصين، أن يقصف أولاً ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا، لأن تعطيل التجارة البحرية الصينية إلى الولايات المتحدة سيلحق ضرراً أكبر ببكين من مهاجمة البر الرئيس الصيني. لقد باتت سلاسل التوريد العابرة للحدود الوطنية متشابكة لدرجة أن التأخيرات الناتجة عن الوباء في الصين تسببت في اختناقات ملاحية مكلفة للغاية لسفن الحاويات في ميناء لونغ بيتش، ما دفع إدارة بايدن للنظر في نشر الحرس الوطني للمساعدة في تخفيف الازدحام. لقد أدت جائحة "كوفيد-19" إلى إدراك أهمية هذه الروابط العالمية أكثر فأكثر ودفع بعض الحكومات إلى التفكير في "إعادة توطين" الإنتاج في المجالات الحيوية، لكن شبكات الاستثمار والاتصالات والإنتاج التي تربط الاقتصادات معاً تستمر في التوسع. وتعتبر التجارة والقوة البحرية أمراً بالغ الأهمية لهذه الشبكات العالمية، إذ يتم نقل نحو 90 في المئة من البضائع المتداولة في العالم عن طريق البحر. غالباً ما تدور مناقشات القوة والاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين حول الحدود الجديدة للفضاء السيبراني والفضاء الخارجي، لكن على المدى القريب، سيحسم المستقبل الجيوسياسي في الغالب في ساحة أقدم ومألوفة أكثر ألا وهي البحر.
هنالك كتابان جديدان يقدمان تقييماً لتحديات وأهمية علاقات القوة البحرية المعاصرة. يهتم كتاب "أن تحكم الأمواج" لمؤلفه بروس جونز، وكتاب "العصر الأزرق" لمؤلفه غريغ إيستربروك بالأمن الدولي في المقام الأول، بناءً على فرضية المؤرخ والاستراتيجي البحري ألفريد ثاير ماهان القائلة بأن "تاريخ القوة البحرية. . . هو إلى حد كبير تاريخ عسكري". ويجادل كلا الكتابين بشدة أن أمن الولايات المتحدة وازدهارها يعتمدان على الهيمنة البحرية، وكلاهما ينذر بعودة العنف إلى الطرق البحرية التجارية. سيثير هذان الكتابان غضب الخبراء وسيكونان مدار نقاش محتدم، ولكنهما سيوفران لمعظم القراء رؤى مفيدة حول الجوانب البحرية للاقتصاد العالمي وصعود الصين وتغير المناخ.
إثارة المشاكل
يتبع جونز نهجاً صحافياً، مستعيناً بروايات لقاءاته ومحادثاته كأساس لأفكاره وتفسيراته. ولتسليط الضوء على محورية المحيطات في التجارة والاتصالات اليومية، قام برسم الشبكة الهائلة لخطوط أنابيب الوقود وكابلات النقل تحت سطح البحر، ما يؤكد اعتماد الاقتصاد العالمي على التوصيل البحري. ويوضح بقوة أن المحيطات "تلعب دوراً محورياً بشكل مدهش في واقع الطاقة، وفي الكفاح العالمي لتغير المناخ".
ينطلق جونز لإظهار أن "محيطات العالم أصبحت بسرعة أهم منطقة مواجهة بين اللاعبين العسكريين الكبار في العالم". ويجادل بأن الأنماط التعاونية الخاصة بالقرن العشرين آخذة في التآكل، مما يمهد الطريق لصراع واسع النطاق - وأن الصراعات الجيوسياسية بدأت الآن في أعالي البحار. وبالنظر إلى هذه التوقعات القاتمة، يحذر جونز من تضاؤل الهيمنة البحرية الأميركية. ومع ذلك، فإن توصياته غير واقعية وتفتقر إلى الدقة التحليلية: فهو يدعو، على سبيل المثال، إلى "تحالف التحالفات" حيث تقوم الولايات المتحدة بتنسيق التعاون العالمي بين جميع الاقتصادات المستهلكة للطاقة. كما يقترح أن تعمل واشنطن على "معالجة مسألة الرابحين والخاسرين من العولمة" و"تبني أنواع الخطط اللازمة للحد من انبعاثات الكربون". لكنه يقدم القليل من التفاصيل حول سبل تحقيق أي من هذه المقترحات.
السيطرة على البحر ستكون العامل المحدد للقرن المقبل.
وعلى نحو مماثل، يدعو إيستربروك إلى الحفاظ على الهيمنة البحرية للولايات المتحدة، لكنه يتخذ منهجاً مختلفاً يشي بأنه يخاطب أشخاصاً من اليسار السياسي. يقول إن "كثيراً من الناس لا يحبون المنظمات العسكرية" وإن "أسباب كرههم بديهية، وإنه يمكننا أن نحلم فقط باليوم الذي لن تحتاج فيه دولة إلى جيش أو إلى قوة بحرية".
ومع ذلك، يريد إيستربروك أن يقدم "حجة ليبرالية للبحرية الأميركية" على أساس أن قوتها أدت "إلى تقليص مذهل للفقر في العالم النامي... وتحسين مستويات المعيشة في كل مكان تقريباً". يجادل إيستربروك بأنه بعيداً من الحفاظ على الهيمنة البحرية الأميركية، يمكن لواشنطن أن تسعى إلى تعزيز الامتداد العالمي للبحرية الأميركية من خلال إرسال سفنها إلى عدد أكبر من الموانئ في العالم وإنشاء المزيد من القواعد للدفاع عن حلفائها، وفرض حرية الملاحة. لكنه يقوض حجته باستنتاجه أن الدين العام الأميركي الكبير قد لا يجعل مثل هذه الخطوات ممكنة من الناحية المالية.
يقدم إيستربروك، مثله مثل جونز، عدداً من الوصفات السياسية، لكنه لا يبدي عناءً كبيراً في تقييم البدائل. ويعتبر إيستربروك يوتوبياً يرفع لواء المثل أكثر من جونز، حيث يقترح إنشاء "منظمة للمحيطات العالمية" التي من شأنها توفير "نظام إدارة عالمي حقيقي" لحماية حقوق العمال وتقييد الأسلحة وتنظيم مشاريع الطاقة البحرية وفرض التجارة الحرة وضمان المعايير البيئية في جميع مياه العالم.
يقدم كلا المؤلفين تأكيدات خاطئة أضعفت مصداقية تحليلاتهما وأفكارهما التوجيهية. فعلى خلاف تفسير جونز أزمة السويس عام 1956، لم تكن تلك "واحدة من اللحظات الأولى التي ربما تصاعدت فيها الحرب الباردة إلى صراع حقيقي"، حيث إن أزمة 1948-49 حول الحصار السوفياتي لبرلين والحرب الكورية تناسبان هذا الوصف بشكل أكثر دقة. من جانبه، يقول إيستربروك خطأً إن "الولايات المتحدة لديها من السفن البحرية الحديثة الجاهزة للانتشار في البحار ما يعادل تقريباً ما تملكه جميع الدول الأخرى مجتمعة"، في حين أن الصين تعتبر وحدها قوة بحرية أكبر من الولايات المتحدة. كما أنه يلقي باللوم على التوترات بين الصين والولايات المتحدة إلى "تضخم التهديد من قبل المجمع الصناعي العسكري والتخويف من قبل الصحافيين"، مما يعفي الصين من أي مسؤولية. وفيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، حيث انتهكت الصين بشكل روتيني السيادة الإقليمية للدول الأخرى وأنشأت جزراً اصطناعية لبناء قواعد عسكرية، يستنتج إيستربروك أنه "حتى الآن، تعتبر هذه المياه سلمية في الغالب - وهو أمر لا تحصل بموجبه الصين على أي تقدير من الغرب".
نشر التوتر في المحيط
على الرغم من عيوبهما، فإن كلا الكتابين يمثل محاولات رائعة لجذب عامة القراء إلى تخصص المياه. ولكي تواجه الولايات المتحدة تحديات العولمة وصعود الصين وتغير المناخ، سيحتاج الأميركيون العاديون إلى تطوير فهم أفضل للقضايا البحرية ودور بلادهم كقوة بحرية.
وللحفاظ على النظام الدولي المتدهور الذي أشاد به جونز وإيستربروك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى استعادة القوة البحرية العسكرية والمدنية التي تركتها تضمر. إن الترابط العالمي الذي أثنى عليه كلا المؤلفين قد مكن من ظهور التكتلات اللوجيستية الخاصة الهائلة التي قزمت الآن الأسطول البحري التجاري الأميركي، وهو أمر ضروري لقدرة الولايات المتحدة على التعبئة للأغراض العسكرية في أوقات الحرب. ففي عام 1950، شكل أسطول البحرية التجارية للولايات المتحدة 43 في المئة من أسطول الشحن العالمي. وبحلول عام 1994، انخفضت هذه الحصة إلى أربعة في المئة، على الرغم من قانون 1920 الذي تطلب أن تكون السفن الناقلة بين الموانئ الأميركية مبنية ومسجلة في الولايات المتحدة وأن يكون أغلبية طاقمها من المواطنين الأميركيين. ويحتل الأسطول التجاري الأميركي الحالي المكون من 393 سفينة المرتبة 27 فقط في العالم. وبالمقارنة، تمتلك الصين ثاني أكبر أسطول تجاري بحري في العالم، وهذا لا يشمل أسطول الصيد شبه العسكري السيئ السمعة الذي تستخدمه لشن غارات في المياه المتنازع عليها.
إن افتقار الولايات المتحدة إلى أسطول تجاري كبير يجعل البلاد أكثر اعتماداً على أسطول البحرية، الذي تقلص أيضاً بشكل كبير. لقد كان لدى البحرية الأميركية من السفن في عام 1930 عدد أكثر مما لديها اليوم، بعد أن حلت الصين محل الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم في عام 2020. ويستهدف البنتاغون زيادة حجم أسطوله من 306 إلى 355 سفينة في أفق عام 2034 - وهو هدف بعيد لم يخصص له الكونغرس أي تمويل حتى الآن.
اقرأ المزيد
- شي جينبينغ وسياسته الخارجية المتعثرة
- عرض شي جينبينغ الكبير
- النظام العالمي الجديد وفق شي جينبينغ
- شي جينبينغ يعزز سلطته على رأس الصين بإعادة كتابة تاريخ الحزب الشيوعي
- مقامرة الرئيس الصيني شي جينبينغ
- المحور المعادي للدولار
- أعداء عدوي...
- واشنطن تقرع طبول حرب في غير محلها مع الصين
- ميزة قوة الصين الناعمة في أفريقيا
- نهاية صعود الصين
- شي يحور القانون الصيني لصالحه
- الحرب الباردة الجديدة
إن الاستراتيجية العسكرية الحالية للولايات المتحدة تفرض ضغطا عملياتياً شديداً على هذه القوة المحدودة سلفاً. ونظراً إلى استعداد واشنطن لصراع محتمل مع الصين، والتزامها بإرسال قوات إلى أوروبا في حالة وقوع هجوم على أحد حلفاء الناتو، واستخدامها الزيارات الدبلوماسية للموانئ والتدريبات العسكرية كوسيلة لتوطيد العلاقات مع الشركاء الأميركيين، فإن الجيش الأميركي تجاوز حد قدراته. وفي عدد من المناسبات، بدا أن الرئيس جو بايدن يزيد العبء على الجيش من خلال إلزام الولايات المتحدة علناً بالدفاع عن تايوان – حيث اقترب من إنهاء سياسة "الغموض الاستراتيجي" التي اتبعتها واشنطن منذ عقود حول ما إذا كانت ستقف إلى جانب الجزيرة في حال غزو صيني لها. إنها تشكيلة شاقة من المسؤوليات، لا تستطيع القوات الأميركية تحملها جميعاً حالياً.
ومما يزيد من إجهاد الجيش الأميركي، كما كتب المحلل الدفاعي ماكنزي إيغلن، هو أن القادة المسؤولين عن صياغة خطط الحرب لديهم "مطالب كبيرة (وضخمة) للقوات تتجاوز أو ترهق الإمداد". إن الطلبات المستحيلة للقادة المحاربين سيفشل في تلبيتها حتى أسطول من 500 سفينة. هذه الهفوة بين الإمداد والطلب للقوات البحرية الأميركية ترهق أفراد الخدمة: فكل عام يتم تمديد انتشار 20 سفينة في المتوسط، وتقوم حاملات الطائرات بانتظام بعمليات انتشار متتالية من دون توقف للصيانة.
سوف يتحول الصراع بين بكين وواشنطن بشكل متزايد إلى صراع على القوة البحرية.
تتسبب الفجوة بين الالتزامات البحرية وقدرات الأسطول في إنهاك البحرية الأميركية، كما يتضح من زيادة عدد الحوادث في البحر. ففي الآونة الأخيرة، اصطدمت غواصة "يو أس أس كونيتيكت"، وهي غواصة هجومية، بجسم غير معروف خلال مهمة في عمق بحر الصين الجنوبي. وفي العام الماضي، كان لا بد من التخلص من السفينة "يو أس أس بونهوم ريتشارد" بعد أن دمرها حريق (يزعم أن بحاراً تسبب به) وفشل طاقمها في إخمادها، وأصيب على أثرها عشرات من البحارة والمدنيين بجروح. إضافة إلى ذلك، اصطدمت مدمرتان تابعتان للبحرية الأميركية بسفن تجارية في السنوات الأربع الماضية، مما أسفر عن مقتل 17 بحاراً. في عام 2021، ألقى مكتب محاسبة الحكومة، وهو هيئة رقابة فيدرالية، باللوم في هذه الإخفاقات على نقص الطاقم والإرهاق ونقص التدريب. في عام 2018، وجد تقييم داخلي للبحرية أن 85 في المئة من صغار الضباط يعانون نقصا في المهارات التي يحتاجون إليها للتعامل مع السفن.
هذه التحديات التشغيلية تفاقمها تحديات إدارية. لقد أدى تقرير صدر أخيراً بتكليف من الجمهوريين في الكونغرس إلى انتقاد البعض الثقافة البحرية التي "تقدر الأعمال الإدارية على التدريب للقتال، وقادة السفن الخاضعين للإدارة الدقيقة، والنفور من المخاطرة". ويؤكد النقد الذي قدمه التقرير شكاوى العديد من ضباط البحرية الذين رأوا بأن القائد البحري اللامع في الحرب العالمية الثانية تشيستر نيميتز، الذي حوكم عسكرياً لسلوكه المتهور في وقت مبكر من حياته وواصل مع ذلك حياته المهنية ليصبح أحد أشهر الضباط في تاريخ القوة البحرية، لم يكن سينجح أبداً في الثقافة البيروقراطية للبحرية اليوم.
يميز المؤرخ أندرو غوردون، في روايته عن تدهور البحرية الملكية البريطانية، بين نوعين من العسكريين "صائدو الجرذان"، الذين يكسرون القواعد وينتصرون في الحروب، و"المنظمون،" الذين يعملون ضمن الإطار البيروقراطي ويرتقون في الجيوش وقت السلم لكنهم يخسرون الحروب لاحقاً. لذا، فمن خلال إعطاء الأولوية للمهام الإدارية على حساب المهارات الجوهرية اللازمة لكسب الحروب، تنشئ الولايات المتحدة قوة بحرية من المنظمين.
تغيير الأوضاع
تأتي المشكلة الثقافية المتمثلة في عدم الانتباه إلى الكفاءة القتالية في البحرية الأميركية من القمة. في هذا الصدد، تقوم إدارة بايدن بتوجيه طاقتها إلى أولويات أخرى، كما يتضح في التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الصادر في مارس (آذار) الماضي، الذي يعطي الأولوية "لوباء عالمي وتراجع اقتصادي ساحق وأزمة عدالة عرقية وحالة طوارئ مناخية عميقة". عندما أعلن عن ترشيح لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع، أشاد بايدن بقيام الجيش بتوزيع اللقاحات. من ناحية أخرى، تؤكد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الدفاع التزام الوكالة بتوسيع التنوع وإنهاء التحرش الجنسي ومعالجة الأضرار المناخية. هذه كلها قضايا مهمة، لكنها ليست الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى امتلاك الجيش. كما لا يوجد تمويل كافٍ في ميزانية البنتاغون لإدراجها دون الحاجة إلى سحب الأموال المخصصة للأفراد والمعدات والعمليات. إن تبني البنتاغون ما يسميه "الردع المتكامل" يؤكد الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية للدفاع، ويبدو إلى حد كبير مبرراً لعدم استخدام القوة العسكرية لردع الخصوم.
تتعهد استراتيجية بايدن الأمنية بأن "تظل القوات المسلحة الأميركية أفضل قوة مدربة ومجهزة في العالم". لكن التمويل الحالي لتلك القوات يدعو إلى التشكيك في هذا الالتزام. ففي ميزانية بايدن المقترحة لعام 2022، تعتبر وزارة الدفاع الهيئة الفيدرالية الوحيدة التي لم تعرف زيادة في التمويل، في حين من المقرر زيادة ميزانيات الهيئات المحلية الأخرى بنسبة 16 في المئة في المتوسط. في الوقت نفسه، رفضت إدارة بايدن تمويل برامج مثل مبادرة الردع في المحيط الهادي، التي اقترحها قائد عسكري إقليمي بارز وحددت الاستثمار العسكري المطلوب في المحيطين الهندي والهادي، وهو أمر يعتبره معظم الخبراء العسكريين ذا أهمية بالغة لردع الصين. (تم تمرير نسخة من المبادرة في نهاية المطاف من قبل الكونغرس). كان الإنفاق الإجمالي الذي خصصته إدارة بايدن للدفاع في ميزانيتها المقترحة غير كافٍ، ما دفع الكونغرس في النهاية إلى إضافة 24 مليار دولار إلى طلب الإدارة.
حلت الصين محل الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم في عام 2020.
لكن حتى مع هذه الإضافة، لا تقترب الميزانية الحالية من مستوى الإنفاق المطلوب لتنفيذ الالتزامات الأميركية. لقد سمحت الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقدين بوجود فجوة متنامية بين وسائلها العسكرية واستراتيجيتها المعلنة. وعلى الرغم من أن بايدن ليس مسؤولاً بالكامل عن المشكلة، فإن تسييرها يقع الآن على عاتق إدارته، وستتطلب من واشنطن تقييد أهدافها أو زيادة إنفاقها أو إيجاد طرق ثورية لتحسين الأداء العسكري.
ستتطلب الاستراتيجية الحالية للولايات المتحدة ميزانية دفاعية تبلغ نحو تريليون دولار سنوياً (وهو ما يعادل نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة) وستتطلب أيضاً مضاعفة 59 مليار دولار المخصصة لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وعلى الرغم من الزيادات الهائلة في الإنفاق المحلي التي قامت بها إدارة بايدن، من غير المرجح أن تقترب ميزانية الأمن القومي من هذه المستويات. يمكن لمساهمات الحلفاء سد بعض الثغرات في التمويل الحالي، ولكن لا يمكن تلبية جميعها.
تغير هائل
لقد تعثرت الهيمنة البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر جزئياً لأن هيمنة المملكة المتحدة العالمية كانت تتوقف على سيطرتها على البحار، وظهور خطوط السكك الحديدية كشكل من أشكال السفر البري الموثوق به حطم قدرة المملكة المتحدة على اعتراض التجارة والاتصالات. اليوم، تواجه الولايات المتحدة بالمثل خطر أن تؤدي الاختراقات التكنولوجية والتشغيلية إلى تقويض هيمنتها العسكرية - أو حتى جعلها متجاوزة.
على الرغم من تركيزهم على أهمية القوة البحرية، لا يولي جونز ولا إيستربروك الكثير من الاهتمام للحرب البحرية الفعلية وكيف تتغير. ينبغي أن يكون الابتكار نقطة قوة الجيش الأميركي، وينبغي أن يعكس الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة هذه الأولوية. في هذا الصدد، أجرى الجيش الأميركي مجموعة من التجارب في العمليات التي أنتجت تعديلات مهمة، مثل عودة سلاح مشاة البحرية إلى العمليات البرمائية واستثماره في وحدات أصغر وأكثر قدرة على الحركة. هذه الأنواع من التطورات ضرورية لمنح الجيش الأميركي الميزة التي يحتاجها للدفاع عن المصالح الأميركية، لكنها ليست كافية، ولا تحدث بالسرعة المطلوبة.
تضاؤل اهتمام واشنطن بالقوة البحرية يرسل رسالة خاطئة إلى حلفائها وشركائها.
ترى إدارة بايدن، كما فعلت إدارة ترامب، أن الصين هي التهديد العسكري الأساسي للولايات المتحدة - وتعتبر منطقة المحيطين الهندي والهادي المسرح البحري الذي من المرجح أن ينشب فيه أي صراع. وما لم تخصص إدارة بايدن المزيد من التمويل بشكل كبير للجيش الأميركي بأكمله، فإن الإنفاق الدفاعي سوف يحتاج إلى التوجيه وفقاً لذلك. ستحتاج ميزانية الدفاع إلى إعطاء الأولوية للبحرية الأميركية على القوات البرية والقوات الجوية الأميركية. يعد ضمان قوة البحرية أمراً بالغ الأهمية، فمن دون قوة بحرية قوية وبموارد مهمة، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن حلفائها في اليابان والفيليبين أو تأمين المسرح على نطاق أوسع في حالة نشوب صراع. في هذا الصدد، فإن جونز وإيستربروك محقان تماماً في القول بأن السيطرة على البحر ستكون العامل المحدد للقرن المقبل.
تعتبر الولايات المتحدة قوة مهيمنة شاذة لأنها مترددة في الانخراط في النظام الدولي الذي صنعته. على سبيل المثال، قادت واشنطن المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، وطورت "دستوراً للمحيطات" من أجل وضع معايير للنشاط البحري الدولي - لكن الولايات المتحدة نفسها لم تصدق أبداً على الاتفاقية. لقد أدت مخاوف متنوعة، مثل قلق الكونغرس بشأن المعاهدات الدولية والمصالح التجارية الخاصة بالتعدين في قاع البحار العميقة، إلى يأس الرؤساء من التصديق عليها، على الرغم من دعوة البنتاغون ووزارة الخارجية إلى القيام بذلك. وعلى الرغم من ترددها الرسمي للانضمام إلى المعاهدة، فإن الولايات المتحدة، لا تلتزم فقط بشروطها، بل تفرضها على دول أخرى. هذه "الاستثنائية" -كما تصفها بعض الدول- في سلوك الولايات المتحدة، التي تتجلى في رفضها الالتزام بالاتفاقية بينما تجني فوائدها، تغذي الانتقادات بأن الولايات المتحدة قد زعزعت استقرار النظام الدولي وأصبحت حليفاً غير موثوق به. إن تضاؤل اهتمام واشنطن بالقوة البحرية يرسل رسالة خاطئة إلى حلفائها وشركائها. فإذا كانت الولايات المتحدة تريد الاستمرار في وضع وفرض قواعد النظام الدولي، فعليها الأخذ بنصيحة قديمة: لا تدر ظهرك أبداً للمحيط.
كوري شاكي هي زميلة أولى ومديرة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد أميركان إنتربرايز ومؤلفة كتاب "الممر الآمن: الانتقال من الهيمنة البريطانية إلى الهيمنة الأميركية". شغلت منصب نائب مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية في 2007 - 2008.
مترجم من فورين أفيرز، مارس (آذار)/ أبريل (نيسان)2022