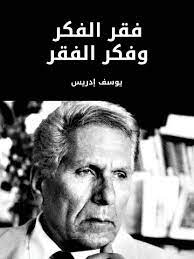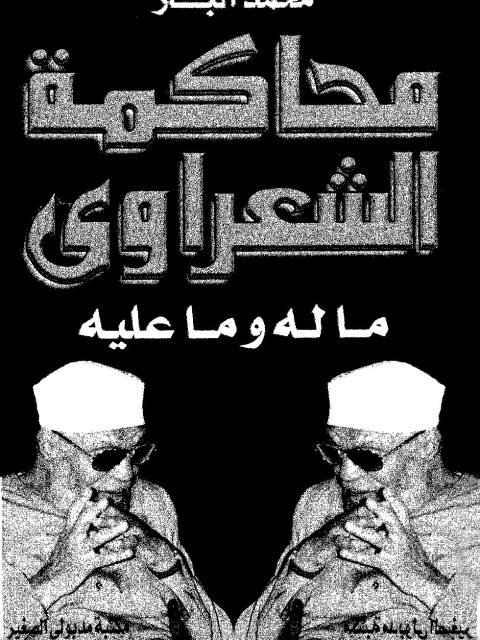لم تهدأ الضجة في مصر منذ إعلان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي (مسرح جورج أبيض) عن تقديم سيرة الشعراوي في عرض مسرحي، من بطولة كمال أبو رية، ضمن مبادرة رمضانية لتقديم سير شخصيات عامة. ولم يتضح بعد ضحايا المعركة، خصوصاً أن الكاتبة والنائب في البرلمان المصري فريدة الشوباشي تقدمت بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني حول الموضوع.
المهاجمون
قادت الشوباشي الهجوم لأن الشعراوي سجد لله شكراً على النكسة، وموقفه هذا لا يختلف عن مرشد "الإخوان" المعادين للأسس الوطنية. وأكدت أن "دور وزارة الثقافة المصرية" التوعية وتقديم شخصيات مرتبطة بالتنوير. واعتبر الناقد طارق الشناوي الفكرة "غير مناسبة". وعلى رغم أنه أشاد بما تمتع به الشيخ من كاريزما، فإن "أفكاره كانت تحرم الفن". وطالب بالتركيز على سماحة وعصرية الإسلام، متهماً الشعراوي بأنه كانت له "آراء رجعية".
الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، أكثر الأصوات التنويرية راديكالية الآن، اتهم الشعراوي صراحة بأنه "متطرف وداعشي وضد المرأة والأقباط".
المدافعون
كانت أسرة الشيخ الراحل أول الغاضبين، وكلفت المحامي سمير صبري المتخصص في قضايا الرقابة والمشاهير، تقديم بلاغات ضد طارق الشناوي والناقدة ماجدة خير الله، وغير مستبعد إبراهيم عيسى. وكانت مؤسسة الأزهر في طليعة من تصدوا للدفاع عنه، فأطلقت بياناً جاء فيه، "فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهب حياته لتفسير كتاب الله، وأوقف عمره لتلك المهمة. أوصل معاني القرآن لسامعيه بكل سلاسة وعذوبة، وجذب إليه الناس من مختلف المستويات". وأكد مشرف "أروقة الأزهر" د.عبدالمنعم فؤاد أنه "سيظل علامة مضيئة في سماء الفلسفة والدين".
لن تتوقف أصوات المدافعين، وهم الأكثرية، فيسهل الرد على "عدم وطنية الشعراوي" في موقفه من النكسة، بأن الدولة المصرية نفسها صعدته لأعلى المناصب وزيراً للأوقاف، وفتحت له تلفزيونها وإذاعتها وكل صحفها ودور نشرها، ومنحته أعلى الأوسمة. وبالنسبة إلى آرائه التي لا تعجب "التنويرين" فبعضها قد تراجع عنه، وبعضها الآخر يعبر عن موقف المؤسسة الأزهرية الرسمية، بل يمكن النظر إلى الشعراوي، كما نفهم من تصريحات المدافعين، أنه كان تنويرياً قدم للناس خطاباً ميسراً وسمحاً ومختلفاً عن التصورات المتشددة، وهذا سر حب الناس له، فليس ثمة تعارض بين تقديم سيرته على المسرح، ودور وزارة الثقافة في "تنوير المجتمع"، وإلا يصبح حجبه مساهمة غير مباشرة لتصعيد خطاب العنف والتشدد.
الوزيرة في المعركة
وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أرادت سحب فتيل الأزمة، وأوضحت في تصريحاتها أن الأمر كان مجرد "اقتراح" من مدير المسرح القومي لتقديم سير بعض الشخصيات الدينية في رمضان، وليس عروضاً مسرحية كاملة. ولم يقدم الاقتراح عبر اللجنة المسؤولة، مع إشارتها الواضحة إلى الاهتمام بشخصيات "تنويرية" لها دور في مكافحة التطرف. كلام الوزيرة يشير ضمناً إلى أنها غير مرحبة باجتهاد مدير المسرح، وأنه لن يكون هناك عرض. فهل سيكون إيهاب فهمي رأس الذئب الطائر في الأزمة؟ إن تصريحات أو تلميحات الكيلاني نفسها لا تبدو مريحة للمؤسسة الأزهرية، لذلك رد ما يسمى "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية"، على ما قالته إن "عليه تحفظات كثيرة"، بالتأكيد أن "إمام الدعاة مثال للعالم الوسطي المستنير".
ولعل تباين رؤية مدير المسرح مع الوزيرة يكشف عن ملاحظات عدة، هيمنة أصوات محافظة على مفاصل وزارة الثقافة، وعدم الانسجام بين الوزيرة وبعض مساعديها، وعدم وعي مدير المسرح القومي الذي تأسس قبل أكثر من مئة وخمسين عاماً بمهام المسرح وفلسفته. فالمفترض أنه يقدم للجمهور العروض الكلاسيكية العالمية ونصوص الدراما العربية الرصينة، أما ليالي الاحتفاء بشخصيات دينية فهي من مهام وزارة الأوقاف وقصور الثقافة ومراكز الشباب.
جذور الأزمة
ليست هذه المرة الأولى التي يطفو فيها اسم الشعراوي ورمزيته على السطح، فقبل ثلاث سنوات اتهمت المذيعة أسما شريف منير الشيخ الشعراوي بعدم الاعتدال، وأن له "فتاوى لا تعجبها". ولضراوة الهجوم عليها اعتذرت وأغلقت صفحتها. ولو عدنا إلى جذور الأزمة فهي كامنة، منذ أن أنشأ محمد علي باشا مصر الحديثة، في ازدواجية التعليم الديني والعلماني حتى الآن، وفي الأحزاب المدنية مقابل جماعات دينية متشددة مثل "الإخوان" و"الجهاد" و"التكفير والهجرة"، وفي ذلك التصدع الذي يتسع ويضيق بين مؤسسة الأزهر والحكومة. وعرفت مصر ثورات واحتجاجات منذ أيام عرابي وثورة 23 يوليو وانتفاضة الخبز، وصولاً إلى يناير 2011، وعبر مئتي سنة لم يجد المصريون إجابة حاسمة، هل نحن دولة وطنية مدنية أم جزء من خلافة إسلامية آتية؟
تتكشف الازدواجية حتى في مبادرة مدير المسرح القومي، وهو بمثابة وكيل وزارة الثقافة، بينما الوزيرة نفسها معارضة أو متحفظة.
أسطرة الشعراوي
استثمر السادات في ميوله الريفية الدينية وراهن على الحركات الدينية كحائط ضد خصومه، وجسر للتقارب مع أميركا آنذاك، في حربها ضد الروس في أفغانستان. وجاء صعود الشعراوي ضمن تلك الاستراتيجية. فهو لم يكن مجرد وزير عابر في حكومة، بل تحول من ضيف على برنامج الإعلامي أحمد فراج، لصاحب أشهر برنامج تلفزيوني، وتجاوز ملعبه الأساسي في خواطره القرآنية إلى نشر عشرات الكتب وآلاف الفتاوى والتصريحات في الفقه والتنظير. وجرت أسطرته، إن جاز التعبير، فما زالت إذاعة القرآن والتلفزيون يبثان دعاءً بصوته بعد كل صلاة، وهي مكانة لم يحظَ بها أحد من شيوخ الأزهر أنفسهم. وما زالت صوره في محال الفول والعصير والميكروباصات والتكاتك. ألا يستحق الرجل مكانته؟ ليس هذا مربط الفرس، وإنما السؤال: إلى أي مدى أسهمت الدولة المصرية نفسها في تعميم ظاهرته وتكريسها؟
كان الكاتب الراحل يوسف إدريس أكثر الكتاب المصريين شجاعة عندما كتب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن الشعراوي، في حياة الرجل وإبان نفوذه، ووصفه بأنه "يتمتع بكل خصال "راسبوتين" من قدرة على إقناع الجماهير البسيطة وقدرة على التمثيل والحديث بالذراعين وتعبيرات الوجه، والقدرة على جيب كبير مفتوح دائماً للأموال، باختصار، قدرات أي ممثل نصف موهوب".
نشر إدريس كلامه الناري في كتابه "فقر الفكر وفكر الفقر"، وكان تنبوئياً في تأكيد كاريزما الرجل وقوة تأثيره، وارتباطه بعملية توظيف الأموال التي ظهرت لاحقاً، وما خلفته من مآسٍ وحالات انتحار. وتركز مقالته على وجود خطابين للإسلام، أحدهما خطاب "تحرر"، والآخر مرتبط بالسلطة والعبودية، بحسب زعمه. ومن هنا شبه ظاهرة الشعراوي بالظاهرة الراسبوتينية التي قوضت روسيا القيصرية، لكن وزير الثقافة آنذاك أحمد هيكل هاجم إدريس بشدة، ووصف كلامه بأنه "ساقط"، وأن الشعراوي "مفخرة لمصر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حدثت مراجعات لظاهرة الرجل منها كتاب "الشعراوي ما له وما عليه" للكاتب الصحافي محمد الباز، وصدر قبل رحيله بفترة وجيزة.
أكد الباز أنه يحب الشيخ، لكنه "لا يقدسه"، ومزج في كتابه بين الحس الروائي والصحافي. وتطرق إلى تشجيع الشعراوي لدفع أموال لمساعدة الفنانات على التوبة واعتزال الفن، وكذلك فتاواه المثيرة للجدل، ودوره في توظيف الأموال، وعلاقته الخاصة جداً مع السادات الذي استوزره، ووقف معه ضد انتفاضة الخبز. وقال مقولته الشهيرة بأن السادات لا يسأل عما يفعل. وعندما اعترض عليه أحد الشيوخ داخل البرلمان، رد الشعرواي عليه "أنا أعرف بالله منك".
والعجيب والمأسوي أن السادات نفسه راح ضحية الظاهرة "الراسبوتينية" التي احتمى بها ضد خصومه، فيما ظل اسم الشعراوي مثل لعبة شد الحبل بين السلطة والسلطة، والشعب والشعب. وعلى الأرجح لن يكون هناك فائز.