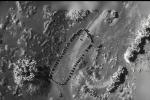من أسوأ المصائر في عالم الأدب تلك التي تكون مآل شخصيات تعيش وتزدهر إنما في ظل شخصية رئيسة تكون هي أساس العمل الأدبي ومبرّر وجوده. هنا مهما كان جمال الشخصية غير الأساسية كبيراً ونقاؤها واضحاً، كثيراً ما يحدث لها أن تُنسى لتتلاشى مع الزمن في وهدة التجاهل، فإن كانت عودة إليها بين الحين والآخر فإنما للتأكيد على طغيان وأهمية الشخصية الرئيسة صاحبة الظل الكثيف. يحدث هذا في الإبداع لكنه يحدث عادة في ما هو حول الإبداع. ولعل خير معبّرٍ عن الأمر ذلك العنوان الذي اختارته باحثة وأديبة فرنسية يوماً لكتاب أرادت من خلاله أن تكتب ليس سيرة سيغموند فرويد بل سيرة زوجته. كان العنوان "تبّاً! لقد نسينا مدام فرويد مرة أخرى".
هل تتذكرون أوفيليا؟
والحقيقة أن هذا العنوان الظريف الذي يكفي في حد ذاته لشرح "مأساة" من يعيشون في "ظل الكبار" يخطر في البال في كل مرة يدور فيها الأمر من حول شخصية ما يُكتشف أنها ظلمت. وفي سياق حديثنا هنا، ليست هذه الشخصية سوى أوفيليا. فهل يتذكر القاريء من هي أوفيليا؟ السؤال بسيط بالتأكيد وجوابه يمكن أن يكون سريعاً: هي خطيبة هاملت في مسرحية شاعر الإنجليز الأكبر شكسبير. ولكن ماذا غير ذلك؟ ربما يتذكر كثرٌ أنها انتحرت في سياق المسرحية. ثم؟ لا شيء تقريباً لأن انتحارها نفسه إنما يخدم للإضاءة أكثر على شخصية هاملت. فمن هي وما تفكيرها ومن أين جاءت؟ ثم ما هو النموذج الذي رسم شكسبير صورتها على أساسه؟ وماذا بعد انتحارها؟ وماذا أصلاً قبل وصول هاملت إليها؟ لا شيء قطعاً ولا شيء قاطعاً.
ومع هذا لم يتوقف الكتّاب والباحثون الأكثر ظرفاً والأكثر إنصافاً بالتالي عن وضع هاملت نفسه على الرف في بعض الأحيان، للاهتمام بتلك الفاتنة النقية التي كان من سوء طالعها أن أحبت الأمير الدنماركي في واحدة من أكثر لحظات حياته تعاسة.
مصادر شكسبيرية
وهكذا على مرّ الزمن، ورغم شكسبير ورغم الظلم التاريخي راحت تتكون صورة لأوفيليا ترسم مسار "ولادتها" التاريخي، لتتضافر مع اهتمامات من نوع آخر سنصل إليها بعد سطور. أما ما سنبدأ به هنا فهو التأكيد على أن شكسبير وكعادته التي لم يحد عنها أبداً، لم يأت بأوفيليا من مخيلته. فهو إذا كان في مسرحياته التاريخية، سواء روت لنا فصولاً شديدة القسوة من التاريخ الحقيقي لبلده الإنجليزي، أو فصولاً من التاريخ الروماني الذي كثيراً ما اهتم به ومسرَحَه بصورة مدهشة، إذا كان قد استعار معظم شخصياته من التاريخ أو من توليفة تاريخية حقيقية، فإنه في دراماته غير التاريخية حقاً، مثل "أوتيلو" و"الملك لير" و"ماكبث" ثم خصوصاً "هاملت"، رسم شخصياته المبتَدعة انطلاقاً أيضاً من شخصيات حقيقية.
ومن هنا، في ما يخص موضوعنا هذا، يمكننا أن نتنبه إلى أن اسم أوفيليا موجود كما حال اسم دزدمونة "أوتيلو"، في كتاب المؤلف ساناتزارو عن رعاة "آركاديا". ومن الواضح أن عذوبة الاسم وموسيقاه قد فتنتا شكسبير فجاء لديه، كما يقال، اسما على مسمّى. فالاسم يوحي بكون صاحبته بتولاً نقية تجمع بين الصبية والملاك في كمال من لن تكون موعودة بأن تعيش طويلاً ولن تعرف السعادة الحقيقية.
ونعرف أن أوفيليا في المسرحية عاجزة عن فهم "هاملت وبحثه المجنون عن الحقيقة" طالما أنها غير مضطرة إلى البحث عن أية حقيقة، كل ما في الأمر أنها تحتاج إلى هاملت كي تتحول على يدي حبه من ملاك إلى امرأة... لكن المرأة صارت لدى هاملت صنواً للخيانة. ألم تغدر أمه بأبيه؟ من هنا ستدفع أوفيليا مواربة ثمن خيانات كل النساء، أو بالأحرى ستفلت من الخيانة بالموت باكراً. غرقاً في الماء. فمن أين أتى هذا الحل؟
"شكسبير" أخرى طفلة في الثانية من عمرها
ثمة دراسات حديثة أتت لتخبرنا: من حكاية حقيقية حدثت فيما كان شكسبير لا يزال طفلاً، لكنه سمع بها مع ذلك. والحكاية تكاد تكون ملخص أشغال أجراها باحثون في جامعة "أوكسفورد" متبحرين في نحو تسعة آلاف تقرير صيغت في القرن السادس عشر استجابة لقرار اتخذه التاج البريطاني فحواه تقديم تقرير مفصّل حول كل ميتة غير طبيعية تحدث في أية رقعة من إنجلترا. ومن هنا كان الاكتشاف الذي راحوا يشتغلون عليه وهو المتعلق بحادثة وقعت لطفلة في الثانية والنصف من عمرها تذكر التقارير أن اسمها جين شكسبير – وإن كانت تختلف في حروف اسمها اختلافاً ضئيلاً عن اسم كاتبنا الكبير - فهذه الطفلة سقطت كما يقول التقرير في الماء في حوض عميق قرب طاحونة، فيما كانت تقطف أنواعاً زاهية من الزهور في منطقة لا تبعد أكثر من عشرين كيلومتراً عن بلدة سترتفورد - آبون - إيفون مسقط رأس شكسبير الذي كان حينها في الخامسة من عمره، لكن تلك المأساة التي هزت المنطقة بأسرها وصلت إلى مسامعه بالتأكيد ولو على شكل أمثولة لمنعه من الاقتراب من مياه عميقة والمجازفة بموت مثل ذلك الموت!
مهما يكن من أمر، لا شك أن اكتشافاً كهذا، لا يبتعد في منطقه كثيراً عن أمور كثيرة تتعلق بالمصادر التي استقى منها شكسبير أصول الشخصيات التي ابتكرها، قد لا يبدو لنا عميق الحجة هنا، لكنه يتلاقى مع صورة الحدث كما صُوّرت لنا، انطلاقاً من نظرة معينة إلى المسرحية أبدع في إلقائها عددٌ من الفنانين ومن بينهم على الأقل اثنان من الذين ارتبطوا بالحركة المسماة "ما قبل الرافائيلية" التي ازدهرت خصوصاً في أواسط القرن التاسع عشر، وكان من أشهر مبدعيها دانتي غابريال روزيتي وويليام هولمن وجون إفريت ميلليز وغيرهم من الذين أرادوا للرسم أن يعود تصويرياً كما كانت حاله في مرحلة ما قبل النهضوي رافائيل. فهؤلاء الرسامون عرفوا كيف يجمعون بين الرمزية والتصويرية مع شيء بيّن من النزعة الرومانطيقية كما اهتموا بتصوير شخصيات منتزعة من الآداب القديمة. ولقد انصبّ اهتمام ميلليز – أحد ذينك الاثنين أما الثاني فهو آرثر هيوز- بشكل خاص وفي واحدة من أشهر وأجمل لوحاته على أوفيليا التي رسمها في 1851-1852 عبر تلك اللوحة البديعة المعلقة الآن في متحف تيت اللندني (ارتفاعها أكثر قليلاً من 76 سنتيمتراً وعرضها أقل قليلاً من 112 سنتيمتراً). وتصف هذه اللوحة بتقنية وتلوين عاليين مأساة أوفيليا، لكن روعة جمالها كذلك مفعمة بقدرٍ كبير من رمزية طاغية عليها.
اندماج تام في الطبيعة
فالحال أن الرسام عرف كيف يترجم إلى لغة الزهور وأنواعها كل تلك الأبيات التي بها يُخبر، في المسرحية، لايوس الملكة غيرترود عن الفاجعة التي طاولت أوفيليا مركّزاً حديثه على أنواع الزهور التي كانت تقطفها والتي بدت معها حسب تعبير شعري لاحق للشاعر الفرنسي ريمبو "تلك الأوفيليا البيضاء التي تعوم وكأنها زنبقة كبيرة وسط أوراق النينوفار المجعّدة".
بيد أن الرسام تجاوز هذا الوصف الشاعري ليجعل أوفيلياه محاطة بعددٍ أكبر كثيراً من زهور من الواضح أن كل زهرة منها ترمز إلى صفة من الصفات المشتركة بين الطبيعة والنقاء الأنثوي، ناهيك بكون الرسام قد اجتهد كي يجعل الملاك الميتة تبدو هنا جزءاً مندمجاً في الطبيعة نفسها، انطلاقاً طبعاً من واحد من المباديء الرئيسة للمدرسة الـ"ما قبل رافائيلية" وهو المنادي بعودة الرسم إلى الطبيعة ليس بوصفها مكاناً تجري فيه أحداث معينة بل بوصفها جزءاً أساسياً من الحدث نفسه. وعلى سبيل التندر يُروى هنا أن الرسام فيما كان ينجز لوحته راسماً إياها في الطبيعة مباشرة، كاد بدوره يقع ويغرق في مياه نهر استخدمه بديلاً عن الماء الذي تغرق فيه أوفيليا.