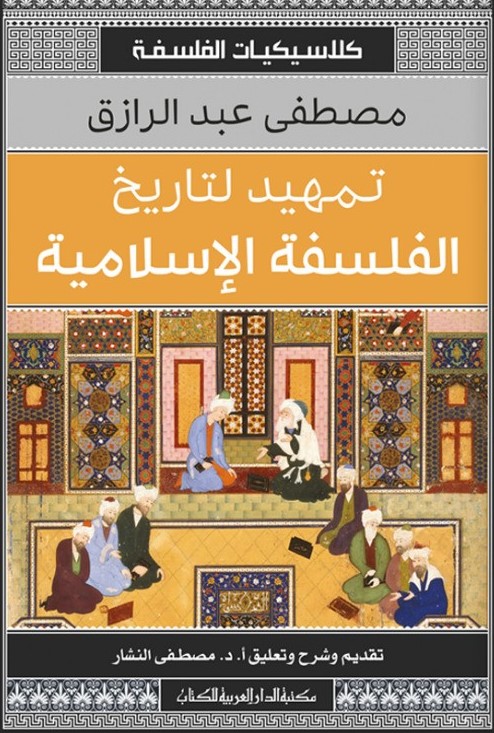يعد كتاب "تاريخ الفلسفة في الإسلام" للمؤرخ الألماني ت. ج. دي بور الأول في موضوعه، علماً أنه نشر بالألمانية عام 1901 "متضمناً وجهات نظر تستنفر في الباحثين الرغبة في الجدل والحوار والنقد"، بحسب ملاحظة كريم الصياد، التي تضمنها تقديمه لطبعة جديدة من الترجمة العربية للكتاب نفسه (سلسلة كلاسيكيات الفلسفة - الدار العربي للكتاب)، والتي حققها وراجعها على الأصل الألماني، وصدر الكتاب بترجمة أبي ريدة في 1938، ثم صدرت منه طبعة ثانية في 1948، وثالثة في 1954، وهذه الترجمة التي أنجزها محمد عبدالهادي أبو ريدة سبق أن حققها مصطفى لبيب عبدالغني مع آخرين وصدرت بتقديمه عن المركز القومي للترجمة في القاهرة 2018.
وكما يقول الصياد فإن دي بور استشعر نقصاً كبيراً في الدراسات الغربية حول الفكر الإسلامي، إذ إن معظمها جزئي لا يسمح لمفكري الغرب برسم خريطة عادلة لأنساق هذا الفكر وعلاقته بنظيره اليوناني واللاهوت المسيحي وأثره في الفكر الغربي خلال العصور الوسطى، فقرر وضع هذا الكتاب الموسوعي ليكون توطئة للباحثين الغربيين المهتمين بالفلسفة الإسلامية. ويضيف الصياد أنه "لعل دي بور لم يدر بخلده وهو يخط كتابه هذا أنه سيأتي مترجم ينقل جهده إلى اللغة العربية، شارحاً ومصوباً بصياغة عربية لا يستشعر معها القارئ أنه بصدد مصنف أجنبي". واستطاع أبو ريدة أن يحول هذا الكتاب من عمل يستهدف الغرب إلى مرجع فلسفي للمتخصصين العرب في الفلسفة الإسلامية، وإذا نظر القارئ إلى المساحة التاريخية والجغرافية الشاسعة التي يتعرض لها هذا المصنف لفهم مدى الجهد الهائل الذي بذله المترجم في إخراج الكتاب بعد ترجمته على نحو فعال. وهذا يعني أنه صار ممكناً الاعتماد عليه كمرجع. فلا يمكن الاعتماد على دي بور أو غيره وهو يصف ويحلل أفكار الغير من دون إحالات مرجعية دقيقة، هذا كله أدى إلى أن تكون إضافات أبي ريدة صالحة من حيث المبدأ للترجمة إلى الألمانية وأضافتها إلى الأصل، كما يذهب الصياد.
السياق التاريخي
إضافة إلى ذلك دخل أبو ريدة مع دي بور في هوامش هذا الكتاب في جدل حول أفكار الفلاسفة والمتكلمين والصوفية وعلماء الحضارة الإسلامية، وذلك للسبب نفسه الذي جعل لدى بور أهميته في وقت ما، وهذا ما يفتح الباب لطرح مسألة السياق التاريخي الذي وضع فيه دي بور هذا المصنف. فقبل دي بور لم يعرف الغرب ولا العالم الإسلامي موسوعة شاملة على هذا القدر من الاتساع والدقة لتاريخ الفلسفة الإسلامية، وهذا ما يوضحه دي بور في مقدمته. يقول دي بور في هذا الصدد "هذه أول محاولة لبيان تاريخ الفلسفة الإسلامية في جملتها، بعد أن وضع الأستاذ مونك Munk في ذلك مختصره الجيد، بالفرنسية، فيمكن أن يعد كتابي هذا بدءاً جديداً، لا إتماماً لما سبقه من مؤلفات". ويضيف المترجم في هذا الصدد كتاب "مفكرو الإسلام" للبارون كرادفو وقد ظهر بالفرنسية عام 1920.
غير أن ما يضاف إلى هذا التوضيح – يقول الصياد - هو أن الكتاب مقدم إلى المستشرقين ودارسي الفلسفة الإسلامية في أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20. هذه المرحلة التاريخية والنظرية المفصلية يراها الصياد عصر نضج الاستشراق، بمعناه التقليدي، وقد أدى هذا بدي بور إلى تطبيق معايير معينة في تقييم منجز الفلاسفة، والمتكلمين والصوفية، دون نظرة عنصرية غالباً، وإن شابت أحكامه بعض المبالغات، ومنها مثلاً ما يتعلق برأيه في شعر المتنبي، والذي يفنده الصياد في سياق تحقيقه الترجمة ومراجعتها على الأصل الألماني، لكنه يوافقه في ذهابه إلى أن شعر أبي العلاء المعري "ليس فلسفة"، وأن صياغته "ثقيلة متكلفة".
من الفارابي إلى ابن طفيل
ومن أهم المسائل ذات البعد الاجتماعي التي لم يركز عليها دي بور، كما لاحظ الصياد، هي طبيعة إدراك الفلاسفة والمفكرين والصوفية لأدوارهم في المجتمع. ومن اللافت للنظر – يقول الصياد - أن أكبر فلاسفة الإسلام لم يحاولوا الترويج لأفكارهم، أو صنع مدرسة على غرار أكاديمية أفلاطون أو ليسيوم أرسطو، وإنما أكدوا ضرورة قصر المعارف البرهانية على الفلاسفة من جهة، والمعارف الذوقية على الصوفية من جهة أخرى، أي على طبقة معينة من المتلقين، بحيث لا يفهمها "إلا من كان أهلاً لها". ويضيف المحقق "سنجد هذه الظاهرة واضحة، وقد أشار لها دي بور فعلاً عند الفارابي وإخوان الصفا وابن سينا والغزالي وابن باجه وابن طفيل، وهي ظاهرة قابلة للفهم في سياق مجتمع ديني ثيوقراطي أو شبه ثيوقراطي تمثل فيه الرابطة الدينية النسيج الضام لوحدات المجتمع وتعلو فيه على روابط الدم أحياناً، وليس فيه تصور واضح عن دولة قومية أو مواطنة.
وهي مرحلة تبدو بدائية اليوم بالنسبة إلينا، لكنها كانت مرحلة طبيعية في سياق التقدم التدريجي للبشرية وتنامي دور المؤسسات الوسيطة والسلطات القضائية والتشريعية المستقلة عبر القرون، كما يوضح الصياد. ومع ذلك، "يمكن للفيلسوف دائماً أن يؤسس لاستراتيجية تنويرية أو تعليمية يمكن من خلالها الارتقاء بالغالبية الغاشمة، التي ضن عليها الفلاسفة والصوفية معاً بأعز مصنفاتهم"، يقول الصياد ثم يضيف "ولهذا فإن مسار الثقافة الإسلامية العام، بما فيه من فلاسفة وعلماء قد اتجه إلى التصوف بدءاً من عصر التدهور في القرن السابع الهجري تقريباً في المشرق والمغرب. وهنا لا نقصد حصراً التصوف كنظريات، بل نعني المسار الاجتماعي للتصوف: الخلاص الفردي، والحركة في دائرة ضيقة من الخاصة، والنأي عن شؤون المجتمع و"العامة". ولأن الفلاسفة لم يتمتعوا باستراتيجية تثقيفية أو تنويرية أو مشروع على المدى البعيد كمشروعات الفكر العربي المعاصر مثلاً وأنهم اكتفوا بالتنظير وتشييد المذهب، فلم يكن مصيرهم يختلف كثيراً عن مصائر الصوفية".
وحرص أبو ريدة على مراجعة ترجمته وتنقيحها في طبعتها الثانية، وقد استفاد في ذلك من الشيخ مصطفى عبدالرازق الذي مكنه من الانتفاع بمكتبته في هذا الصدد لشهور طويلة، كما وجه الشكر إلى فريتز ماير، الأستاذ في جامعة بازل، "لمعونته لي برأيه في بعض النقاط التي كانت لا تزال ملتبسة سواء بسبب اللفظ، أو بسبب المعنى". ومن جانبه أكد دي بور في تقديمه أنه قصر بحثه على فلاسفة الإسلام، ما استطاع، وأنه لم يذكر ابن جبرول وابن ميمون إلا عرضاً، وأغفل ذكر من عداهم من مفكري اليهود إغفالاً تاماً، "وإن كانوا من الناحية الفلسفية ينتمون إلى دائرة الثقافة الإسلامية"، وهنا علق الصياد بأنه كان على دي بور أن يوضح كيفية هذا الانتماء إلى الثقافة الإسلامية باستفاضة، وذلك لأهمية هذه القضية بشكل عام، وكيف استوعبت الحضارة الإسلامية أدياناً مختلفة"، ص64. ويتألف كتاب دي بور الموسوعي هذا من سبعة أبواب، آخرها يحمل عنوان "الخاتمة"، ويضم قسمين، الأول بعنوان "ابن خلدون"، والثاني بعنوان "العرب والفلسفة النصرانية في العصور الوسطى.
وفي القسم الثاني يذهب المؤلف إلى أنه في الحروب التي قامت في إسبانيا بين النصارى والمسلمين، كثيراً ما خلب لب النصارى جمال غانيات البربر، وكم من فارس نصراني قضى "أيام العبادة التسعة" مع حسناء بربرية، ولكن الفاتحين إلى جانب تأثرهم بالخيرات المادية واللذات الحسية تأثروا بسحر الثقافة العقلية، وبدا علم العرب عروساً خلابة في نظر كثر من المتعطشين للمعرفة"، ص423. ويضيف في السياق ذاته الذي قصد الصياد أن يعتبره غير كاف لتفسير تأثر يهود بالثقافة الإسلامية، "وظهر اليهود وسطاء في هذا الأمر (أمر شغف نصارى الأندلس بعلوم العرب)، وكانوا قد اشتركوا من قبل في كل مراحل الحضارة العقلية عند المسلمين، وكان كثير منهم يكتبون باللغة العربية، وترجم آخرون كتب العرب إلى اللغة العبرية، ويرجع الفضل في بقاء كثير من كتب الفلاسفة المسلمين إلى هذه الترجمات". ويؤكد دي بور أن اليهود أخذوا بحظ من معالجة العلوم في الدول الإسلامية أيام ازدهارها، وقد تمتعوا بالتسامح من جانب المسلمين، بل نالوا الحظوة عندهم".
وأخيراً، تنبغي الإشارة إلى أن التحقيق الجديد لترجمة كتاب دي بور تنطلق من أن الترجمة عموماً ليست عملاً نهائياً، فلا يمكن – كما يقول الصياد – ترجمة كتاب، مهما كان بسيط التركيب والعبارة ترجمة نهائية لا مراجعة لها، والسبب في ذلك هو أن كل ترجمة تخاطب ثقافة معينة بوعي أو من دون وعي. ولهذا قرر الصياد أن يعود إلى النص الأصلي، وأن يعيد ترجمة بعض الألفاظ أو التراكيب في الحواشي، "وهذا الأمر لا يغير من لغة أبي ريدة، ولا يضيف إليها جوهرياً، ولكنه يصحح الفهم بصدد بعض هذه المواضع، ويقترح الترجمة السارية اليوم".