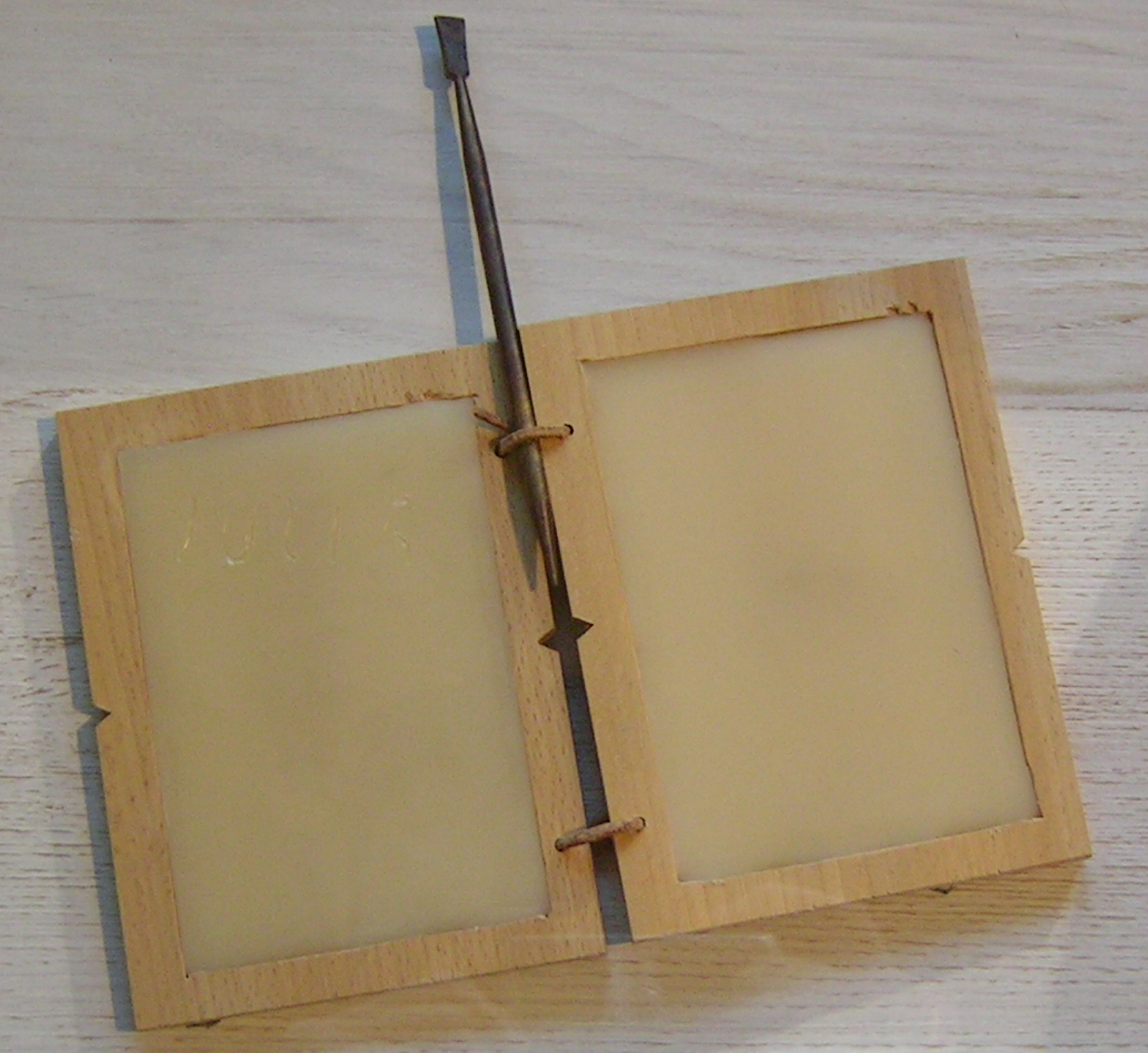يعتقد العقلانيون، ومنهم أرسطو (384-322 ق. م.) وديكارت (1596-1650)، أن العقل هبة سنية من الطبيعة، إذ إن الإنسان يولد حاملاً في ذاته مبادئَ المعرفة الأساسية الناشبة في عمق مداركه، ومنها مبدأ الهوية، ومبدأ الثالث المرفوع، ومبدأ العلية. ومن ثم، ينطوي العقل فطرياً على مجموعة من المضامين التأصيلية الثابتة التي لا تتأثر بأحوال الزمان والمكان. أما التجريبيون من أمثال لوك (1632-1704) وهيوم (1711-1776)، فيصرون على القول إن العقل، أو قل التعقل، يأتينا من الاختبار والتجربة، إذ إن وعي الإنسان لوحة بيضاء خاوية (tabula rasa) تمتلئ امتلاءً متدرجاً بفضل الاكتسابات الاختبارية التي يحرزها العقل الباحث.
لا شك في أن جميع المذاهب الفلسفية لا تؤيد مبدأ كونية العقل. خلافاً للمذهب العقلاني الميتافيزيائي الجذري الذي نادى به أفلاطون، معتبراً أن الوجود كله قابل الإدراك العقلي، وخلافاً للمذهب العقلاني الإبيستمولوجي الذي ناصره كانط مصراً على حدود المعرفة الإنسانية، تنبري مذاهب التشكيك والنسبانية والتعطيل تعلن أن الوجود كله عصيٌّ على الإدراك، وأن العقل عقول، والفكر أنظومات، والإدراك مدارك، والحقيقة آراء متباينة. في جميع الأحوال، تعرف الفلسفةُ العقلَ على أربعة وجوه: فإما أن يكون الآلة أو الأداة أو الوسيلة التي بها يعقل الإنسان العالم وأشياءه وكائناته وموجوداته، وإما أن يكون المرجعية التمييزية التي تفصل بين الخطأ والصواب، وإما أن يكون مستودع الأفكار والمعارف والمضامين، وإما أن يكون بمنزلة الحيوية الاستشكافية الإبداعية الذاتية الدفع والطاقة.
ارتباط كونية العقل بالفطرة الإنسانية
تعني كونية العقل أولاً أنه ملكة يتمتع بها كلُّ إنسان عاقل. وتعني ثانياً أن بنية العقل الأصلية الذاتية فريدة ومتشابهة في جميع تجلياتها تتجاوز الاختلافات الناشئة بين الذاتيات الفردية. بحسب هذا المعنى، يظهر العقل بنيةً ثابتةً منغرسةً في صميم الكيان الإنساني تضطلع بوظيفة أساسية: قدرة بلوغ الحقيقة في مدارك الإنسان وضمانة الاستقامة في الفكر الباحث. أما المعنى الثالث والأخير، فيدل على أن العقل الكوني ينطوي على بنية موضوعية مستقلة عن خصوصيات الفرد الذاتية تستطيع أن تدرك الواقع وما يقوم وراء تموجات الواقع واضطراباته وتبدلاته، أي جوهر الأشياء وحقيقة الكينونة والمعنى الكوني الناشب في العناصر الجزئية.
لذلك يمكننا القول إن كونية العقل تعني أن طبيعة الإنسان الإدراكية تنطوي على بنية معرفية ثابتة تؤهله لاستكشاف حقائق الأمور استكشافاً منطقياً واحداً. المثال الأبلغ على ذلك الرياضيات الكونية التي يستخدمها العلماء المنتمون إلى مختلف الحضارات الإنسانية استخداماً واحداً، فتتيح لهم أن يخرجوا بخلاصات واحدة في ضبط الحسابات والمعادلات والمعاينات التي قد تتجاوز حدود الأرض لتصيب سرعة الضوء وحركة الكواكب وبنية الكون الواسع عينه.
كان الفيلسوف واللاهوتي الإسباني بالتازار غارثيان (1601-1658) يتناول مسألة الإنسان الكوني في تصوره الكائنَ البشريَّ الواحد المنبثق من المشيئة الإلهية، في حين أن غيوم الأوكامي (1285-1347)، مؤسس المذهب الاسمي الذي ينزع بواسطة مقصه الحاد الكليات المجردة النافلة كالسعادة والعدالة والمساواة وغيرها من المفاهيم العامة غير المتعينة، فكان يعتقد في كتابه "خلاصة المنطق" (Somme de Logique, I, 14) أن الكوني عديم الوجود.
التمييز بين العقل واستخداماته
في سياق معاصر، انبرى فيلسوف العلوم النمساوي باول فايرأبند (1924-1994) يذيع في كتابه "وداعاً للعقل" (Farewell to Reason) أن فرضية كونية العقل الواحد تستند إلى قرائن الانتظام السياسي الاستبدادي الذي كان سائداً في العصور الغابرة. فالناس آنذاك كانوا يستمدون الحقائق من مصدر إلهي أو إمبراطوري أو ملكي واحد، وكانوا يعتقدون أن الجبلة الإنسانية تتحقق تحققاً واحداً في جميع الأزمنة وجميع القرائن وجميع المجتمعات. والحال أن عقلانية العقل الواحد مسألة ثقافية نسبية ترتبط باختبارات المعارف ونماذج المدارك والإبيستمات الناظمة.
في كتاب "أركيولوجيا المعرفة" (L’archéologie du savoir) يحفر فوكو (1926-1984) حفراً عميقاً في تربة التاريخ المعرفي ليستخرج التحولات والانكسارات والانقطاعات ويعتمدها أصلاً في المسار المعرفي المتنوع: "ليست المشكلة مشكلة التقليد والأثر، بل مشكلة الاقتطاع والحد؛ ليست مشكلة الأصل الذي يدوم، بل مشكلة التحولات التي تصلح للتأسيس ولتجديد التأسيسات" (فوكو، أركيولوجيا المعرفة، ص 12). يعتمد فوكو مبدأ التحول، لا مبدأ الثبات، من أجل استجلاء طبيعة الإنسان ومقامه المعرفي المستند إلى مسار الإدراك العقلي، وفي ظنه أن التبدلات التي طرأت على الوضعية الإنسانية أفضت إلى سقوط الهوية الثابتة وأفول عصر الإنسانية. بذلك يخالف المنحى العقلاني الكلاسيكي الذي كان يجسده مذهب الفيلسوف الفرنسي دكارت الداعي إلى إنصاف مقام العقل. إذا كان هذا العقل النصيب الأعدل بين الناس، فإن استخدامه يختلف من فرد إلى آخر ومن حال إلى أخرى. ليس الاختلاف في جوهر العقل، بل في قرائن استخداماته الموضعية.
الحقيقة أن الإنسان يستخدم العقل حتى يستطيع أن يستجلي هويته وعلاقته بذاته، ويستكشف هوية الآخر وصلته به، ويستوضح هوية العالم وارتباطه به. لذلك ينطوي العقل على ثلاثة متطلبات معرفية أساسية: ضرورة الانسجام مع الذات بواسطة توحيد عملية التفكير وضبط مسارها وتنسيق خلاصاتها، وضرورة التوافق مع الآخرين من أجل الخروج بإجماعات كونية تتيح الحياة المسالمة على الكوكب الأرضي، وضرورة الانسجام مع العالم الذي يكتنفنا من أجل الانخراط فيه انخراطاً سليماً لا يؤذينا ولا يعطل حركة الوجود.
في سياق الجدل الفلسفي العربي المعاصر، يعارض الفيلسوف اللبناني ناصيف نصار (1940) في كتابه "الإشارات والمسالك" (2011) نظرية الفيلسوف التونسي الإسلامي طه عبد الرحمن (1944) الذي يناصر الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ويبني مثل هذا الحق على القول بكثرة العقول الناتجة من كثرة الألسنة القومية. في نظر نصار، لا يقوم التعدد الثقافي على تعدد العقول البشرية، بل على تعدد الاختبارات التي يضطلع بها العقل الإنساني الواحد في المجتمعات المتنوعة. ذلك بأن الماهية الإنسانية واحدة، ولو أن مصدرها يظل غامضاً في كتابات نصار، في حين أن الهويات الثقافية التاريخية مختلفة باختلاف قرائن الانتساب وأوضاع المكان وأحوال الزمان. أميل إلى تأييد نصار في الدفاع عن كونية العقل التي تعارض الانتمائيات القومية والدينية، إذ إن التفكر المتبصر في الوضعيات الإنسانية المشتركة لا يطيق الانزوائيات اللسانية، ولو أن التعبير عن حقائق الوجود يختلف من حضارة إلى أخرى. بيد أن الإشكال الفلسفي الأعمق يتجاوز الخلاف الناشب بين نظرية الكونية ونظرية الانتمائية ليصيب مبدأ الثبات السرمدي في الماهية الإنسانية التي ينبثق منها العقل.
الإشكالية الخطيرة الناجمة عن كونية العقل: التوفيق بين الكلي والجزئي
كان بعض العلماء يعتقدون أن وحدة العالم تفترض وحدة العقل. إذا كانت المكانية منبسطة انبساطاً منسجماً في أنحاء الكون كله، على ما كان يظن العقلانيون التقليديون، فإن ذلك يقتضي أن يكون العقل مبنياً بناءً واحداً في جميع الأمكنة والوضعيات. بيد أن اكتشاف غموضية الكون وتمدديته وانسيابيته وتنوع محاوره وحيوية تدفقاته ولا توقعية اعتمالاته أفضى بالعلماء إلى توخي الفطنة والتريث في تعيين مقام العقل. فما عادوا يربطون مقام العقل الكوني الواحد بانتظامية الكون. على قدر ما تتنوع تناولات المكان المتسع وتتكاثر تصوراته، يكف العقل عن ادعاء القدرة على تعيين جوهره تعييناً ثابتاً مطلقاً، وعلى تحديد ماهية الإنسان تحديداً جامعاً مانعاً، وعلى الإمساك بالحقيقة الواحدة إمساكاً نهائياً قاطعاً.
المشكلة أن القول بكونية البنية وانتسابية المضامين يولد إشكالاً معرفياً خطيراً، إذ كيف تنشأ من العقل الكوني الواحد اختبارات معرفية ووجدانية وحياتية وأخلاقية متباينة؟ لا ريب في أن هذه المشكلة تعيدنا إلى الإشكال الفلسفي الأقدم الذي يستفسر عن انبثاق الكثرة من حضن الوحدة. لا بد لنا، والحال هذه، من إعادة التأمل في شعار عصر الأنوار كما رسمه كانط (1724-1804) "لتكن لك الجرأة على استخدام عقلك الخاص" (sapere aude). هل تعني عبارة العقل الخاص تفرعاً متبايناً من العقل الكوني؟ إذا استخدم كل إنسان عقله الخاص، فهل يلتقي الناس على مضامين مشتركة، ويخرجون بخلاصات متآلفة، ويُفضون إلى قرارات ومسالك متقاربة؟ صحيح أن من يرفض كونية العقل يرفض كونية شرعة حقوق الإنسان، ويرفض كونية الفطرة الإنسانية، ويرفض كونية الوجود الإنساني برمته. ولكن ما الضير في مثل هذا الرفض؟ وهل كُتب على الناس أن يحيوا حياة متشابهة منذ انبلاج فجر الوجود حتى انطفاء الشمس بعد خمسة مليارات سنة؟
أصل المشكلة في تدبر التباينات الخطيرة في تسويغ الفهم الإنساني الخاص. إذا كانت المجتمعات غير الغربية لا تعترف بكونية العقل الغربي، وقد يكون من حقها أو حتى من واجبها ألا تعترف بذلك، فكيف يمكننا أن نتفق على كونية شرعة حقوق الإنسان الأساسية؟ هل الاعتراضات الصينية والهندية والإسلامية على هذه الشرعة تُغنيها أم تعطلها؟ وما مشروعية الانتقاد الصادر من إدراكات مختلفة تتناول في تأويلات شتى تصورات الكون، ومبادئ الوجود، وقيم الحياة، وأحكام العيش، وقواعد المسلك، وأصول المعية الإنسانية المتباينة في المدينة الواحدة؟
الترابطية العصية على الإدراك جوهر العالم
يبدو لي أن السبيل الأقوم يقضي أن نفتح أذهاننا على أوسع فضاء احتمالي ممكن، من غير أن نكتفي بالموروث الأنثروبولوجي السائد على تنوعه وتمايزه وتباينه. أعتقد أن الإنسانية، من جراء القفزات العلمية النوعية الخطيرة التي تنجزها، ستخطو خطوات مذهلة في تصور طبيعة الإنسان وبنيانه ومقامه ودعوته ووظيفته. إذا أحببنا تنويع مداركنا، قرأنا نصوص الفيلسوف الأميركي المشاكس غراهام هارمان (1968) الذي يكب على ابتداع سبُل جديدة من أجل تجديد فهمنا العالم الذي ننسلك فيه والأشياء التي تكتنفنا. في كتابه "الأونطولوجيا الموجهة إلى الغرض: نظرية جديدة في كل شيء" (Object-Oriented Ontology. A New Theory of Everything)، يعتمد مبدأ الاستقلالية الشيئية أو الغرضية أو الكائنية. ذلك بأن الإنسان لا يستطيع بعقله أن يستنفد أغراض العالم المفطورة على العصيان المعرفي. الأشياء قائمة في تمردها على كل أصناف الإحاطة المفهومية. ومن ثم، ينبغي أن نتناولها في ارتباطاتها، لا في جواهرها الثابتة المتخيلة. في صميم هذه الارتباطات تنعقد بين الأغراض مقاصدُ ذاتية تحيل بعضها على بعض، فتنشئ لنا مجموع البيانات العابرة المؤقتة التي نتكئ عليها من حين إلى آخر حتى نتعزى بإدراك بعض جزئيات العالم الفسيح. وعليه، فإن شبكة الترابط القصدي المتحول بين الأغراض تصبح المرجعية الأضمن من أجل إعادة النظر في كل شيء، لا سيما في الماهية الإنسانية والجوهر العقلي.
يدلنا تاريخ الإنسانية على أن العقل لم يُستخدم استخداماً سوياً سليماً على تعاقب العصور، بل غالباً ما اعترضته وشوهته تصورات الناس الاعتقادية، وأوهامهم المعرفية، وآراؤهم الاقتناعية الذاتية. فإذا بهم يسخرون العقل لمآربهم وغاياتهم، فيصورون طبيعته ومقامه ووظيفته وحدوده تصويراً يلائم مبايعاتهم المذهبية ومصالحهم الانتمائية. حتى القرن العشرون لم يسلم من التشوهات الأيديولوجية التي أصابت العقل، إذ أكبت الأنظمة السياسية تسوغ الحروب تسويغاً مستنداً إلى فهم خاطئ يتصور العقل أداةً في خدمة السلطان. إذا تعسر علينا الإجماع على تعيين مقام العقل، فلا يعني ذلك أننا مضطرون إلى السلوك مسلك العبيد أو البهائم. الاختلاف في معاني العقل لا يُبطل استخدام طاقاته الواعدة. لذلك ليس لنا أن نشكك في مقام العقل، على حد قول الفيلسوف الألماني لايبنيتس (1646-1716) في كتابه "اجتهادات جديدة في الذهن الإنساني" (Neue Abhandlungugen über den menschlichen Verstand II, 21, § 50) "لو أن الحرية تعني أن نزعزع نير العقل، لأصبح المجانين والحمقى الأحرار الوحيدين".