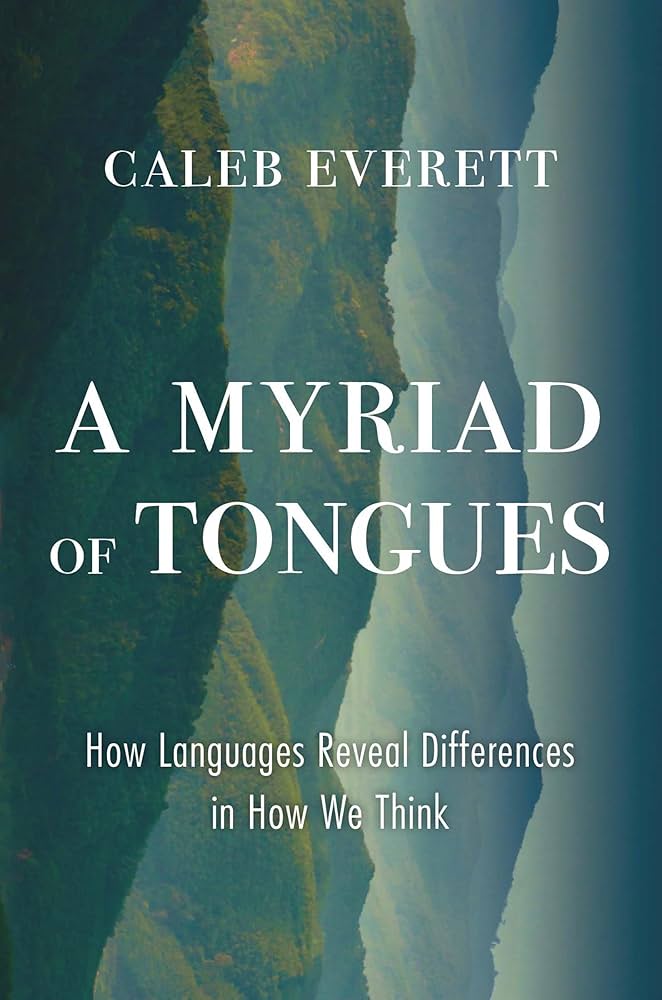ملخص
ما يزيد المرء فجيعة أن في العالم اليوم أكثر من سبعة آلاف لغة حية، نصفها معرض لخطر الانقراض في رأي علماء اللغة، حيث أغلب هذه اللغات لا يتكلم بها إلا أقل من عشرة آلاف شخص، والمئات منها يتكلمها أقل من عشرة آلاف، ويعتقد أن كثيراً منها لا يتكلمها إلا متحدث واحد.
في أواخر القرن الـ19 اخترع طبيب عيون بولندي يدعى زامنهوف لغة أطلق عليها اسم "اسبرانتو"، وأرادها أن تكون لغة دولية، فجعلها شديدة البساطة، مستبعداً منها كثيراً من السمات اللغوية التي شقينا بسببها في الفصول، فالكلمات فيها تكتب مثلما تنطق، والنحو بسيط ولا شواذ لقواعده، والأسماء غير معينة الجنس، فضلاً عن تسهيلات أخرى.
وتقول الموسوعة البريطانية إن الـ"اسبرانتو" قد تكون أنجح اللغات الدولية المصطنعة، فعدد الناطقين بها يقدر بأكثر من مئة ألف، ويضم الاتحاد الدولي للاسبرانتو (الذي تأسس عام 1908) 83 بلداً أعضاء، وثمة 50 اتحاد وطني للاسبرانتو، ومؤتمر عالمي سنوي لها، وأكثر من مئة دورية تصدر بها، وأكثر من 30 ألف كتاب مؤلف بها.
لكن لو كانت غاية لودفيك زامنهوف من اختراع الاسبرانتو أن تصبح لغة عالمية فهذا لم يحدث، ولو كانت غايته منها أن تعزز السلام والتناغم بين شعوب العالم، فقد أخطأ الحساب، ولكن يبقى له أنه أصاب حينما سماها باسمها هذا، وهو في الوقت نفسه اسمه المستعار "دكتور اسبرانتو" ويعني "دكتور متفائل"، فالحق أنه كان مفرط التفاؤل.
لو كانت الاسبرانتو قد نجحت حقاً، فأغنت شعوب العالم عن لغاتهم، لما كان ذلك كابوساً للمترجمين وحدهم، وإنما كان جديراً به أن يكون كابوساً مريعاً للإنسانية كلها، بما يمثله من خسارة فادحة لتنوع لغوي ومن ثم معرفي وثقافي هائل. غير أن أسباباً كثيرة -ليس من بينها الاسبرانتو- تضعنا أمام هذا الواقع الكابوسي أيضاً، مثلما يتبين من كتاب صدر حديثاً بعنوان "ألسنة لا حصر لها" لعالم اللغة الأنثروبولوجي كالب إيفرت في قرابة 300 صفحة عن مطبعة جامعة هارفرد.
لغة الروائح
في استعراضها للكتاب (أوروبا ناو – 15 أبريل/ نيسان 2024)، تحدد جولي سيديفي غرض إيفرت من كتابه بأن يثير في قارئه دهشة الكشف عن لغات مغمورة تبين له أنماطاً غير مألوفة من التعبير عن التجارب البشرية، حتى ما يبدو منها أولياً وعالمياً فيتعلق مثلاً باللون والرائحة والعلاقات الأسرية والمكان والزمان فـ"وحده القارئ قليل الحظ من الفضول هو الذي لا يجد متعة في هذه البهجة الموسعة للأفق".
ويا له من اتساع في الأفق ذلك الذي يجربه المرء حينما يرى تعامل لغات مجهولة مع مفهوم مألوف وجليل هو الزمن. تكتب سيديفي أنه "قد يكون بدهياً أن يقسم البشر الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل، لكن اللغات تبدي تنوعاً هائلاً في تقسيمها للزمن. فاللغة الكاريتيانية Karitiâna المتداولة في جنوب الأمازون لا تفرق لغوياً بين أحداث الماضي والحاضر، لكنها تغاير بين كليهما وبين أحداث المستقبل"، أي إن الزمن فيها إما مستقبل أو لا مستقبل... وفي المقابل، تستعمل لغة ياغوا Yagua وهي الأخرى من لغات الأمازون، ثمانية أزمنة، اثنين منها للتمييز بين أحداث المستقبل القريب والمستقبل البعيد، وخمسة منها مخصصة لتقسيم الماضي إلى فئات دقيقة التباين، فضلاً عن أن كثيراً من اللغات (لكن ليس جميعها) تستعين بالفضاء المادي نموذجاً للحديث عن الزمن، وتفعل ذلك بطرق مبتكرة مختلفة".
تضيف سيديفي "نحن [أي الناطقين بالإنجليزية] نتكلم عن أحداث الماضي باعتبار أنها (وراؤنا) وأحداث المستقبل باعتبار أنها (أمامنا)، أما الناطق بلغة أيمرا Aymara فقد يحار من هذا، إذ يقع الماضي بالنسبة له بوضوح في الأمام والمستقبل في الوراء، لأن بالإمكان رؤية الماضي أوضح من المستقبل الكامن ينتظر. أما اليوبونو Yupno المقيمون في أعالي غينيا الجديدة فابتكروا استعارة للزمن مختلفة كل الاختلاف، إذ يقولون للحدث الذي وقع قبل سنين قليلة إنه (على بعد سنوات قليلة أسفل التل) وللحدث مرجح الحدوث خلال شهر إنه (على بعد شهر أعلى التل)".
تكتب سيديفي أن كتاب إيفرت الموجه للقارئ غير المتخصص "يطرح جولة آسرة في معاجم متنوعة لمفاهيم إنسانية جوهرية أخرى، وفي ابتكارات اللغات للأصوات والقدرات النحوية. ومثلما يشير إيفرت، فإن الغالبية العظمى من دراسات اللغويات المعاصرة قد جرت في ما يعرف بلغات الويرد [WEIRD] أي اللغات الغربية المثقفة الصناعية الثرية الديمقراطية، مع التركيز المحدود على اللغات الهندوأوروبية، فأدى هذا المنظور الضيق إلى إنشاء نظريات تدور في فلك مجموعة من اللغات المتقاربة، ما جعل علماء اللغة يهملون، ببقائهم داخل تلك الحدود، النطاق الحقيقي للتنوع اللغوي، ويتبنون مزاعم شديدة الطموح في شأن خصائص مطلقة للغة يفترض أنها نابعة من بيولوجيا وإدراك مشتركين".
تكتب سيديفي أن "حياة إيفرت المهنية بوصفه عالم لغة أنثروبولوجي، بل وحياته كلها في واقع الأمر بوصفه ابناً لمبشرين أمازونيين، جعلته يتماس مع لغات ومجتمعات شديدة الاختلاف عن التي يعيش فيها أغلب قراء كتابه، وفي هذه المجتمعات تحديداً تصبح بصمة الثقافة على اللغة شديدة الوضوح لنا، ولذلك فإن من ثيمات الكتاب المهمة ثيمة الطبيعة المعقدة للتفاعل بين الثقافة واللغة، حيث تستجيب اللغة للضغوط والفرص التواصلية الموجودة في البيئات المادية والثقافية".
وتضيف "في بعض الحالات تكون الصلة بين اللغة وبيئتها المادية/ الثقافية ظاهرة بوضوح، كما في حالة لغة نينيهغاتو Nheengatú المستعملة في منطقة البرازيل الاستوائية، فما من عبارات زمنية للإشارة إلى وقت من اليوم وقع فيه حدث ما أو سيقع، وبدلاً من ذلك، ينقل المتحدث هذا المعنى بالإشارة إلى موضع الشمس في السماء في الوقت المعين، فلكي يقول (سأرجع عند الظهر) مثلاً، يشير المتحدث إلى أعلاه مباشرة بينما ينطق بما يعني (سأرجع). ومن الواضح أن هذه الأداة اللغوية لا تتيسر إلا في ثقافة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعراء وبموقع استوائي يكون موضع الشمس فيه مستقراً".
وتتابع "في لغات أخرى، ترك التصنيع بصمته، دافعاً إلى وضع معجم للون المجرد، إذ يتبين أنه ليست في جميع اللغات كلمة تعني الأزرق أو الأصفر. وفي المجتمعات غير الصناعية، نادراً ما ينفصل اللون عن الأشياء التي يتكلم عنها المرء، فقد يشير شخص إلى شيء أصفر بقوله إنه (موزي اللون). وعلى غرابة هذا فإن الناطق بلغة مانيق Maniq المستعملة في أدغال تايلاند قد يحار في حقيقة أن الإنجليزية تخلو تقريباً من كلمات مجردة للروائح (سوى "عفن" و"لاذع")... أما في ألمانيق فلديهم ما لا يقل عن 15 كلمة رائجة للروائح، فتقتنص كلمة واحدة المشترك بين روائح الدرنيات والرز والخنزير البري المطبوخ والشعر الحيواني".
شخصياً، لن أشعر بأدنى قدر من الملل، لو ظللت أقرأ مثل هذه النماذج لطرائق البشر في التعبير عن المفاهيم والأفكار والمشاعر، حتى لو لم أعرف بدقة ما الذي يمكن استخلاصه من هذه المعرفة عدا أن جميع اللغات بلا استثناء مهمة، وجميلة، وذكية، وأنها المفاتيح الحقيقية للتعرف إلى مكان وأهله والتواصل معهم وإدراك الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم، لأن كل لغة تحمل في جوهرها خلاصة المكان الذي نشأت فيه وجوهر أهله وثقافته، فلا يكون معجم كل لغة خريطة لكنز معرفي، بل بما يجعل كل معجم هو الكنز نفسه، وقد أخفيت جواهره في العلن، مباحة لكل من ينفذ من حجاب الصوت إلى ما وراءه وإلى ما فيه.
ولعل هذا هو الذي يزيد المرء فجيعة إذ يشعر أن الإنسانية على شفا كارثة حينما يطالع في صدر استعراض روس برلين للكتاب (فورين أفيرز/ عدد مايو/ أيار 2024) أن في العالم اليوم أكثر من سبعة آلاف لغة حية، 7168 على وجه التحديد، نصفها معرض لخطر الانقراض في رأي علماء اللغة فـ"أغلب هذه اللغات لا يتكلم بها إلا أقل من عشرة آلاف شخص، والمئات منها يتكلمها أقل من عشرة آلاف، ويعتقد أن كثيراً منها لا يتكلمها إلا متحدث واحد. وفي حين أن الناطقين بالعربية والإنجليزية والفرنسية والهندية والمندرينية الصينية والإسبانية كثر، فثمة لغات أقل شهرة تتضاءل، ويذهب أحد التقديرات إلى أن 96 في المئة من سكان العالم يتكلمون أربعة في المئة من مجموع لغاته".
التنوع اللغوي
يقول برلين إن "التنوع اللغوي شأن التنوع الحيوي غير موزع بالتساوي، فهو أقوى ما يكون في (المناطق الساخنة) من قبيل بابوا غينيا الجديدة، وأفريقيا الاستوائية، والأمازون، وجبال الهيمالايا أي الأماكن التي نجت فيها جماعات اللغات الصغيرة بسبب التضاريس، واقتصادات الكفاف، والبعد عن الدول المركزية، ولو إلى وقت قريب. أما المناطق اللغوية الساخنة اليوم فهي المدن التي يتكدس فيها الناس طلباً للعمل والتعليم والخدمات وفرص النجاة والإحساس بالحياة الحديثة، حتى إن نيويورك اليوم لا تعد فقط أكثر مدن العالم تنوعاً لغوياً لكنها الأكثر تنوعاً لغوياً في تاريخ العالم، لكن بقاء التنوع اللغوي في مثل بوتقات الاتصال هذه مسألة غير مضمونة بالمرة".
ويضيف، "دأب اللغات أن تظهر وتختفي، وفي بعض الأحيان نجت بعض اللغات ذات المجموعات الصغيرة من المتحدثين لأجيال، لكن معدل الخسارة الراهن غير مسبوق. وهو من أوجه كثيرة مواز لفقدان الكوكب المتسارع سلالاته الحيوانية والنباتية... ويعتقد أن ذلك المعدل بدأ قبل آلاف السنين مع انتشار الزراعة التي مكنت جماعات لغوية معينة من التزايد عدداً، والاستيلاء على أراض جديدة، والسيطرة على الجماعات الصغيرة الأكثر تنوعاً لغوياً من البدو أو ملتقطي الثمار. وفي القرون الأخيرة وما شهدته من غزوات الإمبراطوريات الاستعمارية والأوامر أحادية اللغة الصادرة عن الدول القومية والتوسع الحضري المفرط وشبكات الرأسمالية دائمة التوسع تزايد تلاشي اللغات. كما أن انتشار أنظمة التعليم الرسمي وأشكال وسائل الإعلام والاتصالات الجديدة يجعل من الصعب على اللغات الأصغر الصمود في عالم متغير".
ويتابع "كثيراً ما يستصغر المتحدثون باللغات المهيمنة شأن اختفاء هذه اللغات الصغيرة، متسائلين: ألن يكون العالم، في نهاية المطاف، أفضل لو أن الجميع يفهمون بعضهم بعضاً؟ وذلك التفكير لا يتناسى فقط أن الناطقين بلغة واحدة قادرون تمام القدرة على القتال والقتل لبعضهم بعضاً، لكنهم يتجاهلون أيضاً الفوائد العلمية والفنية والإنسانية العميقة للتنوع اللغوي، فكتاب (ألسنة لا حصر لها: كيف تكشف اللغات اختلافات طرائقنا في التفكير) يتناول ثراء لغات العالم المهددة بالاختفاء، ويكشف مدى بعدها عن أن تكون محض لهجات بدائية، فهي تزخر بأدب شفوي، ومعارف تاريخية وعلمية، وسمات لغوية فريدة، وأعاجيب أخرى نادراً ما يمكن ترجمتها إلى لغات أخرى. وإذاً، كيف يمكن إدراك لغة قبل زوالها؟".
يكتب روس برلين وهو المدير المشارك لتحالف اللغات المهددة بالانقراض وأستاذ اللغويات بجامعة كولومبيا الأميركية أن "زوال لغة ليس بالأمر الحتمي. فبالدعم السياسي للحكومات الوطنية أو المحلية وتوفير الموارد الاقتصادية الكافية، يمكن أن تعالج كل لغة ما يواجهها من أخطار وإغراءات ومطالب تواصلية ناجمة عن تجانس الهويات الوطنية وضغوط العولمة، لكن أغلب اللغات لا تحظى بدعم كهذا. فالضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير العادية تمنع انقطاع اللغة بين الأجيال إذ يتوقف الشباب عن الحديث بالطريقة التي يتحدث بها الكبار، فيبدأ الناطقون بلغة في الإحساس بأنهم غير منتمين إلى العالم، فالأمر لا يقتصر على أن إتاحة الوظائف والمدارس وغيرها من الفرص مرتبطة باللغات المهيمنة من قبل الإنجليزية والمندرينية والإسبانية بل يتجاوز ذلك إلى حمل أصحاب لغات من قبيل الكري Cree والنهواتل Nahuatl والزوانغ Zhuang على الإحساس بالعار مما ينطقون به بل ومن أنفسهم".
يكتب برلين أن "الناطقين باللغات المهددة بالانقراض يتعرضون أكثر من ذي قبل للتهميش إذ تؤخذ منهم أراضيهم أو يحولها التغير المناخي لأرض غير قابلة للسكنى، فيدخلون المدن والاقتصاد النقدي في قاع تراتبيتهما". واللغات القليلة التي تحظى بدعم حكومي رسمي -وهي محض مئات اللغات- تزداد هيمنة، حتى إن دراسة تبينت أن أقل من خمسة في المئة من لغات العالم هي التي "تصعد" إلى المجال الرقمي، وتزدهر على الإنترنت وفي التقنيات الجديدة "في حين أن 95 في المئة من لغات البشر، على رغم رقيها نحوياً ومعرفياً، قد تكون بحاجة إلى دعمها لكي تبقى".
ويضيف، "لقد بدا قبل بضعة أجيال أن اللغة الويلزية Welsh منذورة بالانحدار الحتمي في ظل تضاؤل عدد الشباب القادرين على الحديث بها، لكن بفضل عمل النشطاء، وكذلك الدعم من الحكومات المحلية والوطنية بل والقارية من قبيل الاتحاد الأوروبي، أحييت تلك اللغة لدرجة أن بات لها متحدثون حتى في قلب اللغة الإنجليزية. وعلى مدار القرن الـ20 أحييت لغات عدة كانت مهددة بالانقراض إما لاستفادتها من المزايا الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الاستقلال الذاتي كما في الباسك وكتالونيا، وإما من إدراج هذه اللغات في مناهج تنشئة الصغار كما في حالة لغة الماوري في نيوزيلاندا ولغات أخرى في هاواي. كما أن برامج إحياء الأميركيين الأصليين تثبت أنه حتى الجماعات شديدة الصغر قادرة على خلق مكان للغاتها (النائمة) على حد وصف اللغويين للغات التي يمر عليها قرن أو نحو قرن من دون وجود ناطقين طلقاء بها.
أخيراً، يكتب روس برلين أن العالم يغص اليوم بحركات لغوية نشطة تنشأ على سبيل رد الفعل على أخطار الانقراض والتهميش، وإن حكومات كثيرة تستجيب لهذه الحركات بخطوات رمزية من قبيل تحصين بعض اللغات في الدساتير لكن من دون إنفاق كثير على صيانتها بالفعل. وهكذا، على رغم بأس طوفان العولمة الذي يهدد بالإغراق كل علامة مميزة لأمة أو قبيلة أو مجتمع، ساعياً إلى أن يجعل الإنسانية القائمة منذ آلاف السنين على الاختلاف والتنوع، نمطاً واحداً، واحد الثقافة والذائقة، بالتالي واحد الاستهلاك، "من المرجح أن تتزايد مطالب الحركات اللغوية... لن تتحول كل حركة لغوية إلى حركة سياسية انفصالية، لكن ستستمر محاولات اللغات الصغيرة من أجل البقاء".
العنوان: A Myriad of Tongues: How Languages Reveal Differences in How We Think
تأليف: Caleb Everett
الناشر: Harvard University Press