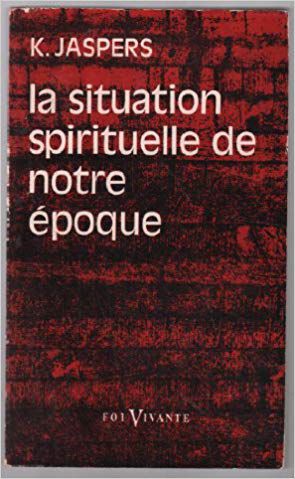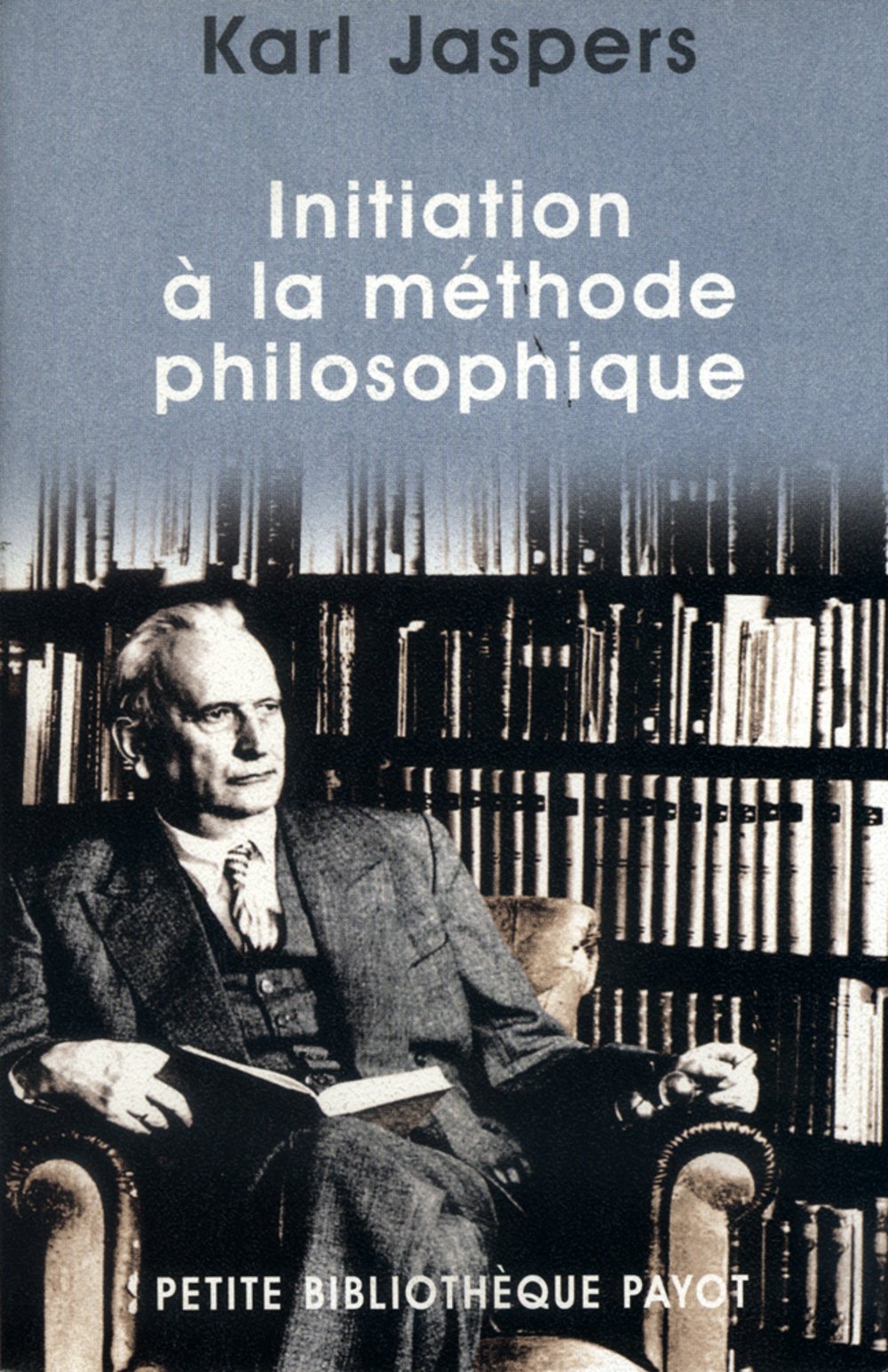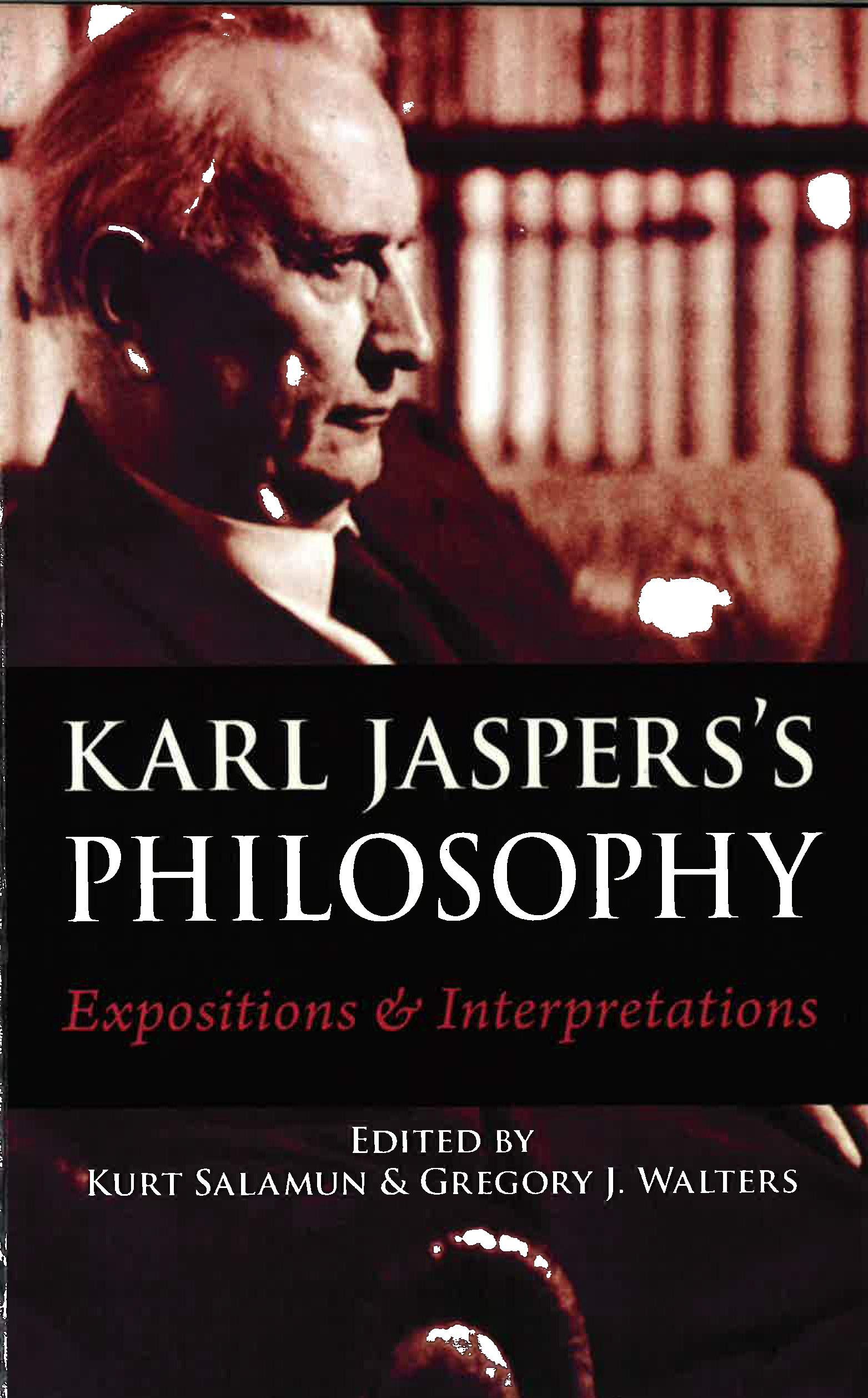ارتبط مفهوم الإيمان الفلسفيّ بالفيلسوف الألمانيّ كارل ياسبِرس (1883-1969) الذي نشأ في البداية على حبِّ علم النفس، واجتهد في هذا الحقل اجتهاداً حميداً حتّى ذاع له صيتٌ طيّبٌ في الأوساط العمليّة، لا سيّما حين أصدر العامَ 1913 دراسته الشهيرة "باتولوجيا علم النفس العامّة" التي أثّرت تأثيراً بالغاً في أبحاث علم النفس العلاجيّ. ولكنّه مالَ من بعد ذلك إلى الفلسفة، وأنشأ فيها أبحاثاً ثمينة عالجت عمق الوجدان الإنسانيّ. فأُسند إليه كرسيّ التدريس في جامعة هايدلبِرغ. وما لبث أن حرمه منه الحزبُ النازيّ في عام 1937، ناعتاً إيّاه بزوج المرأة اليهوديّة غرترود مايِر. ربطته بهايدغر (1889-1976) علاقة فكريّة وثيقة، مع أنّ فلسفته تبحث في الوجود الإنسانيّ، لا في الكينونة المجرّدة. هالته أحوالُ الانحطاط السياسيّ في الحربَين العالميّتَين الأولى والثانية، فطفق يتحرّى عن تعقيدات العقل السياسيّ في معترك الواقع الإنسانيّ. أصرّ في فلسفته على استثمار تصوّف أفلوطين (205-270) ومعارضته بنقديّة كانط (1724-1804) في مواجهة جدليّة مخصبة.
على غرار أبي الفلسفة الوجوديّة المعاصرة، الفيلسوف الدنماركيّ كيركغارد (1813-1855)، يصرّ ياسبِرس على أنّ الوجود لا سبيل إلى تعريفه أو تحديده. قد يوفَّق المرءُ في استجلاء بعض جوانبه، إذا قرّر أن يحرّر نفسه من كلّ تصوّر معرفيّ يُغلق عليه في هيئة جامدة من هيئات التحقّق الذاتيّ التاريخيّ. وحدها هذه الحرّيّة تقوده إلى تجاوز آنيّته المكبَّلة بأصناف شتّى من الأحكام الناقصة، وتتيح له أن يختبر بعضاً من وجوه التسامي الذي يظلّ عصيّاً على الإمساك الذهنيّ. فالإنسان أسيرُ انغراسه في تربة المحدوديّة التاريخيّة يستهلّها بالولادة الموهوبة، ويختمها بالموت المباغت.
التواصل الوجداني
أمّا الحقيقة، فلا يستطيع الإنسان أن يبلغها إلّا بالتواصل المنفتح الحرّ اللامحدود المشرَّع على اختبارات الوجدانات المتلاقية المتقابسة. لا غرابة، من ثمّ، أن تنشأ بين تواصليّة ياسبِرس الوجدانيّة وتواصليّة هابرماس (1929-....) العقلانيّة روابطُ شتّى من القربى الموضوعيّة استهلّها الأوّل مؤثِّراً تأثيراً واضحاً في بنيان الثاني الفكريّ. فالتواصل الوجدانيّ يستنهض كلَّ الإرادات الطيّبة الصالحة، ويستثمر طاقاتها الإصلاحيّة الإغنائيّة. في حيويّة التعاون الوثيق بين الذات والآخر، تضطرم نارُ الحقيقة، ومن ثمّ تخبو وتنحجب، ولا تلبث أن تختفي.
بيد أنّ قرائن التأزّم السياسيّ التي اختبرها ياسبِرس جعلته يدرك صعوبة التواصل الإنسانيّ هذا. ذلك بأنّ مثل هذا الحوار لا يستقيم إلّا إذا اعترف الجميع بالأخطاء الجسيمة المرتكبة، على نحو ما بيَّنه ياسبِرس في كتابه "الذنب الألمانيّ" (1948)، وأكبّوا يتطلّعون إلى تغيير إصلاحيّ صادق يحرف التاريخ عن مسراه الانحداريّ، كما جاء في كتابه "أصل التاريخ ومعناه" (1949). فالبشريّة يتهدّدها اليوم خطرُ الإفناء النوويّ الذاتيّ. ومن ثمّ، لا بدّ من نضال كونيّ في سبيل الإنقاذ والسلام، يضطلع به أهلُ البصيرة من حكماء الزمن الذين يراعون أصول الاختلاف الشرعيّ بين الحضارات، ويستثمرون كنوز التعبير الثقافيّ الذاتيّ في كلّ مجتمع على حدة. ذلك بأنّ "الفلسفة تُبيّن ما هي عليه بقدر ما تعتلن في فكرها السياسيّ" (ياسبِرس، "أصل التاريخ ومعناه"). تعزيزاً لهذه المسؤوليّة، تناول ياسبِرس في كتابه "كبار الفلاسفة" (1957) أبرز الإسهامات الفكريّة التي تُظهر تنوّع الحسّ الثقافيّ الفرديّ والجماعيّ في إدراك خصوصيّة الوجود. فشرع يحلّل تحليلاً فذّاً ضمّةً من الأنظومات الفلسفيّة، منها على وجه الخصوص أنظومة كانط التي برع في تجديد منهج تأويلها، ويقينه في هذا كلّه أنّ الفكر الفلسفيّ الناضج يستطيع أن ينقذ الناس من عصيانهم وانغلاقاتهم وتشنّجاتهم واحتراباتهم.
مشكلة الفلسفة أنّها لا تستطيع أن تفكّر في شرط وجودها، أي أن ترتقي إلى الينبوع المنحجب الذي منه تنبثق كلُّ الاختبارات الوجوديّة والمعاينات الفكريّة. إنّه الحاوي (das Umgreifende) الذي ينطوي على الواحد والأصليّ والكينونة معاً. ذلك بأنّ هذا الحاوي لا يملك أن يتحوّل إلى موضوعِ تفكّرٍ ما دام خاضعاً، في قرائن الوجود التاريخيّ، للقسمة الحاصلة بين الذات وموضوعها. حين ندرك هذه الاستحالة، نتحرّر فعليّاً لكي نمارس البحث الفلسفيّ الأصيل. فالوجود يقوم بفضل الكينونة الحاوية المنحجبة هذه، ينفصل عنها حتّى ينبسط في ثنايا الزمن الجاري.
الوجود الإنسانيّ المربك
لذلك ليس الوجود الواقعيّ العينيّ الجزئيّ المحدود بحدّ ذاته موضوع الفلسفة الوجوديّة، بل الوجود الذي يستحيل انبساطُه وتحقّقُه من جرّاء تنازعه بين الانغراس في العالم والتعالي على حركة التاريخ. لا ريب في أنّ الوجود مركزُ الفلسفة الأساس. إلّا أنّه ليس غايتها القصوى، إذ إنّ اندفاعها التجاوزيّ يُفضي بها إلى طلب الماوراء الأقصى، أي المِتافيزياء التي تشير بالخفَر والحذر إلى التسامي المطلق.
تستلزم الفلسفة مراناً تقشّفيّاً تهذيبيّاً يجعل الإنسان يدرك حدود إمكاناته، على قدر ما تتّضح له الاختباراتُ الشفيريّة الحدوديّة القصيّة التي يبلغها من جرّاء ما يعانيه من وضعيّات وجوديّة صادمة تتواطأ فيها وعليها طاقاتُ حرّيّته الذاتيّة ومراسيمُ القدر، وقائعُ التاريخ المنجزة وقابليّاتُ الاستشراف المفتوحة، معطياتُ التجربة الزمانيّة المكانيّة وإفلاتاتُ الروح المتوثّبة. من الواضح أنّ بنية الكائن الإنسانيّ تَعارضيّةٌ في صميمها. من هنا ينشأ اختبار الألم والشكّ واليأس.
يستخدم ياسبِرس اصطلاح الدازاين (Dasein) أو الوجود-هنا، وقد انفرد بتعريفه وجوداً ينشئ ذاتي الخاصّة ويخضع لشروطٍ وأحكامٍ فُرضت عليّ فرضاً. بذلك بخالف ياسبِرس ما يذهب إليه هايدغر في تصوّر الدازاين موضعاً لاختبار نداء الكينونة. ومن ثمّ، فإنّ وجودي يغدو مهمّة أساسيّة تضطلع بها حرّيّتي من أجل أن أتجاوز مثل هذا الوجود (الدازاين) طلباً لوحدة جوهريّة أنحتها في صميم كياني. لذلك ليست وجوديّة ياسبِرس وجوديّة لصيقة بالأفق التاريخيّ المحدود، بل فلسفةٌ في الوجود تستنهض الإنسانَ لكي يقرّر بنفسه مصير كيانه، أي لكي يعيّن الكائن الذي يريد أن يصبح عليه.
الاختبارات القصيّة المؤلمة
بيد أنّ الإنسان الموجود- هنا غارقٌ في أحوال ضاغطة تحدق به من كلّ حدب وصوب، في قرائن انتمائه الطبيعيّة الثقافيّة الاجتماعيّة التاريخيّة التي تحجب عنه حقيقة مصيره الوجوديّ المأسوَيّ. يبتكر ياسبِرس اصطلاحاً فذّاً للتعبير عن وطأة هذه القرائن، فيخرج علينا بمفهوم الوضعيّات الشفيريّة (Grenzsituationen) التي تدفع بالاختبار الوجوديّ إلى أقصى حدوده. من الوضعيّات الصاعقة هذه اختباراتُ الألم والذنب والإخفاق والصراع واليأس والانهيار النفسيّ والموت. كلّها تهزّ سكينتنا، وتجرح عنفواننا، وتعطّل يقينيّاتنا، وتكسر بديهيّاتنا، وتُربك الإيقاع اليوميّ المنتظم في مجرى شؤوننا الحياتيّة. من فضائلها المزعجة أنّها تجعلني أدرك أنّ الوجود الإنسانيّ الواقعيّ مستحيلٌ باستحالة التنعّم بطمأنينة الوجدان. يستحضر ياسبِرس عثار الشرّ أو اختبار الذنب، وكلاهما يعانيهما الإنسانُ، وفي وجدانه أنّهما بلاءُ الوجود بعينه. ما إنْ يأتي الإنسان إلى الحياة حتّى تنزل به مصيبة الشرّ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لا خلاص من المأزق الوجوديّ الخانق هذا إلّا بالجرأة على القرار الأعظم يحمل الأنا الجوّانيّة الأصيلة على قبول انعطابيّة الوجود، وزائليّة الحياة، وعابريّة الزمن، وصدفيّة التاريخ، وامتناع الواقع الكونيّ كلّه عن الإدراك. بفضل القرار الحكيم هذا، تصبح الفلسفة نضالاً في سبيل الفوز بالعالم الحقّ والوجود الأصيل. في صميم الفعل الانتفاضيّ الجريء، يختبر الإنسانُ انفطارَ جوهره على التسامي، ولو أتى هذا الاختبار في صورة الإنجاز الناقص: "الكينونة بحدّ ذاتها، الأصل الكونيّ، المطلق، تلك حقائقُ ينبغي أن تتجلّى أمام أعيننا في صورة موضوعيّة، ولو كانت هيئتها هذه لا تناسب موضوعيّتها، فتنهار على ذاتها، مخلِّفةً فينا بدمارها شفافيّة الحاوي الصافية" (ياسبِرس، "مدخل إلى الفلسفة").
الكون أرقامٌ ورموزٌ
في سبيل ذلك، ينبغي للإنسان أن يقرأ الوجود قراءةً فطنة حصيفة يستجلي فيه ما يدعوه ياسبِرس علامات الحاوي أو أرقام الوساطة بين الوجود والتسامي. فالكون كلُّه معقودٌ على الأرقام. الطبيعة رقمٌ رمزيٌّ يتيح للإنسان أن يستشفّ سرّ الكينونة. التواصل الإنسانيّ رقمٌ رمزيٌّ يبيّن انعطاب الفرديّات المنعزلة وتمزّقات الوجود المقيَّد بسلاسل التأزّم العلائقيّ، والتنازع بين رهبة إخفاق العلاقة الإنسانيّة وطموح الارتقاء إلى الوحدة المتسامية. وكذلك الأساطير والعمارات الفكريّة المِتافيزيائيّة التي احتضنت رموز النار والهواء والحياة والروح والصيرورة الكونيّة. هذه كلّها رموزٌ تُفصح عن لغة الكينونة التي يتحدّث بها الإنسانُ في صورة غير مباشرة. بيد أنّ خطيئة الفلاسفة أنّهم ظنّوا أنفسهم قادرين على تحويل الكتابة الكونيّة الرقميّة الرمزيّة إلى موضوع نظريّ خاضع لسلطتهم العقليّة. والحال أنّ المطلق الحاوي عصيٌّ على الإمساكات الذهنيّة القاهرة.
وعليه، لا يجوز اختزال المطلق هذا وتقليصه وتحويله إلى مجرّد موضوع معرفيّ، إذ لا سبيل إلى اختباره إلّا بواسطة ما يدعوه ياسبِرس الإيمان الفلسفيّ. في هذه العبارة مفارقةٌ مربكةٌ، إذ إنّ الفلسفة نظرٌ عقليٌّ، والإيمان تسليمٌ واثقٌ. غير أنّ ياسبِرس يُحرج الجميع حين يعلن أنّه يحتاج إلى ينبوع أصليّ لا يمكن تسويغه على الإطلاق حتّى يُسند إليه قلقَ كيانه الجوّانيّ. لا ريب في أنّه بذلك يستنجد أبا الوجوديّة الإيمانيّة، الفيلسوف الدنماركيّ كيركغارد، وهو مقتنعٌ بأنّ المطلق الحاوي لا يغدو حقيقيّاً إلّا بالإيمان الذي يتيح للإنسان أن يختبره ويحيا في نوره ويعاين تجلّياته.
صعوبات الإيمان الفلسفيّ ووعوده
الإيمان الفلسفيّ حركةٌ جوّانيّةٌ تحثّ الإنسان الحرّ على اعتناق التسامي من غير مباحثة أو تردّد. في هذا السياق، يعلن ياسبِرس أنّ "الإيمان هو الكينونة"، معارضاً دِكارت وهيغل اللذَين يصرّان على القول بأنّ "الفكر هو الكينونة"، سائرَين على خطى المفكّرين الإغريق الأوَل، لا سيّما بارمنيذيس (القرن الخامس ق. م.). إذا كان الإنسان ينحت ذاته على صورة إيمانه، فإنّ الاختبار الإيمانيّ هذا لا يُفضي إلى اعتناق الأنظومة الدِّينيّة الرسميّة، ولا يسوِّغ في الوقت نفسه الإلحاد الأيديولوجيّ الأعمى المتزمّت. لا يتحمّل الإيمان الفلسفيّ المبايعة اللاهوتيّة، ولكنّه يرفض الأسر التاريخيّ الضيّق: "في مواجهة الدِّين والإلحاد، يحيا الفيلسوف إيمانَه الخاصّ" (ياسبِرس، "العقل والوجود"). فلا يصطنع من التسامي موضوعاً نظريّاً، إذ إنّ الله ينبغي أن يظلّ في علاقة توتّريّة جدليّة إرباكيّة بألغاز الوجود الإنسانيّ. ليس المؤمن ولا المتصوّف مَن يختبر القربى الحقّ من الله، بل الإنسان العاديّ البسيط، الطفل البريء، الكائن المسكون بغربة الحياة. ومن ثمّ، فإنّ المطلق الإلهيّ المتسامي يتجلّى لي في معاناة الاختبارات الشفيريّة التي تضطرّني إمّا إلى الخنوع واليأس وخيانة ذاتي، وإمّا إلى القرار الفلسفيّ الجريء الذي يحثّني على معاركة الحياة بالمحبّة والمغافرة والالتزام الإنسانيّ الكونيّ: "إنّ ما أحبّه، إنّما أريد لي أن يكون. أمّا الكينونة بحدّ ذاتها، فلا أستطيع أن ألتمحها وأستشفّها حدْسيّاً إلّا بالمحبّة. ذلك بأنّ المحبّة الحقّ تضمن لي في الوقت عينه أصالة المسلك وصدقيّته" (ياسبِرس، "مدخل إلى الفلسفة").
رأس الكلام في هذا كلّه أنّ فلسفة ياسبِرس تساعدنا في الاضطلاع بسرّيّة وجودنا وغَوريّته ولُغزيّته، ولكن من غير أن تدفعنا إلى معاندة متطلّبات العقل. لذلك تدعونا إلى احتضان الأبعاد الفائقة الوصف في الوجود على قدر ما تحرّضنا على رعاية الحقائق الحياتيّة المألوفة البسيطة التي تحمل في طيّاتها روعة الواقع الكونيّ برمّته. يظلّ كتابه "الفلسفة" الأحبّ إلى قلبه، إذ إنّ الفلسفة تنير ظلمات الوجود. لذلك يدعونا في كتاب "المِتافيزياء" إلى أن "نقرأ كلَّ كائن قراءتَنا مخطوطةً أنشأها التسامي بالأرقام المرمَّزة". بذلك نستطيع أن نختار بين حقيقة دينيّة مضبوطة، مغلقة، محدودة، جامدة، قاطعة، نهائيّة، مفروضة فرضاً؛ وحقيقة عقلانيّة مبحوثٍ عنها، مفتوحة، حيّة، متحرّكة، مقترَحة للمراجعة والنقد والتقويم، لا حدود لها على الإطلاق.