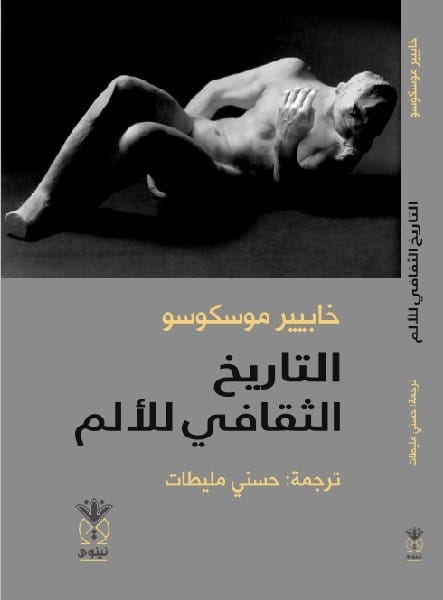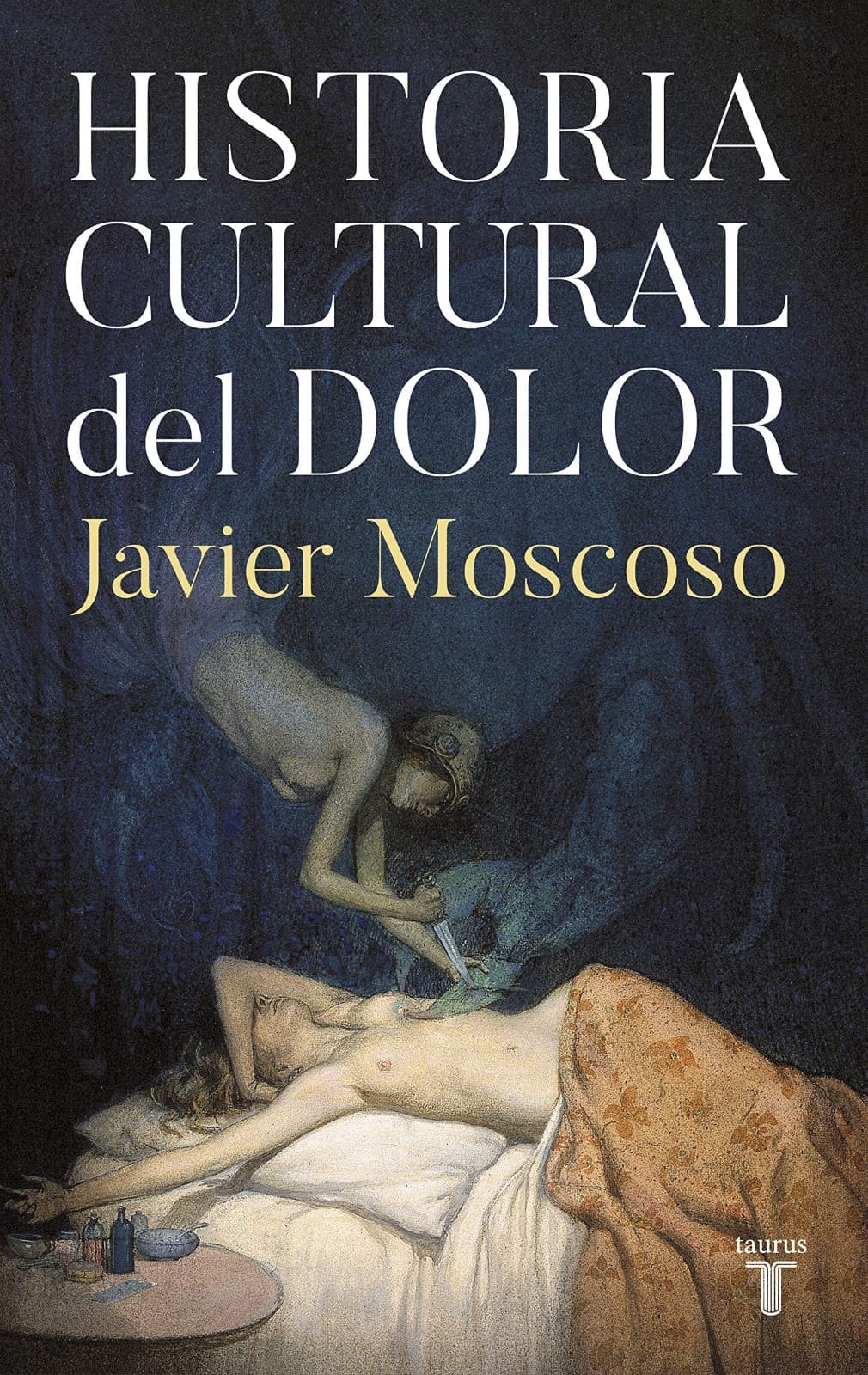ملخص
نشر كتاب "التاريخ الثقافي للألم" للكاتب الإسباني خابيير موسكوسو للمرة الأولى في 2011، وفي عام 2012 صدرت الترجمة الإنجليزية له، فيما حصلت النسخة الفرنسية من هذا الكتاب على جائزة المكتبيين الفرنسيين لأفضل كتاب تاريخي في عام 2015، واليوم ينقله إلى العربية المترجم والكاتب الفلسطيني حسني مليطات، فنتعرف معه إلى "سردية الألم في الثقافات العالمية"، لكن ليس من منظور أدبي وفني وفلسفي فحسب، وإنما من منظور طبي، سريري أيضاً، لتشكل موضوعاته محوراً من محاور العبور إلى التخصصات العلمية والإنسانية.
يأخذنا الكاتب الإسباني خلبيير موسكوسو في كتابه "التاريخ الثقافي للألم ("دار نينوى – دمشق) إلى مناقشة عديد من الموضوعات حول الألم الذي يقتفي الأكاديمي الإسباني سرديته عبر العصور كظاهرة ثقافية، ويتجلى ذلك في موضوعات عديدة تطرق إليها المؤلف في فصول كتابه، وخلافاً لما أكده إميل سيوران (1911-1995) باستحالة اللقاء أو الحوار مع الألم الجسدي، فإن كل صفحة من صفحات الكتاب (456 صفحة من القطع المتوسط) تدعو إلى هذا اللقاء، وتعزز هذا الحوار، فما بين التاريخ والفلسفة والطب وفن الأيقونات والأدب الروائي، يطرح موسكوسو أمثلته عن الأشكال المتتابعة لتجسيد تجربة الأذى، وعن الأساليب الفنية والقانونية والعلمية التي أتاحت للبشرية منذ عصر النهضة وحتى أيامنا هذه، الفهم الثقافي للمعاناة الإنسانية.
الألم والتاريخ
يذهب أستاذ العلوم والفلسفة في المجلس الوطني الإسباني للبحوث إلى أن مجموعة الصور والأيقونات المزخرفة على مذابح القديسين شكلت جزءاً من مجموعة الصور المرتبطة بالألم الجسدي أو المعاناة الجسدية التي أنتجت نهاية العصور الوسطى، فالعنف الذي صورته أعمال الرسامين من أمثال: بيتر بروغل وجان كالوت ولوكاس كراناخ، لمشاهد الشهداء المسيحيين وأحكام الإعدام والتعذيب، عبرت عن آلام المسيح على الصليب في سياق مسرحي اعتمدت فيه المشاهد على مبادئ واتفاقات طقسية، من مثل لوحة "الطريق إلى الجلجلة" للرسام بيتر بروغيل (الأكبر).
لقد وجد المؤلف في الأيقونات التي تجسد استشهاد القديسة باربارا للراهب الدومنيكاني ماستر فرانك، تمثيلاً لانتصار الإيمان عبر تعذيب الجسد، وكان الجسد في هذه الأيقونات يتعذب بهدف التعدي على العفة والطهارة، وتماشياً مع طقس عبادة الشهيدة العذراء الذي كان شائعاً في نهايات العصور الوسطى في أوروبا. إذ عرف التعذيب وقتها بأنه عنصر مثير للشهوة الجنسية، ومن هذا المنطلق يصور الكتاب التعذيب كوجه من وجوه العنف الجنسي، كما في لوحة "الجلد" للرسام الكتلاني لويس بوراسا.
فن العقاب
وكان "فن العقاب" جزءاً من التاريخ المروع للألم. إذ كان للمشاهد دور كبير في دراما الألم، فحتى عندما نفترض استحالة مشاركة التجارب الحسية للآخرين، فإنه لا يوجد مشهد من العذاب والألم يبقينا غير مبالين كبشر، بل على العكس، يمكننا من خلال الأحاسيس المتداخلة فقط التفاعل أمام الوحشية والهمجية، ففي القرن الـ18 عرف الفيلسوف ديفيد هيوم (1711-1776) التعاطف بأنه طريقة مشاركة الألم أو المتعة مع شخص ثالث، أما إدموند بيرك (1727-1797) فتصور التعاطف صورة من صور الاستبدال الذي يمكننا من خلاله أن نضع أنفسنا مكان شخص آخر، حتى نصل إلى نقطة الشعور بمقياس انطباعاته الخاصة به. وبتأمل المتهم على آلة التعذيب، كما يقول آدم سميث، "يمكننا أن نشكل تمثيلاً من مشاعره التي تجعلنا نتصور أنفسنا مكانه، وأننا نعاني ما يعانيه من عذابات، لندخل، إذا جاز التعبير، جسده".
تاريخ الألم في بعديه الثقافي والفني تجلياً في القرن الـ19 أيضاً بحوادث الانتحار والقتل، وهذا ما يستشهد به مؤلف الكتاب عبر مناقشته روايات مثل "الجريمة والعقاب" و"الأخوة كارامازوف" لدوستويفسكي، أو رواية "تيربز راكان" لإميل زولا التي تحولت موضوعاً للتسلية والاستهلاك، وصار العنف المنزلي بوجود القوانين والأعراف المتساهلة اتجاه اغتصاب النساء وإساءة معاملة الأطفال أمراً مستساغاً. كل هذا حول المدن الأوروبية في القرن الـ19 إلى مرتع للظلم والأحقاد.
وكان للأدب والفلسفة في القرن الـ19 تمثيلهما الناصع أيضاً للألم عبر أعمال كل من ليشتنبرغ وفينكلمان وشوبنهاور وهيغل، وذلك بعديد من الإشارات إلى دلالة وفائدة الألم للحياة والفن والتربية والتاريخ، فكان لرواية "آلام الشاب فرتر" لغوته مكانتها، وهي قصة حزينة عن خيبة أمل غرامية ستحظى باهتمام اجتماعي كبير، وسواء فكرنا بأعمال شيلر أو هولدرلين، فإن المعاناة في ذلك الزمن اكتسبت دلالات ومعاني جديدة، عندما يفكر فيها العارف بوسائل المأساة، وهذا ربما ما دفع نيتشه إلى القول: "إن الألم هو الحيوان القادر على حملك بسرعة شديدة إلى الكمال".
وفي إطار ذلك لم يعد من الممكن النظر إلى تجربة الألم واللذة على أنهما مصطلحان متعارضان، بل على العكس، فـ"اللذة تكمن في الألم" كما يقول موسكوسو، من دون أن يكون ذلك تعبيراً مجازياً فحسب، ففي كتابه "إرادة القوة" يوضح نيتشه هذه الفكرة مع الحالة العاطفية التي تحدثها الدغدغة لحظة الجماع. ولقد وظف صاحب "ما وراء الخير والشر" مثاله لتأكيد نحو واسع، على أن اليأس عنصر من عناصر اللذة.
نظرية فلسفية
ويعيد موسكوسو الشعور العام بالألم إلى نظرية الفيلسوف سيزاري بكاريا (1738-1794) في أطروحته المعنونة: "الجرائم والعقاب" فالمتعة هي صنو الألم، وهما قوى محركة لكل الكائنات المدركة، فتعذيب الجسد لا يعانيه السجين فقط، وإنما يعانيه أولئك الذين يفكرون في تطبيق العقوبة أيضاً. من هنا وعى إنسان عصر التنوير أنه ينبغي إدارة الألم باستخدام معايير ذات طبيعة اقتصادية صارمة مرتبطة بالشعور العام، بدلاً من ارتباطها بحجم الجريمة. إذ كان ينبغي التحكم بالتعذيب من خلال التأثير الذي يخلقه المشهد في مخيلة الشهود. ومن دون الاعتماد على إيماءات وعلامات معاناة المدانين أنفسهم، أما العقوبة فينبغي لها أن تحدث تأثيراً أكثر فاعلية وديمومة في ذهن البشر لردع الجريمة فقط.
لقد أدرك مفكرو عصر التنوير في أوروبا الكيفية التي يتم فيها القضاء التدريجي على الإجراءات القضائية الخشنة، والمرتبطة بإحداث الألم المتفاقم في أجساد المتهمين، فممارسة التعذيب من خلال المشنقة والنيران المشتعلة والرجم بالحجارة والمقصلة، سيفسح في المجال أمام أنظمة عقابية أكثر دقة وحدة. هكذا -وعلى نحو تدريجي- استبدلت المشاهد الوحشية الهائلة التي رافقت عمليات الإعدام أو الاستجوابات القضائية نهاية العصور الوسطى إلى تدابير ضابطة وطرائق عقابية أقل وحشية، بينما استخدم العالم الحديث المفاصل العضلية والمستقبلات الحسية والأنسجة العصبية، فسعى عصر التنوير إلى فرض الاعتراف من دون ألم أو قيود.
التفكير في تقنين الألم جعل الشروع باختراع عقوبات من مثل الإقامة الجبرية، فانخفض خطر العنف الجسدي في وقت حدث فيه الارتياب من إساءة معاملة الحيوانات، والقوانين الجنائية الخاصة بالجيش، إضافة للعقاب البدني للعبيد والمجانين والمعزولين صحياً والأطفال، ووفقاً لذلك اختفت تدريجاً تلك المشاهد الوحشية التي رافقت عمليات الإعدام من المشهد العام للإنسانية، إذ اكتشف الأطباء أن من يتعرض للإعدام بالمقصلة يظل دماغه يستقبل إشارات الألم والصدمة حتى بعد فصل الرأس عن الجسد.
ومع نهايات القرن الـ18 وبدايات القرن الـ19 كما يبين الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه "المراقبة والمعاقبة"، لم يحدث أي تقييد على فن العقاب، بل تحول من فعل إدانة للجسد إلى انقباض للروح. وهذا ما يشرحه الكتاب بتحول عقوبات الجسد إلى سياسات اجتماعية جديدة أدت إلى ولادة "عقوبة السجن" التي توضح تقييد سلوك السجناء بفقدانهم حرية، واستبدال مشهد المعاناة الجسدية بمشهد عزلة الزنزانة والعمل القسري والأشغال الشاقة وصمت السجون، وهذا ما بدأ في مناطق من أوروبا والغرب وإن عبر تواريخ متباينة.
ظاهرة التخدير
ان التعايش مع الألم إلى موضوع دراسة، كما سيحدث في القرن الـ20، وإنما إلى سيجعلها أداة من أدوات البحث المعرفي، فقد أدى اكتشاف التخدير الكيمائي إلى وجود أبحاث عن الوظائف العضوية المدعومة باستخدام تشريح الأحياء، وظهور علم النفس التجريبي، إضافة إلى تقدم الطب السريري. هكذا استبدل علم الوظائف (الفيزيولوجيا) الجديد، الفرضيات التأملية القديمة إلى البرنامج الإمبريقي (التجريبي) الذي اعتمد كثيراً على درجة التجريب الحيواني، وتالياً على الإنتاج القصدي للألم، ففي فرنسا مثلاً سوغ أكثر الكتاب تمثيلاً لشكل هذا العلم الفيزيولوجي الجديد طريقة العنف الجديدة في الاقتناع بأن النظام العصبي لجميع الثدييات محكوم بالقوانين نفسها، وبذلك يمكن للحيوانات أن تحل محل البشر، لتصبح فئران المخابر بذلك "الشهداء الجدد للحقيقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما وطد الطب الصلة بين أعراض المرض والإصابات العضوية، وبما أن الأعراض تعتمد على الإصابات، فإن المؤسسات استبدلت بقصة المريض حكاية أعراض مرضه، ولهذا الغرض تم اختراع سماعة الطبيب وميزان الحرارة وجهاز ضغط الدم والأشعة السينية في عام 1859، وأصبح لكل تجويف أو فوهة في الجسد الإنساني مصدر مخصص للبيانات، وتطورت أدوات قياس الألم مع اختراع جهاز تخطيط العضل الذي طوره هيلمهولتز عام 1852، وقد صممه لتصوير تقلصات العضلات، وجهاز الرسم الكيموجرافي عام 1846 القادر على قياس التغيرات في ضغط الدم.
ويركز الباحث الإسباني على دراسة الأشكال الموضوعية للألم، وبخاصة، في أثناء العمليات الجراحية، بما ذلك عمليات جراحة الأسنان والولادة، إذ يأخذ المؤلف بعين الاعتبار مسألة التخدير الكيمائي، لكنه يخبرنا عن "الألم كصديق وفي" سواء لحظة الولادة، أو في مرحلتي الطفولة والشيخوخة، فالألم يخبرنا عن الحقائق غير المريحة في أجسامنا من دون قلق على ندمنا أو شكوانا. والألم يدلنا أيضاً على إصابة عضوية في الجسد، ويقترح بعد تشخيصه العلاج الأول، والألم يجب ألا يفسر من خلال الطريقة التي ينقل بها المريض انفعالاته، بل من خلال الملاحظة التجريبية.
وعلى رغم أن الألم، إلى جانب الحمى والالتهابات ومجموعة أخرى من الأعراض ذي قيمة تشخيصية، فإنه يبدو له أيضاً وظيفة علاجية، لقد كان الألم الذي وصفه الكثير مثل طاغية، أو وحش متقلب" أفضل الأطباء وأصل كل العلاجات، فهو "أكثر الأطباء يقظة وانتباهاً" وهو "حارس الحياة". إن علامة المرض الأكثر وضوحاً وأقل راحة جزء من العلاج، كما أن الألم استخدم في الطب لمحاربة الألم بإحساس أكثر شدة مثل الصعقات الكهربائية والكي بالنار. استخدم الأطباء هذه الممارسات في حالات النوبات القلبية والشلل والسكتة الدماغية والصرع والكساح والأورام السرطانية، كما استخدم المقيئ في الحالات المزمنة الشديدة من مثل الالتهاب الرئوي، والكسور، وآلام الصدر، والقشعريرة، وآلام أسفل الظهر، والتهاب الرئتين، وآلام النقرس.
وفي القرن الـ20 وصف استخدام المخدر في العمليات الجراحية بالفتح والنصر المبين، واحتفل بالمخدر كما لو أنه "وحي منزل" وتحرر من عبودية الألم، وهذا ما دفع ملكة إنجلترا فيكتوريا على العلاج باستخدام الكلوروفورم لتلد مولودها الرابع، وكان ذلك يوم السابع من أبريل لعام 1853. فطبق مبدأ أبقراط الذي يقضي بأن تخفيف الألم يعود للآلهة، فهو عمل إلهي لتهدئة الألم، ليدرج ذلك في القانون المتعلق بواجبات فن الطب. حدث ذلك مع أن بعض الأطباء دافعوا على نحو علني عن ألم الجراحة، بناءً على الفوائد المفترضة التي تقدم للمرضى، وكان من البغيض إجراء عملية جراحية لشخص فقد حواسه ووعيه، على أساس أن صرخات المريض أثناء العملية هي من توجه المشرط في يد الطبيب بالصورة المناسبة.